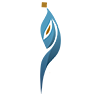الشبهة الثالثة: حقوق الإنسان في الأديان، وعلاقتها باتهام الساخرين من الأديان بازدراءها.
من الأمور التي يثيرها الملحدون في شبهاتهم حول الأديان خاصة السماوية، ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكيف أن الأديان قد ازدرت حقوق الإنسان، وأنها جعلت من التحكمات ما جعلت.
من أمثلة هذه الحقوق التي يزعمها الملحدون: حق المرأة في أن تلبس ما تشاء وقت ما تشاء، وذلك ينافي ما فرضه الإسلام من الحجاب والزي الخاص بالمرأة، فأول ما يقدم عليه الملحد من النساء مثلا ترك الحجاب، كذلك حق الإنسان في ممارسة العلاقات الجنسية مع من يشاء، كذلك حق الإنسان في شرب ما يشاء فيتهمون الدين الإسلامي الذي حرم شرب الخمر وغيرها من المسكرات بأنه مقيد لحقوق الإنسان وهكذا.
يقول أحد الملحدين: البعض يتهمنا بالفوضوية في تعاملاتنا الجنسية، لكن وإن كان لنا تحفظ على مفهوم الأخلاق فإن هناك أخلاقا تحكمنا فلسنا كما يظنون، فالجنس بالنسبة لنا ليس آخر المطاف ولا الغاية فهو لحظة مادية وقتية وأرى أنه عندما يلحد الشاب فإن أول ما يبحث عنه هو الجنس بعكس البنت، فهي تكفر كثيرا قبل أن تمارس الجنس والذي يكون غالبا مع ملحد، حيث لا تقبل أن يكون لها علاقة مع مسلم حتى وإن كان عاصيا؛ حيث يرفض إلحادها، ولا أرى موانع من إقامة علاقة جنسية مع امرأة متزوجة طالما أرادت هي ذلك فجسدها ملك لها، وتبعا لمفاهيم المجتمع وتقاليده التي لا تسمح بإقامة اثنين بلا زواج يلجأ البعض- لو كان الطرفان ملحدين- للزواج أحيانا بالشكل الرسمي؛ كي يتجنبوا ردود الأفعال، خاصة في الطبقات الوسطى والسفلى، عكس الأمر في الطبقات العليا التي يزداد الإلحاد فيها انتشارا، كذلك العلاقات تكون أيسر وأكثر انفتاحا فلا حاجة لزواج الملحدين، فالطبقة تكفل لهم حرية الممارسات وتحميهم، وعلى المستوى الشخصي أرفض فكرة الزواج ولا أهتم برؤية المجتمع لغير المتزوج… وهنا أشير إلى أن الرؤية الإلحادية منقسمة بالنسبة للجنس والإنجاب، كذلك الأمر بالنسبة للإنجاب هناك من يرفضه كيلا يولد طفل ويكرر المعاناة في الظروف القاسية والتي لا تسمح لأي أحد بتحقيق شيء والإجهاض أمر مباح لا ضير منه، وهناك من يحبذه بغية نشر الإلحاد وتكثير عددهم([1]).
وهذه الشبهة تندرج تحت الأنواع التالية للإلحاد:
1- إلحاد الإله الظالم القاسي: لأن هذا النوع ينطلق من محاولة إطلاق العنان للتصرفات البشرية بلا سقف أخلاقي أو قيمي، ومحاولة إلصاق تهمة الظلم والقسوة بالأديان؛ لأنها في نظر أصحاب هذا النوع تقييد للإنسان بقيم دينية وأخلاقية تجعله في معاناة دائمة تجاه أهوائه النفسية، أو هو حالة من الشعور بالظلم والقسوة في الأديان نتيجة لقصور التصور؛ لأن الملحد يبني هذه النتيجة على تصوراته للمخلوقين، فما يعتبره منهم قسوة وظلمًا فهو يراه كذلك بالنسبة لللإله، وهو لا يستحضر أن الخالق لا تحكمه تلك الأمور النفسية والعوارض البشرية التي تجعل بعض البشر ظالمين، وينسى كذلك أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ عالم ومدبر لخلقه، فكما أنه يعاقبهم في حياتهم القصيرة على المعاصي فهو يثيبهم كذلك ثوابًا أجزل من أعمالهم، وأن العقاب قد سبقه التحذير من خلال الرسالات، فالثواب والعقاب والعقاب في حقيقتهما إذا تصورهما هذا الملحد من الخالق المدبر فهما تجلٍّ للعدالة الإلهية([2]).
2- إلحاد التعنت والسفه. وذلك لأن هذا النوع قائم على ادعاء بعض الملحدين: كيف يعطيني الإله غرائزَ ثم يطالبني ألا أستعملها وهذا النوع هو نتاج إنكار العبودية للخالق، واعتقاد الحرية المطلقة بلا سقف ديني أو أخلاقي، وهو شعور بالتناقض بين المطالب الدينية وبين حقيقة التركيب البشري القائم على التحرر ووجود الغرائز، أنتج هذا الشعور نفيًا للوجود الإلهي؛ لأنه ـ في زعمهم ـ لا يمكن أن يكون من خلق هذا المعاني في النفس البشرية هو من قيدها بعد ذلك بوضع الدين والأخلاق، ومن هنا كان هذا التعنت في التصور والإدراك القاصر لحقيقة الوجود الإلهي، ولحقيقة النفس البشرية، مدخلًا لهذا النوع من الإلحاد، وهونوع يرسخ لبهيمية الإنسان وعبثية وجوده في هذه الحياة، والمنتمون إلى هذا النوع يبذلون من أموالهم وأوقاتهم في ما يخالف الأديان؛ لأن الحقيقة التي لا ينكرها أحد أنه لا يستطيع الإنسان الحياة بهذا المفهوم حتى ولو كان ملحدًا، وإنما تظهر هذه الحالة العبثية حين يتعلق الأمر بالدين فقط([3]).
3- إلحاد الشهوات: وذلك لأنه ينشأ من مخالفة للدين السائد، بسبب غلبة الشهوة، والعجز عن الالتزام بقيود الدين الأخلاقية، ومع الجهل بمراتب الأعمال، ومنزلة المعصية في المنظومة الدينية، فإن العاصي يرى في فعله مناقضة لاعتقاده، ولأنه لا يستطيع التخلي عن الفعل، لأن هوى النفس وشهوة الجسد يمنعانه من ذلك، فإنه يلجأ للتخلي عن الاعتقاد، بتبني الشك ثم الإلحاد، وهو في كثير من الأحيان يغلف إلحاده بسؤالات فلسفية أو تشكيكات علمية لكن الحقيقة أنه ما به إلا الشهوة الطافحة، مع الجهل بمعاني التوبة والتكفير عن الذنب من داخل المرجعية الدينية.
وفي الحقيقة هذا هو الإلحاد الذي تعاني منه المجتمعات العربية والمسلمة، فالنخبة الإلحادية في هذه المجتمعات عالة على الغرب في الفلسفة والعلم معا، وغير النخبة غارقة في الكسل المعرفي وطمأنينة الجهل، ولذلك فليس للمبتدئ في الإلحاد إلا التمسك بهرمونات الشهوة والاستناد إلى التأصيلات المسروقة من بيئة خارجية.
والمراقب للحالة الدينية والعقدية لدى المجتمعات العربية والمسلمة يجد أن هناك حالة من التمرد ضد القيم والمبادئ وبعض الثوابت والمسلمات خاصة في أوساط الشباب، الذي اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح على العالم عامة والعالم الغربي خاصة، حقق لهم دورا تثقيفيا وهميا، وصاحب ذلك تقدم حضاري غربي مادي، قابله تخلف حضاري عربي مما زاد من حالة الاحتقان لدى كثير من الفئات ودفعتهم للتفتيش عن خيارات بديلة تسهم في تحقيق النهضة ورفع الظلم.
وأضحت الصورة النمطية للخطاب الشرعي في نظر كثير من المثقفين صورة سلبية أثمرت عدم الرضى عن الخطاب القائم في حين أن الخطاب الإلحادي اتسم بالجودة والتجديد والبراعة، إلى جانب غلبة القيم المادية العلمانية.
فنتج عن ذلك حالة من التمرد ليس على الخطاب الشرعي فحسب بل على الدين والتدين والقيم والثوابت لدى الشباب([4]).
4- إلحاد تحصيل الأهداف: وذلك لأن الملحد يحصل من خلاف إلحاده غاياته وأهدافه من الحصول على الشهوات وإشباع ما يبتغيه من أمور لا يتيح له النظام الديني فعلها.
5- إلحاد التمرد: لأن هذا النوع قائم على جهل الملحد بالفارق بين المخلوق والخالق عزَّ وجلَّ الذي لا يحده زمان ولا مكان ولا منظومة الأسباب، حيث يصير الملحد في هذا النوع كأنه يحاكم الإله إلى منطقه وحدوده العقلية المحدودة، ويتفرع منه إلحاد المراهقين الذي يرجع إلى ما يمر به بعض المراهقين من التمرد ورفض آراء من يكبرهم سنًّا، وكذلك إلحاد النِّدية والكبر الذي ينظر فيه الملحد إلى الإله باعتباره رجلًا ذا قدرات خارقة؛ فيحكم على الإله بمقارنته بأفعاله هو، ويترتب على ذلك مثلا تساؤل الملحد عن ما يستفيده الإله من عبادتنا له طوال عمرنا، وهذه الأنواع ناتجة عن حالة رفض دائم للأوامر والنواهي الإلهية، وتساؤلات عن جدوى العبودية والانصياع للأمر الإلهي، وهي رؤية مبنية على جهل بالذات والصفات الإلهية، ويعد التمرد والرفض من أقوى الدوافع لهذا النوع من التساؤلات، وقد تكون الشهرة وطلب الجاه وذيوع الصيت دافعًا لهذا النوع من الإلحاد، وهو ما يسمى بإلحاد خالف تُعْرَف([5]).
خطورة هذا النوع من الإلحاد:
إن هذا النوع من الإلحاد تأتي خطورته هو طغيان داعية النفس على داعية العقل، وقد علمنا العلماء أن القلب فوق العقل، والعقل فوق السلوك، ومن عكس انتكس، فالملحدين في هذا القسم قدموا السلوك على كل شيء، بل تسعى المنابر الإلحادية لتعزيز ذلك. يقول الدكتور عمرو شريف: يبتعث الكثير من شبابنا إلى دول العالم الغربي والدول الشيوعية (سابقا) ويعاينون نمطا من الحياة تحتل فيه العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج موضعا محوريا باسم الصداقة والحب، كذلك فإن هذا النمط من الحياة يدخل بيوتنا عن طريق الإعلام والسماوات المفتوحة، كما تعرض المواقع الإباحية على الشباب كما كبيرا من المثيرات نتيجة لذلك، يطوق بعض الشباب إلى هذا النمط من الحياة وقد تمثل التنشئة الدينية حاجزا أخلاقيا وعبئا نفسيا يؤرقهم فيلجأ بعضهم للهروب من هذه المعاناة إلى إسقاط منظومات الإله والدين من حياتهم بالتنكر لها. اهـ
وهكذا يظهر أن الإلحاد في بلادنا خاصة بين المراهقين والشباب لم ينشا بتفكر عقلي أو بحث حول أدلة إثبات وجود الله تعالى، إنما التكاليف الدينية الشرعية، خاصة وأن الشباب يرفضون القيود مهما كان مصدرها، ويحرصون العيش وفق توجيه عقولهم، واختياراتهم الشخصية ومن هنا يسعون إلى تحطيم الثوابت وإنكارها، والنظر إليها على أنها تعارض حرياتهم الشخصية، وتمنعهم من الاستمتاع بحياتهم، وعلى رأس هذه الثوابت الدين والقيم فيتجهون نحو الإلحاد متحررين من كل قيد([6]).
المراد بحقوق الإنسان:
إن الماصدق والواقع الذي يعنيه الملحدون بحقوق الإنسان في هذا الباب وهذا الموضوع هو ما ذكرناه مسبقا من إطلاق العنان لكل ما جاءت به-على سبيل المثال- الشريعة الإسلامية في عالمنا العربي خاصة، والأديان بصفة عامة، لكننا سنعمم الموضوع ابتداء حتى يتبين صدق مدعاهم من عدمه.
الحق في اللغة كما في المصباح خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت([7]).
وفي الاصطلاح تعني الحق الثابت لكل فرد بصفته الإنسانية، فهذه الإنسانية الكاملة فيه التي تشكل كيانه، وتجسد ذاته البشرية وتكسبه حقوقا فطرية لا انفصال له عنها، ولا مجال لحرمانه منها، لكونها جزءا من آدميته، ونبعا من قدس روحه، فهي لصيقة به، متغلغلة في أعماقه، مترسخة في كيانه المادي والمعنوى.
ومن الصعب الوصول إلى تعريف محدد لحقوق الإنسان، فيعرفها البعض بأنها: مجموعة من الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، وفي أي مجتمع دون أي تمييز بينهم، في هذا الخصوص، سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو اللون، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني أو لأي اعتبار آخر.
ومما سبق يمكن القول بأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تختص ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع الحقوق والحريات وهذه الخصائص هي:
- حقوق الإنسان لها طابع العالمية فهي لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالا ونساء.
- حقوق الإنسان ليست منة من أحد، وهي ثابتة لكل إنسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها.
- حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة.
- حقوق الإنسان لا تقبل التصرف بالتنازل عنها فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولته.
- حقوق الإنسان متطورة ومتجددة فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف نواحي الحياة.
- حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر([8]).
حقوق الإنسان في الإسلام:
تعد الشريعة الإسلامية بمثابة الثورة في ميدان حقوق الإنسان، إذ إنها جاءت كشريعة دينية وروحانية ومنهاجا لتنظيم جوانب حياة الإنسان كافة على أساس تكريم الإنسان والإعلاء من شأنه والتي كانت بحق المنبع التي استقت منه فيما بعد سائر الفلسفات والقوانين والشرائع التي جاءت بمبادئ حقوق الإنسان، وقد جاءت هذه الشريعة بمبادئ سمحة وسط قوم طغى عليهم الاستبداد والعصبية ودرجوا على التفاخر بالأنساب وأهدرت عندهم حقوق الضعفاء أمام الأقوياء، فاستبدلت بذلك الأوضاع القائمة وجاءت تحريرا للأرقاء وصونا لحقوق الضعفاء، ومساواة بين الأجناس وظهور مجتمع جديد القوي فيه ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف فيه قوي حتى يؤخذ الحق له.
وقد جاء الإسلام ليرى أن هناك واقعا كان يسود فيه الظلم والاستبداد وامتهان لكرامة الإنسان واستباحة لحقوق الأفراد والجماعات، فقد تعامل معها بواقعية من حيث الصيغ التي وضعها من أجل أن يؤمن للفرد أو للجماعة حقوقهم من ولادتهم حتى لحظة مماتهم فلم يترك شيء إلا ونظمه، وقد استندت الكثير من القوانين والمواد على ما جاء في القرآن والسنة من حقوق الإنسان وصيغت على شكل مواد قانونية([9]). وقد برزت هذه الحقوق في العديد من الآيات القرآنية كقوله تعالى ﴿۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا﴾. وكقوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ﴾.
ولنتعرض من خلال هذا الطرح لكيفية تعامل الإسلام مع الظلم الذي وقع على الإنسان فيما يتعلق بحقوقه، فمن ذلك حق الرقيق وهي من الأمور التي يشوش بها البعض على المسلمين بسبب بعض تصرفات الجهلة المنتسبين إليه، وأيضا حق المرأة، وكذلك حقوق الأسرى وهم من الأعداء.
ظهر الرِّق والسبي منذ كان الاجتماع الإنساني، فقد كان مشروعًا قبل الإسلام في القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه: رقُّ الأسر في الحروب، ورقُّ السبي في غارات القبائل بعضها على بعض، ورقُّ البيع والشراء، ومنه رقُّ الاستدانة أو الوفاء بالديون.
ففي مصر القديمة كان الرقيق في مصر عبارة عن آلة للعمل، وكان أيضًا من الأشياء المعدة لمشاهد الزينة، ومظاهر الأبهة، فكان الأرقاء بقصور الملوك، وبيت الكهان، ودار المقاتلين([10]).
ومن نظر إلى تاريخ مملكة آشور في العصور السَّالفة علم أنَّ الاسترقاق كان عريقًا بها متأصلًا فيها، فقد كانت القصور مغتصة بالنِّساء والأرقاء المخصَّصين للجمال والزينة([11]).
وعند الصينيين كان الاستخدام للمنفعة العمومية موجودًا بها قبل التَّاريخ المسيحي بأجيالٍ طوال، يقوم به المحكوم عليهم والأسارى، ثم امتزجت أخلاق القوم بهذه العادة، فاستعملوا الاسترقاق، وكانوا يجلبون الرَّقيق من الخارج، أو يأخذونهم من ذات الصِّين، كما كانت تفعل الدَّولة نفسها، أمَّا من الخارج فبواسطة الحروب والأسلاب، إذ كانوا يوزعون الغنائم من أناس وأشياء على كبار الضبَّاط، أو يأتون بأثمانهم لخزينة الدولة، وأمَّا في نفس البلد فبسبب الفاقة والاحتياج، لأنَّ الفقير كان يضطر لبيع نفسه أو لبيع أولاده([12]).
وكانت اليهودية تبيحه؛ فقد وجد الاسترقاق عند هذه الأمَّة منذ الأزمان القديمة جدًّا، وكان الأرقاء في زمن أنبياء بني إسرائيل معدودين من أصول الثَّروة وأسباب الغنى عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحل والترحال والضَّرب في أطراف البلاد، وكان مقام الأرقاء كمقام الماشية، لكنه كان عندهم- كما عند غيرهم من سائر أمم المشرق- مقرونًا بالتَّلطُّف والتَّعطُّف اللذين لا يرى لهما مثيل في بلاد اليونان ولا في مدينة روما.
وقد نشأت المسيحية وهو مباح فلم تحرِّمه، ولم تنظر إلى تحريمه في المستقبل، وأمر بولس الرَّسول العبيد بإطاعة سادتهم كما يطيعون السَّيد المسيح، فقال في رسالته إلى أهل أفسس:
أيها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، ولا بخدمة العين كما يرضى الناس، بل كعبيد للمسيح عاملين مشيئة الله من القلب؛ خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أنَّ مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرَّب عبدًا كان أم حرًا.
وأوصى الرَّسول بطرس بمثل هذه الوصية، وأوجبها آباء الكنيسة، لأنَّ الرِّق كفَّارة من ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم، وأضاف توما الأكويني رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرِّق بل زكَّاه، لأنَّه- على رأي أستاذه أرسطو- حالة من الحالات التي خلق عليها بعض النَّاس بالفطرة الطبيعية، وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب([13]).
وفي الحضارة اليونانية كان مذهب أرسطو في الرِّق أنَّ فريقًا من النَّاس مخلوقين للعبودية؛ لأنَّهم يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر، فهم آلات حية تلحق في عملها بالآلات الجامدة، ويحمد من السادة الذين يستخدمون تلك الآلات الحية أن يتوسعوا فيها القدرة على الاستقلال والتمييز، فيشجعوها ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخرة إلى منزلة الكائن العاقل الرشيد.
وأفلاطون أستاذ أرسطو يقضي في جمهوريته الفاضلة بحرمان العبيد حق (المواطنة) وإجبارهم على الطَّاعة والخضوع للأحرار من سادتهم أو من السادة الغرباء، ومن تطاول منهم على سيد غريب أسلمته الدولة إليه ليقتص منه كما يريد.
وقد شرعت الحضارة اليونانية نظام الرِّق العام، كما شرعت نظام الرِّق الخاص أو تسخير العبيد في خدمة البيوت والأفراد، فكان للهياكل في آسيا الصغرى أرقاؤها الموقوفون عليها، وكانت عليهم واجبات الخدمة والحراسة، ولم يكن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعبادة العامة.
وانقضى على العالم عصور بعد عصور وهذا النظام شائع في أرجائه بين الأمم المعروفة في القارات الثلاث، ينتشر بين أمم الحضارة وقبائل البادية التي تكثر فيها غارات السلب والمرعى، ويقل انتشاره بين الأمم الزراعية عند أودية الأنهار الكبرى كوادي النيل وأودية الأنهار الهندية، إلَّا أنَّ الأمم في الأودية الهندية كانت تأخذ بنظام الطَّبقة المسخرة أو الطَّبقة المنبوذة، وهي في حكم الرقيق العام من وجهة النَّظر إلى المكانة الاجتماعية والحقوق الإنسانية.
وعلى هذه الحالة كان العالم كله يوم مبعث الدعوة الإسلامية من قبل الصحراء ليس فيه من يستغرب هذه الحالة، أو من يشعر بحاجة إلى تعديل فيها حيث يكثر الأرقاء أو حيث يقلون.
ففي البلاد التي كثر فيها عدد الأرقاء كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها مرتبطة بأعمال الرقيق في البيوت والمزارع والمرافق العامَّة؛ فلم يكن تغيير هذه الأوضاع مما يخطر على البال، ولم يكن تغييرها مستطاعًا بين يوم وليلة، لو أنَّه خطر على بال أحد.
وفي البلاد التي قل فيها عدد الأرقاء لم تكن هناك مسألة تسمى مسألة الرَّقيق وتستدعي من ذوي الشأن اهتمامًا بالتغيير والتعديل.
وكان عدد الأرقاء قليلًا في البادية العربية بالقياس إلى أمم الحضارة؛ إذ كان عددهم بين المسلمين الأوائل لا يزيد على عدد الأصابع في اليدين، فلم يكن بدعًا من الدِّين الجديد أن يترك الحالة في الصحراء العربية- وفي العالم- على ما كانت عليه، حالة لا يستغربها أحد، ولا يفكر أحد في تغييرها أو تعديلها؛ ولكنَّه لم يتركها، ولم يغفلها، ولم يؤجلها بين الإغضاء والاستحسان لهوانها وقلة جدواها، بل جرى فيها على دأبه في علاج المساوئ الاجتماعية والأخلاقية، يصلح منها ما هو قابل للإصلاح في حينه، ويمهد للتقدم إلى المزيد من الإصلاح مع الزمن كلما تهيأت دواعيه كما سيأتي بيانه([14]).
الشَّارع شرع العتق ولم يشرع الرِّق:
إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس العتق ولم يشرع لهم الرق بل حرمه جميعًا إلَّا نوعًا واحدًا يظهر بصورة واضحة أنَّه أبقاه على مضض من جهة معاملة الأعداء بالمثل فقط لا غير، إذ الأصل الحرية([15]) كما قرر الأئمة الأعلام، والرق عارض، وقد شرع الله سبحانه وتعالى ما يزيل هذا العارض الضعيف، وفحوى ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع، وأن الأمم الإنسانية لم تأتِ بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم من الإسلام قبل ألف ونيف وثلاثمائة عام.
فالذي أباحه الإسلام من الرِّق مباح اليوم في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق منذ القرن الثامن عشر إلى الآن، لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق تبيح الأسر، واستبقاء الأسرى إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة.
وهذا هو كل ما أباحه الإسلام من الرق أو من الأسر على التعبير الصحيح، وغاية ما هنالك من فرق بين الماضي قبل أربعة عشر قرنًا وبين الحاضر في القرن العشرين أن الدول في عصرنا هذا تتولى الاتفاق على تبادل الأسرى أو على افتداء بعضهم بالغرامة والتعويض، أما في عصر الدعوة الإسلامية فلم تكن دولة من الدول تشغل نفسها بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين، فمن وقع منهم في الأسر بقي فيه حتى يفتدي نفسه بعمله أو بماله، إذا سمح له الآسرون بالفداء.
ولكن الإسلام لم يقنع بهذا في إبان الدعوة، وأضاف إلى شريعته في أمر الرِّق نوافل وشروطًا تسبق الشَّريعة الدَّولية بأكثر من ألف سنة، فجعل من مصارف الزكاة إنفاقها في (الرقاب) أي فكاك الأسرى، وإذا كان ارتباط الأسرى ضرب لازب في الحروب، فالإسلام لم يجعله حتمًا مقضيًّا في جميع الحروب، وحرص على التخفيف من شدته ما تيسر التخفيف منه، وجعل المنَّ في التسريح أفضل الخطتين ﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ [محمد: 4].
قال الماوردي: «فورد بإباحة المن والفداء نص القرآن الذي لا يجوز دفعه، ثم جاءت به السنة…»([16]).
وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسير أو من أوليائه: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ﴾ [النور: 33].
وقد كثرت وصايا النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالأرقاء، وكانت من آخر وصاياه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وصيته بـ ((الصلاة وما ملكت أيمانكم))([17])، ونهى المسلمين أن يتكلم أحد عما ملك فيقول: عبدي وأمتي وإنما يذكرهم فيقول: فتاي وفتاتي كما يذكر أبناءه وبناته([18]).
وما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا: ((اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه)) فالتفت فإذا هو رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقلت يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هو حرٌّ لوجه الله فقال: ((أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار))([19]).
ولقي المعرور أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فلقت انتباهه التشابه التام بين ملبس أبي ذر وملبس غلامه، فسأله عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يا أبا ذر، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم))([20]).
ومن الوسائل الفردية التي تحرى بها الإسلام تعميم العتق وتعجيل فكاك الأسرى أنه جعل العتق كفارة عن كثير من الذنوب كالقتل الخطأ والحنث باليمين ومخالفة قسم الظهار ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ [النساء: 92]. ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ [المائدة: 89]. ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: 3].
ويحسب من الرذائل المأخوذة على الإنسان السيء أنَّه لا يقتحم هذه العقبة أو لا ينهض بهذه الفدية المؤكدة ﴿فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ١١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ١٣ أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ١٤ يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ١٥ أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ﴾ [البلد: 11- 16].
ومن أمثلة الطرق التي وضعها الإسلام لإنهاء حالة الرق أنه شرع المن على الأسير بدون فداء ولا استرقاق وشرع الفداء له من ذويه بالمال أو البدل مع الأسير المسلم قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 4]
وحرم الإسلام الإغارة القبلية وقطع الطرق على النَّاس وقد كان قطع الطرق على الناس وسرقتهم من موارد الرق فجعل الشرع على قطاع الطرق حدًّا من أشد الحدود وهو حد الحرابة: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33] ([21]).
النَّاظر للفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه يرى تلك القاعدة العظيمة التي يعلل بها ويُنظَّر على رغم أنف خوارج العصر، ويجرون بها أيضًا التحايل على إعمال العتق في العبد بأقل شائبة من شوائب الحرية ولو بالاحتمال، أو بمخالفة القياس المعهود في الفقه، ونصها: «الشارع متشوف إلى العتق»([22]) أو «الشارع متشوف إلى الحرية»([23]).
قال الغزالي في الوسيط في خواص العتق: «وهي خمسة: السراية، والحصول بالقرابة، والإمتناع من المريض فيما جاوز الثلث، والقرعة، والولاء.
الخاصية الأولى: السراية قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من أعتق شركًا له في عبد وله مال قوم عليه الباقي))([24])، ففهم من هذا أنَّ الشَّرع متشوف إلى تكميل العتق فلذلك نقول لو أعتق نصف عبد عتق الجميع، بل لو أعتق يده أو عضوًا آخر عتق الجميع وذلك بطريق السراية»([25]). وفي الشرواني على التحفة: «الشارع متشوف متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمال»([26]).
وقال الشيخ الدردير في الشَّرح الكبير في مقدمة باب العتق: «وهو من أعظم القرب ولذا جعل كفارة للقتل وكثير من الفقهاء يذكره بعد ربع العبادات نظرًا؛ لأنه قربة…» ثم قال: «إنما يصح؛ أي صحة تامة بمعنى اللزوم؛ أي إنما يلزم إعتاق مكلف من إضافة المصدر لفاعله، ويدخل في المكلف السكران فيصح عتقه على المشهور لتشوف الشارع للحرية»([27]).
- لماذا لم يحرم الله الرِّق تحريمًا باتًّا:
من الأمور التي لم تتمكن من نفس الخوارج أن الإسلام دين رحمة، ومن نماذج هذه الرحمة أن قد راعى الله سبحانه وتعالى حال البشر في التشريع، ولذلك نرى أن الأمور التي شرعها الإسلام منها ما هو مشرَّع على مرة واحدة، ومنه ما هو على صورة تدريجية، وكذلك في الأمور التي تمَّ تحريمها:
– فمن الأمور التي حرمت تحريمًا باتًّا الزنا والقتل والسرقة.
– ومن الأمور التي تم التدرج في تحريمها شرب الخمر وأأأكل الربا وليس في هذا مجاملة من الدين لأحد، فالإسلام لا يجامل ولا يحابي أحدًا، ولكنها الرحمة التي جعلها الله في الإسلام.
يقول الطَّاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره:«عن أنس بن مالك: حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر. فلا جرم أن جاء الإسلام في تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبة إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنان بذلك في قوله تعالى:﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ [النحل: 67] على تفسير من فسر السكر بالخمر. وقيل السكر: هو النبيذ غير المسكر، والأظهر التفسير الأول. وآية سورة النحل نزلت بمكة، واتفق أهل الأثر على أنَّ تحريم الخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب بأيام، أي في آخر سنة أربع أو سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب. والصَّحيح الأول، فقد امتن الله على الناس بأن اتخذوا سكرًا من الثمرات التي خلقها لهم، ثمَّ إن الله لم يهمل رحمته بالنَّاس حتى في حملهم على مصالحهم فجاءهم في ذلك بالتَّدريج، فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة التحريم، وأنَّ سبب نزولها ما تقدم، فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيها لهم، إذ كانوا لا يذكرون إلَّا محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم، قال البغوي: إنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله تقدم في تحريم الخمر)) أي ابتدأ يهيئ تحريمها يقال: تقدمت إليك في كذا أي عرضت عليك، وفي «تفسير ابن كثير» : أنها ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة، أي معرضة بالكف عن شربها تنزهًا»([28]).
ومن أمثلة ذلك أيضًا الرِّبا وذلك لكونه نظامًا تلبس به النظام الاقتصادي عند العرب فحرم على التدريج فبدأ بالآية: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون﴾ [الروم: 39]
حيث ساق موعظة سلبية تفيد أنَّ الربا لا ثواب له عند الله.
ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فحرمها بالتلويح لا بالتصريح حيث قصَّ علينا سيرة اليهود الذين حرم عليهم طيبات أحلت لهم ﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا١٦٠ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا﴾ [النساء: 160- 161].
ثم انتقل إلى مرحلة ثالثة وهي النهي عن الربا الفاحش الذي يتزايد أضعافا مضاعفة ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130].
ثم تدرج إلى المرحلة الأخيرة التي ختم بها تعاليمه في أمر الربا وفيها النهي فقال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: 275]([29]).
هذا كله يلفت الانتباه إلى قضيتنا في مسألة الرق التي ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة البشرية، فراعى الله سبحانه وتعالى حال البشر والنظام الاقتصادي الذي كان عليه العرب، وأيضا في ذلك رحمة من الله تعالى بالمسلمين أن يبقى ذلك على جهة التعامل بالمثل كخيار عسكري سياسي في ساحة الحرب.
ويضعنا في إجابة واضحة أن الإسلام حافظ على حقوق الإنسان مما اقترفته الأيدي البشرية، بل كان بداية لتصحيحها وإعلانها للناس.
فمعرفة أحوال النساء في البيئة العربية قبل الإسلام وإدراك المكانة المتدنية التي كانت تعيش فيها وانلظرة الجاهلية التي كانت تعامل بها، لهو أمر يكشف بجلاء عن التحول الذي صنعته رسالة الإسلام في تلك الأرض وفي هؤلاء العرب، فقد غيرت مفهومهم وتصورهم للمرأة وعدلت كثيرا من سلوكياتهم نحوها، وأشعرتها بذاتها وأفسحت لها مجال المشاركة في نصرة الرسالة الجديدة بكل ما تستطيع.
وعندما ننظر للمرأة في البيئة البدوية العربية نجدها مكروهة من الأبوين حيث كانوا يستاؤون لولادتها فإما يمسكونها على مضض وشعور بالخيبة والهوان والخوف من العار أو يدسونها في التراب، ويصف الله تعالى في كتابه الكريم حالهم في ذلك فيقول: ﴿وَيَجۡعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكۡرَهُونَۚ وَتَصِفُ أَلۡسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسۡنَىٰ﴾. وقال تعالى: ﴿وَيَجۡعَلُونَ لِلَّهِ ٱلۡبَنَٰتِ سُبۡحَٰنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَ٥٧ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾.
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ﴾.
وكانت المرأة تحرم تماما من حقها في إرث أبويها، فقد كان العرب يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة.
ولم يكن للمرأة على زوجها أي حق، يطلقها كيفما شاء ليس لطلاقاته إياها أي حد، ويعدد الزوجات مطلقا بلا قيد أو عدد، وإن مات الرجل عن زوجته وله أولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه يرثها إرثا كالمتاع، فإن شاء ألقى عليها ثوبا، إظهارا لرغبته في زواجها، أو يحبسها حتى تفتدي نفسها، أو يرغمها على الزواج بآخر ويأخذ منها صداقها، أو تموت فيذهب بمالها.
وكان من أشكال امتهان المرأة عند العرب ما اتخذوه من أشكال العلاقة بين الزوج وزوجته، فقد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن [ص: 16] ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك «فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم»([30]).
وقد رسخ الإسلام في عقيدة المسلم أن الناس سواسية بحسب خلقهم الأول، وأنه ليس هناك تفاضل في إنسانيتهم بين رجل وامرأة إلا بما يجري على ذلك من أسس مكتسبة خارجية، تتمثل في التقوى والعمل الصالح وذلك من خلال آيات عدة، منها: قوله تعالى ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۚ يَخۡلُقُكُمۡ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ خَلۡقٗا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقٖ فِي ظُلُمَٰتٖ ثَلَٰثٖۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ﴾.
وقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾.
وقد بين الله تعالى أن الرجل والمرأة من نفس العنصر، خلقهما الله زوجين متجاذبين حتى يخلق من اجتماعهما نسلا جديدا في آيات عدة، منها قال سبحانه ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ فَمُسۡتَقَرّٞ وَمُسۡتَوۡدَعٞۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَفۡقَهُونَ﴾.
وقال عز من قائل: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَاۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيفٗا﴾.
وقال تعالى ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۚ يَخۡلُقُكُمۡ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ خَلۡقٗا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقٖ فِي ظُلُمَٰتٖ ثَلَٰثٖۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ﴾.
والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قد كرم الرجل والمرأة بالتكليف دون تمييز بينهما، ورتب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية، سواء صدرت من ذكر أم أنثى، فهما متساويان في الجزاء والمؤاخذة، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾.
وقوله سبحانه ﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖ﴾.
وقوله تعالى ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا﴾.
وقوله تعالى ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا﴾.
وفيه قرن الله النساء بالرجال في فضائل الأعمال للتأكيد على المساواة بينهما في التكليف والجزاء.
بل ساوى سبحانه بين الرجل والمرأة على مستوى الحقوق حيث قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
كما نجد على مستوى التكريم والإحسان أن الشرع الشريف أوصى الرجل برعاية المرأة خاصة الزوجة وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾.
ونهى الإسلام عن ظلم المرأة أو البغي على حقوقها المادية أو المعنوية، فقال تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾.
ومن مظاهر تكريم المرأة في القرآن الكريم واحترام مكانتها أن سميت سورتان بهذا الاسم، سورة النساء، وسورة الطلاق، ويطلق عليها سورة النساء الصغرى، كما جاء اسم امرأة وتكرر في ثنايا الكتاب العزيز عدة مرات، وهي السيدة مريم بنت عمران، والدة سيدنا عيسى عليه السلام، وسميت سورة باسمها وهي سورة مريم.
ومما يؤكد عظم مكانة المرأة وعلو منزلتها خاصة المرأة الصالحة أن الله تعالى ضرب مثلا للمؤمنين جميعا بامرأة فرعون حتى يتخذها المؤمنون قدوة صالحة في إخلاص النية له سبحانه، والتمسك بالإيمان به حيث قال تعالى ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾([31]).
وعلى الرغم من وضوح دلالة آيات القرآن الكريم على مساواة الرجل والمرأة في أصل الخلقة والحقوق نجد أن التيارات الإلحادية تتمسك بآيات يوهم ظاهرها أن هناك ثمة تمييز بين الرجل والمرأة وهي:
1- قوله تعالى ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسَۡٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا﴾.
روي عن ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أي لا يتمنى الرجل يقول ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله»([32]).
وقال الطبري في تفسيره لهذه الآية: «ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض… فتأويل الكلام على هذا التأويل: ولا تتمنوا أيها الرجل والنساء الذي فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير، وليرض أحدكم بما قسم الله له من نصيب ولكن سلوا الله من فضله»([33]).
وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال بمعناه: أن للرجال نصيبا من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا وعملوه من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال، وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال بأن تأويله للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسب، وليس الميراث مما اكتسبه الوارث، بل هو مال أورثه الله عن ميته بغير اكتساب، وإنما الكسب العمل ،والمكتسب المحترف، فغير جائز أن يكون معنى الآية هكذا: للرجال نصيب مما ورثوا وللنساء نصيب مما ورثن، لأنه لو كان كذلك لقيل: للرجال نصيب مما لم يكتسبوا وللنساء نصيب مما لم يكتسبن([34]).
الآية الثانية: قوله تعالى ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا﴾.
وينتظم الكلام على هذه الآية فيما يلي:
أ- يلاحظ أن هذه الآية قريبة الشبه بالآية الكريمة التي سبق الحديث عنها، وأن هناك وحدة عضوية ونسقا واحدا يجمع بينهما، فقد تكرر فيهما قوله ﴿مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ (الرجال)، (النساء).
ولكن جاء في الآية الأولى لفظ (بعضكم) بضمير الخطاب وهو يفيد عموم المخاطبين، وأما في الآية الثانية جاء (بعضهم) متصلا بضمير الغائب الذي يعود على الرجال والنساء المذكورين في أول الآية الثانية، وذلك يشير إلى أن الآية تتحدث عن صنف خاص من الرجال والنساء وهما الأزواج.
ب- الرجال قوامون على النساء: هل تتحدث الآية عن جنس الرجال وجنس النساء كما يفهم من (الـ) الجنسية المتصلة بكليهما؟ ويتضح من سياق الآية بما لا يدع مجالا للشك أن الآية تتحدث عن الزوج وزوجته، حيث جاء فيها ﴿فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ﴾ ولا يصح لأي رجل أن يفعل ذلك إلا بزوجته.
ج- قوامون: نافذو الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن، وعن ابن عباس قوله ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله، وفضله عليها بنفقته وسعيه([35]).
وليس في قوامة الزوج على زوجته أي انتقاص لحقوقها أو امتهان لإنسانيتها وذاتها، والآية وإن جاءت في صيغة الخبر لكنها إنشائية تأمر الزوج بأن يقوم على حاجة أسرته بالرعاية والحماية والإنفاق، وتأمر الزوجة ألا تنازع الزوج فيما يأمرها به من معروف، وتخبر الآية أن الأصل في الأسرة الإسلامية أن تكون على هذا المنوال.
فالزوج يقدم لزوجته مهرا ويجهز منزلا للأسرة، ويطلب منه السعي والإنفاق على الأسرة وتلبية حاجاتها، وفي مقابل ذلك تحتكم الأسرة سواء الزوجة والأولاد في القرارات التي تمس الأسرة جميعها إلى الزوج، ولا يتصور حدوث نزاع داخل الأسرة في القيادة واتخاذ القرارات الحاكمة إلا في حالة اختلاف الرأي فقط، ولا بد في هذه الحالة من الوصول بالتشاور إلى حالة من الاقتناع بين الأطراف وإلا فيجب تغليب رأي فقط لفض النزاع والخصام، فإن أصر كل طرف على تنفيد قراره شاذا عن إرادة الأسرة وخارجا عن رضا بقية الأطراف فستتحول الأسرة إلى ساحة من النزاع والعراك، وهذا مضاد لإرادة الشارع الحكيم من الاجتماع الأسرى.
وإن احتسبنا هذه القوامة حقا أو تشريفا للزوج فإنه يفرض عليه من الواجبات التي يجب عليه القيام بها حتى ينال هذا الدور من القوامة، ولن يحصل على هذه القيادة هبة أو لمجرد ذكورته، فقد جاءت الآية لتبين الأسباب الموضوعية التي تبنى عليها هذه القوامة.
فإن أحسن الزوج القيام على أسرته، وكان أهلا لتحمل أعبائها ومسؤولية اتخاذ قراراتها، كانت القوامة حقا واجبا له على زوجته، والشرع لا يعطي صلاحيات أو سلطات لمجرد النوع ولكن لما ألزم الرجل بتحمل تكاليف الزواج وكذلك نفقات المعيشة التي تقيم الأسرة لم يكن من المعقول أن يفصل غيره في قرارات أسرته ثم يؤمر هو بتحمل تبعات هذه القرارات.
ولكن لم لم يسكت الشرع عن تحديد الطرف الذي يفصل في شؤون الأسرة المشتركة التي صار فيها نزاع ويترك الأمر عفوا لكل أسرة أن تدبر شئونها وترى الأصلح لها، فالأقوى في الأسرة وهو الذي يفرض رأيه على الآخر صالحا كان أو فاسدا؟
لقد علم الشارع أن في ذلك فساد الأسر وانهيارها، والقضاء على السلام فيها وتحولها إلى حلبة صراع وعراك دائم بين كلا الزوجين وبينهما وبين الأبناء حينما يشبهون، فالكل في هذه الأسرة يريد فرض سيطرته على الآخرين دون تفرقة بين معروف ومنكر ولا بين أمر خاص وأمر مشترك، وتكون النتيجة فشل الأسرة وتشتت أركانها وليس في ذلك مصلحة للزوج أو الزوجة أو الأبناء.
ولا تعني القوامة -بأي حال- أن يتحكم الرجل بواسطتها فيفرط في بقية القيم الأخلاقية الإسلامية، فيكون رأيه في الأسرة استبدادا وتسلطا، أو يأمر بالمعروف والمنكر والطاعة والمعصية بلا تفرقة، أو يتدخل في الأمور الخاصة بزوجته كأن يتدخل في عقيدتها فيكرهها على تغييرها أو يفتنها في دينها، أو يتدخل في تصرفاتها المالية الخاصة.
وذلك أن الزوجة المسلمة لا تطيع زوجها طاعة عمياء -ولا وجود لمثل هذه الطاعة في الإسلام- حتى طاعة الشارع لا بد أن تكون على بصيرة؛ فهي تطيعه في المعروف، فإن خالف وأمر بمعصية فلا طاعة له عليها، وكذلك حفظ الشرع للزوجة المسلمة بولاية كاملة على مالها، ولا سلطان للرجل عليه إلا بالمشورة والحسنى، وحفظ لها حريتها العقائدية، فليس لزوجها أن يكرهها على غير مرادها أو يتدخل في ممارستها لشعائر دينها، بل هو مطالب شرعا بتمكينها من إقامة هذه الشعائر.
وكل ما سبق فهو مترتب على الوضع الأصلي في الأسرة المسلمة ولكن طالما أن القوامة مرتبطة بأسباب معقولة ومنطقية، ولها علة ،فهي مرتبطة بعلتها وجودا وعدما، ومصلحة الأسرة تقتضي أنه لو تزوجت امرأة لسبب ما رجلا وكانت هي الأصلح علما وعقلا ودينا ومكانة في المجتمع المسلم، وكان الرجل على عكسها، يتوجب عليه شرعا وعقلا أن يجعل لزوجته القوامة والولاية على الأسرة، حتى وإن كان ذا سعة ويقوم بالإنفاق على الأسرة وذلك أن الله عز وجل رتب القوامة على أمرين، وقدم الفضل والصلاح على الإنفاق المالي.
وأما الآية الثالثة التي يأخذ بها من يدعون أن الإسلام مايز بين الرجل والمرأة، فهي قوله تعالى ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن “الدرجة” التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع، الصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه.
وذلك أن الله تعالى ذكره قال: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ عَقيب قوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحُقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهنّ وغير ذلك من حقوقه.
ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال تعالى ذكره: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ بتفضّلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: “ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها” لأن الله تعالى ذكره يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾.
ومعنى “الدرجة”، الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله تعالى ذكره، وإن كان ظاهرُه ظاهر الخبر، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درَجة([36]).
وأما الآية الرابعة فهي قوله تعالى : ﴿إِذۡ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرۡتُ لَكَ مَا فِي بَطۡنِي مُحَرَّرٗا فَتَقَبَّلۡ مِنِّيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ٣٥ فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ وَإِنِّي سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾.
فاستدلوا بقوله ﴿وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰ﴾ بأن هناك تمييزا في الحقوق، وهذا من كلام أم مريم عليهما السلام، متحرجة ومعتذرة إذ كيف توفي بنذرها وقد كان كهنة المعبد يمنعون الإناث من دخول القدس والقيام بالخدمة في الكنيسة.
وقد كانت امرأة عمران تنتظر ولادة النبي المنتظر الذي وعد به آل عمران، وقد نذرته خادما لبيت الرب، فلما ولدت أنثى وقعت في حيرة كيف توفي بنذرها، ولم تشر الآية إلى أن أم مريم كانت حزينة ومكتئبة أنها ولدت أنثى، بل على العكس من ذلك فقد كانت فرحة بمولودها لأنه جاءها على كبر، وقد طلبت من الله عز وجل أن يعيذ مريم ويحميها من الشيطان ويجعلها طاهرة نقية، وقبول الله عز وجل لمريم بقبول حسن وإرغام الكهنة والأحبار على إدخال مريم كخادمة من خدام البيت المقدس لهو تكريم وتشريف للمرأة([37]).
وأما السنة النبوية فهناك أحاديث تمسك بها بعض المغرضين ليقولوا أن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق وذلك
كوصف النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- النساء بنقص العقل والدين فيقول: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن)). والرواية تنصُّ على أن ذلك كان في يوم العيد([38])، فهل من الممكن أن يقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في يوم العيد مثل هذا الكلام الذي يؤذي المشاعر؟ ثم أليس في هذا الوصف انتقاص لقيمة المرأة ممَّا يتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟
والجواب عن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أراد أن يُفرِّح النساء في يوم العيد، فأخبرهم بمدى تأثيرهنَّ على الرجال، وأنَّ الرجل الحازم العاقل الذي يخوض الحروب ويضع الخطط وتُناط به المهمَّات وتُلقَى على كاهله المسؤوليات يكاد يذهب عقله إذا رأى المرأة، لما لها من تأثير عليه.
مع العلم أن المرأة مخلوق ضعيف لا قوة لها ولا حيلة، ومع ذلك كله بنظرة واحدة منها للرجل تخلب لبَّه ويهيم بها، فيفعل ما لا ينبغي فعله، ويقول ما لا يحسن قوله، وقد يشعل خصومات وحروب من أجلها.
وهذا التفوق يسرُّ المرأة معرفته، فهي عندما تسمع عن قدرتها على التأثير بالرجل تشعر بالتميز والفخر؛ وخصوصًا إذا جاء هذا الإخبار من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأين هذا الذي يقول إن في كلام النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما يؤذي مشاعرها، بل على العكس النبي بقوله هذا طيب خاطرهن وباسطهن وأدخل السرور عليهن في يوم العيد.
وينبغي علينا في هذا السياق أن نوضح المعنى المراد بنقصان العقل والدين بشيء من التفصيل حتى تتضح الصورة أكثر.
أولًا: المراد بنقصان العقل.
ليس المقصود من وصف النساء بنقص العقل أن العقل عندهم فيه مشكلة، وأن قدراتهم العقلية على النصف من قدرات الرجل، فمعلوم أن عقل الإنسان هو مناط التكليف وهو سر روحاني أودعه الله في البشر فيمتازوا به عن غيرهم من العجماوات، ومن خلاله تجري عمليات التفكير من تجريد وتحليل واستنباط وغيرها، فالعقل بهذا المعنى مما يشترك فيه الرجل والمرأة؛ بل قد نجد من النساء من يتفوقن على الرجال في ذلك، وسنضرب على ذلك أمثلة:
السيدة خديجة رضي الله عنها التي وصفها كتاب السيرة فقالوا: وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، فتكون عيرها كعامة عير قريش، وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة.
فهل يمكن أن يوصف بهذا من كان ناقص العقل، والمتأمل في الكلام يجد أنها تتاجر وتضارب في مالها ولا يقدر أحد على الاحتيال عليها؛ إذ لو كان الأمر كذلك لنفد المال منها، فهل يصدر هذا إلا من امرأة عاقلة واعية رضي الله عنها؟
وإن ننس لا ننس موقفها أوَّل ما نزل الوحي على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عندما جاء إليها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فزعًا وأخبرها بما حصل معه في غار حراء، فثبَّتت فؤاده وقوَّت من عزمه فقالت له: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ولم تكتف بهذا بل أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تنصَّر وله علم بالنصرانية، فقص عليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الخبر، فأخبره أن ما رآه هو الوحي الذي كان ينزل على الأنبياء قبله([39]). فهل يقدر على هذا التصرف إلا امرأة راجحة العقل قد امتلكت قوة في الرأي وثباتًا في الشدائد.
ومثال آخر: السيدة عائشة التي كان يرجع إليها الناس ليتعلموا منها الدين وكانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنها، جاء في الإصابة في تمييز الصحابة:
«قال أبو الضَّحى، عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة. وقال هشام بن عروة، عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبٍّ ولا بشعر من عائشة. وقال أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علمًا. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وأسند الزبير بن بكار عن أبي الزناد، قال: ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك! فقال: ما روايتي في رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا»([40]).
فكيف توصف بنقص العقل من كان عندها من الفقه والعلم وقوة الحفظ حتى تصبح مرجعية للرجال ينهلون من معين علمها الوسيع رضي الله عنها. والأمثلة في هذا الباب كثيرة:
ولسائل أن يسأل: ما المقصود بنقص العقل إذا لم يكن بمعنى الحط من قدرتها في الفهم والتفكير أو الحفظ؟
والجواب على هذا أن المرأة مخلوق عاطفي تغلب عاطفته على عقله، فلذلك قراراتها تصطبغ بصبغة عاطفية في الغالب، وقد خلقها الله على هذا النحو لحكمة باهرة؛ وذلك لأنها مأوى الزوج الذي يظل طيلة النهار يشقى في عمله، فتعطيه من حنانها وحبها ما يساعده على الكدح في هذه الدنيا، وهي التي تحمل وتلد وتربي الأولاد وترعاهم حتى يكبروا، وتتحمل كل المشاق في سبيل ذلك، ولولا العاطفة لما صبرت على كل هذه المتاعب وخاصة ما تلاقيه من تعب وأوجاع في الولادة.
ثم إن مهمة المرأة في رعاية البيت والأولاد لا تمكنها من الاحتكاك بالمجتمع واكتساب الخبرات ومعرفة طبائع الناس، فكل هذا يؤثر في مشاهداتها وخبرتها.
إذن عقل المرأة كامل في نفسه، لكن جاء النقص لعوارض خارجية، منها: العاطفة التي غلبت عليها بأصل الخلقة وأثرت على سلوكها، وأيضًا لزوم البيت لدواعي التربية والرعاية مما حدَّ من خبرتها الحياتية، فكان نقصان العقل لهذه الاعتبارات، لا لشيء في بنية عقلها وإلا فهي والرجل في ذلك سواء بدليل التساوي في التكليف.
ولذلك كله قرر الشرع الشريف أن يجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، فهي تنظر من منطلق عاطفي ونظرتها غير كاملة باعتبار قلة الخبرة التي ذكرناها، مما يجعلها عرضة للنسيان، فأضيفت لشهادتها حتى تكون كاملة شهادة امرأة أخرى معها، فتذكر كل واحدة منهما الأخرى إذا نسيت.
ثانيًا: المراد بنقص الدين:
ليس معنى الحديث أن الرجل دينه كامل والمرأة دينها ناقص، فكم من النساء بلغوا في الدين مبلغًا لم يصل إليه آحاد الرجال، بل قد تساوي امرأة في المكانة عند الله ألف رجل، ففاطمة بنت الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- وأمهات المؤمنين وآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وغيرهن من عابدات هذه الأمة وصالحاتها رضي الله عنهن خير شاهد على أن كمال الإيمان ليس مختصًّا بالرجل.
ولتوضيح معنى نقص الدين يقول الإمام النووي:
وأما وصفه -صلى الله عليه وآله وسلم- النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع، وقد قدَّمنا أيضًا في مواضع أنَّ الطاعات تسمَّى إيمانًا ودينًا، وإذا ثبَت هذا علمنا أنَّ مَن كثُرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به؛ كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم([41]).
ويقول الحافظ ابن حجر:
وليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الإثم؛ بل في أعم من ذلك، قاله النووي. لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي([42]).
إذن المقصود بنقص الدين في الحديث قلة الطاعة، وهذا شيء تعذر به المرأة، ولا يؤثر في أصل الدين؛ لأن الإيمان بأركانه موجود عند المرأة ولم ينقص، وهو يشبه من ترك الصوم بسبب السفر، فالمسافر دينه كامل، ولكن النقص حصل لجهة نقص الطاعة، فلا تأثير له.
وقد فهم النساء المسلمات هذا المعنى؛ ولذلك وجدنا نماذج من نساء صالحات عابدات في تاريخ المسلمين ازدانت كتب التراجم والسير بذكر أخبارهن في العبادة والزهد في هذه الدنيا، ونذكر من هؤلاء النسوة السيدة رابعة العدوية التي كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يسألها عن مسائل ويعتمد عليها ويرغب في موعظتها ودعائها. فقد ورد عن جعفر بن سليمان قال: أخذ بيدي سفيان الثوري وقال: مرَّ بي إلى المؤدبة التي لا أجدني أستريح إذا فارقتها([43]).
وكانت رضي الله عنها تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول: يا نفس كم تنامين، وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا ليوم النشور([44]).
فكيف لمن كان هذا حاله أن يوصف بقلة الدين بالمعنى الذي فهمه المشككون، ومثل السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها الكثير ممن ذكرهن العلماء، فابن الجوزي امتلأ كتابه «صفة الصفوة» بذكر المتعبدات وأحوالهن رضي الله عنهن، وأفرد السلمي كتابًا لهذا سماه «النسوة العابدات»، وغير هذين العالمين ممن كتب في سير صالحات الأمة مما لا مجال لذكره.
ولو أن نساء المسلمين منذ زمن الصحابيات إلى عصرنا هذا فهموا من الحديث ما فهمه الطاعنون؛ من أن النقص في أصل الدين؛ لما أتعبوا أنفسهن بصلاة ولا بصوم، ولكنهم عرفن مقصود النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فلم يجدوا فيه منقصة لهن، فثابرن في العبادة والطاعة، حتى رأينا منهن نماذج مشرفة تستنزل الرحمات بذكر أسمائهن.
أما قول الطاعنين في الحديث بأن فيه انتقاصًا للمرأة والنظر إليها على أنها أحط قيمة من الرجل؛ مما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فسببه قصور في فهم هذه المساوة التي أتى بها الإسلام.
فالمساواة في الشريعة الإسلامية تعني أن الرجل والمرأة متساوون في الإنسانية، والحقوق، والتكليف.
الأسر في اللغة يأتي بمعنى الشد بالقيد.
قال ابن منظور في اللسان: «الإسار: القيد ويكون حبل الكتاف، ومنه سمي الأسير، وكانوا يشدونه بالقيد فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يشد به. يقال: أسرت الرجل أسرًا وإسارًا، فهو أسير ومأسور، والجمع أسرى وأسارى. وتقول: استأسِر أي كن أسيرًا لي. والأسير: الأخيذ، وأصله من ذلك. وكل محبوس في قِدٍّ أو سجن: أسير. وقوله تعالى: ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]؛ قال مجاهد: الأسير المسجون، والجمع أُسَراء وأَسارى وأُسارى وأسرى»([45]).
وفي الاصطلاح عرفه الماوردي بقوله «هم المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء»([46]).
وفي القانون الدولي فمفهوم أسرى الحرب يأتي على نحو أوسع مما جاء منصوصًا عليه في الفقه الإسلامي، واطرد استعمالها في القانون الدولي بـ«أسرى الحرب»، فيعرفون بأنهم: «كل من يقع في يد العدو حيًّا من أفراد القوات النظامية المحاربة، أو من هو في حكمهم من المنظمات المسلحة أو التابعة للقوات النظامية من المدنيين أو المسلحين المدافعين عن البلاد أو الذين يقاومون الأعداء أو طواقم السفن التجارية الملاحية أو طواقم الطيران المدني أو غير المقاتلين من المنخرطين في القوات النظامية كأطقم الطائرات الحربية والمراسلين ومتعهدي التمويل والعمال وفرق الترفيه وكل من لهم علاقة بالقوات المسلحة غير الجنود المحاربين»([47]).
ثانيًا: أسرى الحرب في التاريخ الإنساني
إن النزاعات الواقعة بين البشر تعد من الظواهر الطبيعية التي لا مناص عنها، ولا يمكن استئصالها بحال، فهي ملازمة للإنسان منذ وجد على الأرض واستقر فيها، تصل في بعض الأحيان إلى القتال المسلح الذي يبدو كحل أخير لإنهاء النزاع بين الأطراف.
قال ابن خلدون: «اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسة، وإما عدوان، وإما غضب لله ودينه، وإما غضب للملك»([48]).
ولأجل ترجيح الكفة يلجأ أطراف الحرب دائمًا للأخذ بكل وسيلة ، لذلك لم تعرف الحرب الرحمة قط، يلجأ كل طرف للفتك بالآخر لإحراز النصر وترجيح الكفة، ومن الأمور الناتجة عن هذه النزاعات وقوع الأسرى من كل طرف في سلطة الطرف الآخر.
يقول الدكتور عبد الكريم فرحان: «ظهرت قضية الأسرى كإحدى نتائج الحرب الحتمية، فقتل الأسرى وذبحوا ومثِّل بهم وأكلت لحومهم في عصر الهمجية الأولى بدافع الانتقام والقضاء على الخصم، ولم يكن الغزاة في أيام الإنسان الأولى يبقون على أسراهم من الرجال إلا لغرض تعذيبهم أو ذبحهم في معابد الآلهة وكان الأسرى يقتلون عادة في ساحة المعركة تخلصًا من إطعامهم وإرهابًا لأقوامهم، وكان السبايا من النساء والأطفال يضمون إلى القبيلة ليزداد عدد سكانها ويتكاثروا بسرعة، ثم رأى الغالب أن يستفيد من الأسير، ولعل نشوء الزراعة هو الذي نبه المنتصر على إبقاء الأسير حيًّا، فقلت المجازر والمذابح، وقل أكل الناس بعضهم لحوم بعض، وهكذا ابتدأ الرق وأصبح الأسير عبدًا للظافر وجزءًا من متاعه وثروته وكان الملوك والزعماء والقادة أول من لجأ إلى ذلك للانتفاع بمواهب الأسير وطاقاته واستغلال قوته.
وسخر الأسرى في أشق الأعمال وأصعبها كإقامة الجسور وشق الجداول وفتح الطرق وبناء المعابد والأهرام والعمل في المناجم ثم أصبح الرق عاملًا على شن الحروب، لقد أدى القتال بين القبائل والجماعات البدائية إلى ظهور أعراف وعادات تحدد القتل فيعنوا أيامًا وأشهرًا لا يجوز القتال بها، كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز عصيانها ومنعوا الاعتداء في بعض الأماكن كالأسواق ودور العبادة وأخيرًا أدخلت النظام والقانون.
وقبيل ظهور المسيحية وفي أيامها الأولى أصبح فداء الأسرى وتبادلهم في الحروب مألوفًا باستثناء الحروب التي تجري مع القبائل البربرية والكفار فليس سوى القتل أو الاسترقاق في أحسن الأحوال وغدت غايات الحروب وأسبابها هي التي تتحكم في معاملة الأسرى ففي الحروب الدينية تقضي الفضيلة بقتل الأسرى والكفار، بينما نجد روما في عهد الامبراطور يوليوس قيصر تعج بالأحرار من الأسرى.
ثم تغيرت الحروب في القرون الوسطى وتبدلت بنتيجتها معاملة الأسرى، وبدأ ظل الاسترقاق ينحسر في أوربا واتسق نطاق المفاداة وتبادل الأسرى وقل تعرض المدنيين للأسر إذ ليس من العدل أخذهم بجريرة المقاتلين، وحدث تطور آخر مهم في معاملة الأسرى إثر ظهور نظام الجنود المرتزقة في الجيوش، حيث جنح هؤلاء إلى معاملة الأسرى بتساهل ولين خوفًا من تعرضهم هم بالذات للأسر في معارك مقبلة، فالغلبة ليست مؤكدة في جميع الأحوال.
وبدأت معاملة الأسرى تتحسن في أواخر القرن السادس عشر وكان للتعاليم الدينية وكتابات الفلاسفة الفضل الأول. فلقد أوصى كروشيس في كتابه قانون الحرب والسلام عام 1625م بإحلال الفداء وتبادل الأسرى محل الاسترقاق وجاءت معاهدة وستفاليا عام 1648م فأطلق سراح الأسرى من دون فدية وهكذا انتهى عهد استرقاق أسرى الحرب وظهر نظام تبادلهم وتوالت كتابات المفكرين والمصلحين في القرن الثامن عشر وكتب مونتسكيو في كتابه روح القوانين عام 1748م أن الحق الوحيد الذي يملكه الغالب هو منع الأسير من الأضرار وليس من حقه أن يعامله كمال أو متاع إنما ينبغي أن يسعى إلى إبعاده عن ميدان القتال فقط كما دافع عن الأسرى كتاب آخرون مثل روسو و دي فاتيلو، في منتصف القرن التاسع عشر اتسع نطاق القانون الدولي العام وتطورت قواعده وابتدأت الدول تعقد المعاهدات والتصريحات والاتفاقيات لتنظيم مركز أسرى الحرب وتقرير أنواع من الحماية القانونية لأشخاصهم وأموالهم بغية القضاء على القسوة وسوء المعاملة التي كان يلقاها الأسرى كما في تصريح (بروكسل) عام 1874م واتفاقية لاهاي عام 1899م و1907م واتفاقية جنيف لأسرى الحرب عام 1929م وأخيرًا أجمع مندوبوا 63 دولة في جنيف عام 1949م ووقعوا في 12 آب اتفاقية جديدة لحماية ضحايا الحرب لا زالت سارية المفعول»([49]).
والذي ذكرناه مذكور بالنسبة لحال العالم على وجه الإجمال، أما حال العرب الذين جاء فيهم الإسلام، يقول الدكتور جواد علي: «وكانت الغزوات والحروب أهم موارد لتجارة الرقيق، وهو مورد قديم معروف، فالغالب المنتصر يأخذ من يقع في قبضته من أسرى ويعده ملكًا له، وقد كان في إمكان الأسرى فك أسرهم بالفداء، أما من لم يتمكن من دفع الفدية منهم فيعد بحسب القانون ملكًا لآسره أو للدولة بحسب القوانين النافذة، فيجوز في هذه الحالة امتلاك الأسير وتشغيله في الأعمال التي يكلفه إياها سيده، ويجوز له إطلاق حريته وعدُّه حرًّا معتق الرقبة وبيعه في أسواق النخاسة، وقد كان تجار العبيد يفدون إلى هذه الأسواق ليبتاعوا منها العبيد الذين يحتاجون إليهم ويأخذونهم معهم إلى بلادهم ليبيعوهم مرة ثانية في أسواق النخاسة لمن هو في حاجة إليهم.
والحروب مورد من موارد الرزق للمحاربين الشجعان الذين يتمكنون من أسر من يبرز لهم، والأسر خير للآسر من محارب يقتله، فقتله لا يفيده من الناحية المادية شيئًا، سوى ما قد يقع في يديه من أسلابه، أما أسره فإنه يفيده فائدة مادية فعلى الأسير ترضيته بدفع فدية مرضية، إن أراد فك أسره وتحرير رقبته، وإلا صار عبدًا مملوكًا لآسره، له أن يمتلكه وله أن يبيعه والغالب أنه يبيعه في حالة عجزه عن تقديم فدية، أو عجز أهله عنها، كي يتخلص بذلك آسره من أخطار هروبه منه فيأخذه إلى الأسواق ويبيعه فيها»([50]).
ولئن كان الأسر خيرٌ للآسر؛ فإنه في تاريخ الإنسانية عذاب للأسير الذي يلحقه الرق بسبب الأسر ولم يستطع الفداء فيلحقه طيلة حياته؛ ويرث هذا العذاب مَن بعده- في غالب الأمم- من بعده ذريته، ليصيروا في الاعتبار الطبقي للمجتمع كالحيوانات.
جاء الإسلام والحال ما سبق الإشارة إليه في تاريخ الأسر، فأعطى للأسير الكرامة التي يستحقها لإنسانيته حتى وإن كان من المشركين المحاربين، فكان المبدأ المشار إليه أولًا في التعامل مع الأسرى في القرآن الكريم:
قول الله تعالى:﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8].
قال ابن عباس والحسن وقتادة: «إنه الأسير من المشركين»([51]) وقال قتادة: «لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك»([52]).
وقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((استوصوا بالأسارى خيرًا))([53]).
وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في بني قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف: ((لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا))([54]).
وقد طبق الصحابة هذا الأمر الإلهي، قال أبو عزيز بن عمير فيما رواه أحمد: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال له: شد يديك به فإن أمه ذات متاع. قال وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غدائهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال: فأستحي فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها([55]).
قال الدكتور وهبة الزحيلي: «وبموجب هذا نص الفقهاء على أنه لا يجوز تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة»([56]).
وقد أثار المستشرقون الكثير من الشبهات حول كون الإسلام لم يتعامل بالرحمة مع الأسرى.
يقول الدكتور الزحيلي بعد ما قرر ما أوجبه الإسلام للأسرى: «وبهذا يبطل ما يدعيه بعض الكتاب الغربيين من أن المسلمين كانوا يعاملون الأسرى معاملة ليست أقل قسوة من سابقيهم. وقد استندوا في ذلك إلى آية في القرآن الكريم: ﴿لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ٦٨ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [الأنفال: 68، 69].
فقد نزلت هذه الآية بعد مشاورة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- أصحابه في شأن أسرى بدر، بسبب أنه لم يكن قد نزل تشريع دائم بالنسبة للأسرى، فأشار الصحابة ما عدا عمر بأخذ الفداء منهم، فنزلت الآية يعاتب الله تعالى نبيه فيها على اتخاذ الأسرى قبل أن تقوى شوكة الإسلام، وقبل أن يتم خذلان العدو وقهره، فسبب نزول هذه الآية يدلنا على أن قتل المحاربين كان هو الشأن المطلوب في مبدأ قيام دولة الإسلام حتى يضعف المتظاهرون عليه، ويتضاءل الخطر على الدولة الناشئة، ولئلا يتجسس أحد على المسلمين. وليس الحكم المقرر في الآية تشريعًا دائمًا يعمل به حينما تستقر الأمور وتسير في طريقها الطبيعي. وهذا شأن كل دعوة أو ثورة إصلاحية لا بد لظهورها من التمكين لها في الأرض وعدم الاستخذاء أو الاستضعاف أمام الأعداء. وإذا عرفنا أن عادة قتل الأسرى وتعذيبهم كان هو السائد لدى الرومان والفرس واليهود، فإذن يكون حكم قتل الأسرى إذا أريد الأخذ به ملاحظًا فيه مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في بادئ التشريع، أو يكون ذلك لمجرد الامتنان والترغيب في الإسلام، وإظهار ما كان ينبغي أن يتبع بحكم العادة، وفي نشوة الظفر والنصر، لولا تسامح الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-.
وبناء عليه فكان الذي حدث مع ذلك هو الفداء ولم يحدث تقتيل للأسرى، فالعتاب من الله لرسوله هو في الظاهر وفي حالة من الضرورة لإيجاد جو من الرهبة تزول بزوال مقتضياتها، فقبول الفداء إذن لا يخالف إرادة الله في الواقع بدليل نزول آية أخرى محكمة تقرر مصير الأسرى: إما بالمن عليهم وإطلاق سراحهم أو بمفاداتهم على مال أو نفس. قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 4].
والخلاصة أن آية الإثخان في الأرض عتاب من أجل الأسر نفسه ولمجرد الأسر قبل أوانه ودون تحقق شرطه الذي هو الإثخان في عدو المسلمين وقهره طمعًا في عرض الدنيا. قال الإمام الرازي: «إن المراد من هذه الآية حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفداء، وذلك لا يدل على أن أخذ الفداء محرم مطلقًا، وإذن فلا تدل هذه الآية على جواز قتل الأسير، ولا تنافي بينها وبين آية ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 4]».
وفي التاريخ الإسلامي نجد ما يؤيد هذا الاستقرار التشريعي في الإسلام، فقد حاول عمر بن عبد العزيز معالجة مسألة الأسرى لا من المسلمين فحسب. ولكن من الروم أيضًا مما يدل على امتلاء قلبه بحب البشرية كما هو مقتضى تعاليم الإسلام، فقد دخل في مفاوضات مع البيزنطيين للبحث في مسألة فداء المسلمين الأسرى الذين وقعوا في الحملات التي وجهت في آسيا الصغرى طوال حكم الخلفاء السابقين»([57]).
إذن فقد كانت معاملة الأسرى في الإسلام قائمة على الرحمة والإحسان، وليس على طلب الثأر أو حظ النفس.
ويتلخص التعامل الفعلي مع الأسرى في الإسلام في أربعة أمور، يقول ابن حجر في الفتح: «ومحصل أحوالهم: تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض … ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار، ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقًا، وهل يصير رقيقًا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء»([58]).
أما أمر المن أو الفداء فلكونه مذكورًا في القرآن ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 4].
وهذا هو الأصل في أمر الأسرى، قال الشيخ أبو زهرة: «لقد ذكر القرآن الكريم أن القائد أو ولي الأمر مخير بين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يفديهم وإما أن يمن عليهم بإطلاق سراحهم.
والفداء قد يكون بالرؤوس فيطلق أسارى المسلمين في نظير أن يطلق المسلمون أسراهم، وقد يكون بالمال، فإن الأسير قد يكون فقيرًا لا مال له، أو رئي من المصلحة الإسلامية إطلاقه ففي هذه الحال يمنُّ عليه ويكون الصفح الجميل، وهو العلاج في هذه الحال ويكون العفو عن عباد الله»([59]).
ونستطيع أن نقول إن أمر المن والفداء هما المراد الأول، ومن أنكرهما محجوج بفعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال ابن قدامة: «ولنا، على جواز المن والفداء قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 4]. وأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منَّ على ثمامة بن أثال، وأبي عزة الشاعر، وأبي العاص بن الربيع، وقال في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيًّا، ثم سألني في هؤلاء النتنى، لأطلقتهم له. وفادى أسارى بدر، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلًا، كل رجل منهم بأربعمائة، وفادى يوم بدر رجلًا برجلين، وصاحب العضباء برجلين»([60]).
وهذا مشروط في الفقه بالمصلحة استدلالًا بما هو ثابت في الشريعة من مراعاتها للمصلحة ودفع المفسدة، وأمر القتل أو الاسترقاق ذكر الفقهاء أن ذلك مرجعه إلى تقدير الإمام ورأيه فيما يحقق مصلحة المسلمين؛ بشرط مراعاته للضوابط العامة السابق ذكرها في الشريعة الإسلامية.
أما أمر القتل: فقد اتفق عليه الفقهاء مشروطًا بما يراه الإمام.
- قال الجصاص: «اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير، لا نعلم بينهم خلافًا فيه، وقد تواترت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قتل الأسير، منها قتله عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث الذي قتل بعد الأسر يوم بدر، وقتل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد أسره، وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية، ومنَّ على الزبير بن باطا من بينهم، وفتح خيبر بعضها صلحًا وبعضها عنوة، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئًا، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله، وفتح مكة وأمر بقتل هلال ابن خطل، ومقيس بن سبابة، وعبد الله بن أبي سرح، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة … إلى أن قال فهذه آثار متواترة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك»([61]).
فعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، مع كونهما أسيرين إلا أنهما تماديا في معاداة المسلمين وتعذيبهم في مكة مع ضعفهم، أما الباقون فإن كانوا أسارى، إلا أنهم خانوا العهد ولا شك أن جريمة مثل جريمة «الخيانة العظمى» معروفة عقوبتها في القوانين المحلية والدولية.
فأما أبو عزة الشاعر فكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أسره يوم بدر، ثم مَنَّ عليه وأطلقه بغير فداء، وأخذ عليه ألا يعين عليه، فنقض العهد، فأسر يوم أحد، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فضرب عنقه صبرًا([62])، وأما بنو قريظة فقد خانوا العهد مع إصرارهم على الكفر وحوكموا محاكمة عادلة فقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى سعد، فأتاه على حمار، فلما دنا قريبًا من المسجد، قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- للأنصار: ((قوموا إلى سيدكم)) أو ((خيركم))، ثم قال: ((إن هؤلاء نزلوا على حكمك))، قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، قال: فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قضيت بحكم الله))([63]).
فهذه حالات خاصة عوقب فيها الأسرى بجرائم فعلوها مع الاعتبار بأن حق العفو مكفول للإمام، ويفعل ما فيه المصلحة للأمة.
وهذا الأمر يشبه تمامًا أمر الرق، فقد اتفقت البشرية بموجب الاتفاقيات الدولية على منع الرق ووضعه أثناء الحرب، فلو اتفقت كذلك الدول على منع قتل الأسير وجب الالتزام بذلك والمصير إليه، ويعد خرقه خرقًا للشريعة الإسلامية التي دعت غلى احترام المواثيق والعهود.
- وقد رأى بعض الفقهاء كراهة القتل وهو محكي عن الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير([64]).
قال الدكتور وهبة الزحيلي: «والحاصل أن سبب الخلاف بين الفقهاء في قتل الأسرى هو معارضة ظاهر القرآن لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك أن ظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 4] الآية، أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن والفداء، وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [الأنفال: 67] الآية والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل في بادئ أمر الرسول عليه السلام أفضل من الاستعباد على حد تعبير بعض العلماء وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في أحوال معينة.
ونحن قد دفعنا هذا التعارض بأن قتل الأسرى في السنة كان لحالات خاصة، أو لحسم مادة الفساد إن خيف ألا تحسم بغير هذه الذريعة.
وقلنا: إن آية أسرى بدر كانت لإظهار الامتنان على الناس بعدم قتلهم مع أنهم كانوا يستحقون القتل أو إنها لمجرد العتاب على الأسر نفسه كما قلنا سابقًا. وتكون القاعدة المطردة في الأسرى هي العفو.
قال رجاء بن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط ما تحب من العفو. وهو معنى قول الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- في ذكر خصال الخير عند المؤمن و((إذا قدر عفا))([65]) فتعاليم الشريعة الإسلامية ترجح جانب الفضل والإحسان عند القدرة، وما نقرره موافق لما قاله قوم من العلماء: لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن حمد التيمي أنه إجماع الصحابة. وقال الشيعة الإمامية: إن أخذ الأعداء بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا. واستدلوا بأن إباحة القتل هي لدفع المحاربة، قال الله تعالى: ﴿فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ وقد اندفع ذلك بالأسر وانقضاء الحرب، فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعدما ثبت في رقاب الأسرى وذلك لا يجوز، ومما قد يدل لهذا كما سيأتي تفصيله في فصل انتهاء الحرب بالإسلام أن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- أنكر على خالد بن الوليد قتل أسرى بني جذيمة حين قالوا: سبأنا صبأنا، في حين أنه امتنع بعض الصحابة من قتلهم، فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري([66]).
إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحة، وإن أبيح فهو دواء ناجع في حالات فردية خاصة وللضرورة القصوى، وليس ذلك علاجًا لحالات جمعية عامة. وقد منع الشافعي وأبو يوسف قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاجة إلى إضعاف العدو وإغاظته أو ما تمليه المصلحة العامة العليا للمسلمين»([67]).
ونعود فنؤكد على أن ذلك كله مقيد بما استقر عليه في القانون الدولي من تحريم قتل الأسرى، فحتى لو كان هناك خلاف بين الفقهاء قديمًا في هذه القضية فقد انحسم هذا الخلاف بموجب توقيع المسلمين على اتفاقيات منع قتل الأسرى، ولا سبيل للأخذ بقول من يجيز ذلك.
وأما بالنسبة لقضية الرق فنقول:
إن الإسلام -كما هو معلوم من نصوص الشريعة– متشوف للعتق، وقد كان الرق في القديم متعدد الأسباب، فجاء الإسلام وحدد السبب بأمرين:
أحدهما: وهو الحرب المقيدة بأنها قانونية منتظمة، وأنها حرب ضد الكافرين.
والثاني: وهو أن يولد شخص من أم رقيقة من غير سيدها. أما ما يصير به العتق فكان في الأمم السابقة واحد؛ إرادة السيد، فجاء الإسلام فعدد أسباب العتق.
جاء في الموسوعة الكويتية: «وكان طريق التخلص من الرق الذي انتهجه الإسلام يتلخص في أمرين:
الأمر الأول: حصر مصادر الاسترقاق بمصدرين اثنين لا ثالث لهما، وإنكار أن يكون أي مصدر غيرهما مصدرًا مشروعًا للاسترقاق:
أحدهما: الأسرى والسبي من حرب لعدو كافر إذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقهم.
وثانيهما: ما ولد من أم رقيقة من غير سيدها، أما لو كان من سيدها فهو حر.
الأمر الثاني: فتح أبواب تحرير الرقيق على مصاريعها، كالكفارات، والنذور، والعتق تقربًا إلى الله تعالى، والمكاتبة، والاستيلاد، والتدبير، والعتق بملك المحارم، والعتق بإساءة المعاملة، وغير ذلك»([68]).
إذا كان الأمر كذلك فالشارع المتشوف للعتق لا يجعل من الرق خيارًا في الأسرى إلا لالضرورة والمصلحة التي يراها الإمام كما هو أمر القتل.
إذن فكل من ضرب الجزية على الأسير وذلك بأن يقيم في بلاد الإسلام، أو الاسترقاق بأن يصير عبدًا، أو القتل فهذه أمور –كما ذكرنا- مراعى فيها مصلحة المسلمين بالدرجة الأولى وليست قائمة على التشهي، بل بما يراه الإمام لائقًا بالحال، وهي تكون من قبيل المعاملة بالمثل.
وبالعودة لمسألة الرق نقول: إن الإسلام متشوف إلى العتق، وما ضرب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على حرٍّ الرق قط، بل ما جاءه من رقيق أعتقه، تطبيقًا لأمر الشارع.
والرق كان -كما ذكرنا- في بداية المبحث أمرًا شائعًا وذائعًا بين الأمم، وكانت أسبابه ومنابعه كثيرة متعددة، بداية بالحرب؛ فالفقر؛ فالدين … إلى غير ذلك من الأسباب، وكان الذي يعطي للرقيق حريته أمر واحد فقط وهو «إرادة سيده» فلما جاء الإسلام سعى في تجفيف تلك المنابع كلها وجعلها منحصرة فقط في أمر الحرب، وعدَّد منافذ العتق التي بها حصول الحرية وبأي وسيلة كانت؛ ولذا قرر العلماء بالإجماع كما ذكرنا أن «الشارع متشوف إلى العتق».
قال الشيخ محمد أبو زهرة: «ولم يفرض الاسترقاق -أي في القرآن- وهو الأمر الثالث، وبذلك يتبين أن القرآن ليس فيه إذن بالاسترقاق، بل فيه ما ينفيه وإن لم يكن بصريح العبارة فإنه يكون بما تضمنته الإشارة.
وإن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم ينشئ رقًا على حر قط، وما كان عنده من رقيق في الجاهلية فقد أعتقه، وما أهدي إليه من رقيق بعد ذلك أعتقه وهكذا.
إذًا فلماذا كان في الإسلام رق؟ ولماذا وجد الرق في عهد الراشدين وهم الذين اهتدوا بهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؟
والجواب عن ذلك أن نصوص القرآن لم تمنعه صراحة، وإن كانت أميل إلى المنع، والنبي لم يقره، وإن لم يمنعه، وبقى الأمر فيه لما يقضي به قانون المعاملة بالمثل، فإن كان الأعداء يسترقون كان للمسلمين أن يسترقوا من قبيل المعاملة بالمثل، وإن كانوا لا يسترقون فلا يحل للمسلمين أن يسترقوا لأن ذلك يكون اعتداء وهم منهيون عنه»([69]).
وهذا في مناقشة المشروعية، أما الرق من حيث هو فقد علم مما ذكرناه سابقًا أن الإسلام يأنفه ويتشوف إلى العتق، ولهذا ووفقًا لما اجتمعت عليه الأمم في العصر الحديث– وفي مقدمتها الأمة الإسلامية- في أواخر القرن التاسع عشر فقد اتفقوا على إنهاء الرق والعبودية في العالم؛ وبهذا صار الرق محرمًا شرعًا وقانونًا؛ ولا مصلحة فيه بوجه من الوجوه، وكونه خيارًا مطروحًا في أمور الحرب ممنوع قولًا واحدًا، لأنه ما كان إلا تعاملًا بالمثل، فلما انتفى من العالم وجوده انتفت الحاجة لأن يكون خيارًا مطروحًا في أمور الحرب.
يقول أحمد شفيق في كتابه الرق في الإسلام: «لا يجهل أحد من الناس ما بذلته إنجلترة من المساعي في إبطال الاسترقاق، وأنها لأجل نوال هذه الغاية الإنسانية قد عقدت العهود وأبرمت المواثيق مع عدد عظيم من دول أوربا وآسيا وأمريكا وأفريقيا، وبعد أن لاقت في طريقها صعوبات جمة قد فازت بالنجاح ونالت الأرب، وقد اشتركت مصر في ذلك، وأبرمت معاهدة مع إنجلترة في 3 أغسطس سنة 1877م من مقتضاها أن الاسترقاق والنخاسة ملغيان في جميع أنحاء القطر المصري، ومن جملته السودان، وقد عملت حكومتنا على مقتضى أصول الدين وقواعده من حيث الحض على العتق، فلم تكتف بمراعاة نص هذه المعاهدة، بل فعلت ما هو زائد عليها، فوضعت أقلامًا عديدة في جميع الأقاليم لعتق من يطلب ذلك منها من الأرقاء، وجميع هذه الأقلام تحت ملاحظة الماهر النشيط الميرالاي شارل شفر بك مدير عموم مصلحة إلغاء الرقيق، والنتائج التي نجمت عن هذا الترتيب ظاهرة لا يصح نكرانها».
وقد كان من ضمن هذه الجهود التي ذكرها الأستاذ أحمد شفيق في كتابه فتاوى القضاة والعلماء في البلدان الإسلامية المختلفة التي تحرم النخاسة تحريمًا يبنى عليه تحريم ما هو واقع من الفظائع في أفريقيا الوسطى، وجدولًا إحصائيًّا ببيان العتقى بمصر، والأوقاف التي خصصت لهم بعد موت مواليهم.([70]).
وقد تلخص ممما سبق أن قتل الأسير واسترقاقه لا يباح في هذا العصر بسبب تغير الواقع عما كان عليه في زمن الفقهاء، بالإضافة إلى أنه يخالف الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الدول الإسلامية.
حقوق الإنسان المرادة عند الملحدين
من الأمور التي هي مسلمة عند المسلمين أنه لا حاكم إلا الله، والحاكم اسم فاعل من حكم يحكم حكما، ومعناه عند الأصوليين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
فالحاكم هو من يصف أفعال البشر بهذا الخطاب، والذي له حق تصنيف ووصف أفعال البشر بالمنع أو بالإقدام في شريعة المسلمين هو الله وحده.
ومن هنا تميز دين الإسلام عما سواه جملة واحدة:
فدين الإسلام يرى أن:
الإنسان مخلوق عظيم.
وأن هذا الخالق مريد.
وأرسل إلى بني البشر رسالة، فأنزل كتابا هو القرآن على نبي هو محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-.
وأن هناك ما يسمى بالتكليف، وحقيقته إلزام أو طلب ما فيه كلفة أو مشقة من عباد الله، وهذا ما يسمى بالشريعة.
وأن الله عز وجل لم يترك فعلا من الأفعال الصادرة من العباد إلا وقد صفها بصفة من الصفات الخمس وهي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة.
من هنا كان الإنسان مكلفا، أي ملتزما بشريعة تأمره وتنهاه، وهو في طريق حياته يحاول أن يلتزم بهذه الشريعة، فلا يخرج عنها، وإن خرج فإنه يحاول أن يعود إليها، ما دام على عقيدته، ووجهة نظره الشاملة للكون والإنسان والحياة، وإجابته عن الأسئلة التي اختلف فيها الفلاسفة عبر العصور، من أين نحن؟ (السؤال عن الماضي).
وماذا نفعل الآن ؟ وما وظيفتنا في تلك الحياة؟ وكيف نعيش فيها ؟ إلخ. (أي السؤال عن الحاضر).
وماذا سيكون بعد هذه الحياة ؟ (أي السؤال عن المستقبل).
فالعقيدة الإسلامية: تجيب بوضوح هو سر قوتها، وبجلاء هو سر تمسك المسلمين بها وببساطة هي سر انتشار الإسلام في جميع أركان الأرض، وعن جميع أصناف البشر تجيب على هذه الأسئلة، بأن الله هو الذي خلق، وأن علينا في هذه الدنيا أن نعبده كما أمر في رسالته، وأن نعمر الدنيا بناء على قواعد وضحها في رسالته من أن الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾. ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا﴾.
وأن الإنسان هو سيد في الكون، لا سيد للكون، ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُ﴾، فالسيادة للكون هي لله، والكون خادم للإنسان وهو سيد فيه، وأن هذا الكون قد بني على الاتساق والتآلف لا على الصراع والتنافر.
وأن المتخالفات والمتضادات تكون منظومة واحدة ﴿وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ٣٧ وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ٣٨ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ٣٩ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ﴾.
وأما المذهب الديمقراطي الغربي: فإنه يصف الأفعال البشرية بناء على نظرية المنفعة والتي اشتهرت بالنظرية البرجماتية، وهذه المنفعة يحددها كل إنسان لنفسه على المستوى الشخصي، وتحددها هيئة نيابية تسمى بمجلس النواب، وهم مختارون عن طريق الانتخاب من الشعب وبأغلبيتهم يتم إصدار القوانين المنظمة لحركة الناس في المجتمع، والحاكمة على الأفعال بالحسن والقبح، فمصدر الأحكام آيل إلى الشعب عن طريق نوابه، أو بعبارة أدق عن طريق الغالبية من نوابه، وهم عندما يحكمون على الأفعال بتلك الصفات يراعون فيها مصلحتهم التي تتراءى لهم في وقتها ويغيرون من هذه الصفات كلما أرادوا وتغيرت المصالح.
ومن هنا فإنهم كفروا بالمطلق وبكل معيار ترد إليه الأفعال، وهم قد خرجوا بذلك عن قضية التكليف والالتزام بشرع معين، ودعوا إلى تبني الحرية في كل شيء، في العقيدة وفي التصرفات الشخصية، وأصبح إطارهم المرجعي في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة هو أن قضية الألوهية مسألة شخصية، وأننا الآن ينبغي أن نعيش حياتنا الدنيا بما يحقق مصالحنا، وكفروا في مجملهم باليوم الآخر، في ظل ذلك التوجه قالوا بنظريات التطور، التي شملت كل المجالات حتى وصلت إلى اللغة بعد علم الأحياء والاقتصاد والاجتماع وغيرها، وملأوا الأرض بباطل ما يسمى بالحداثة، وما بعد الحداثة، ونتج من ذلك كله أزمة داخل المنظومة الغربية([71]).
إذن فمسألة هذه الشبهة لا ترجع في حقيقتها إلا لترتيب عقول الذين يثيرونها، أنهم ما عادوا يفكرون بعقولهم، بل يفكرون بشهواتهم، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا، وأثار هذه الشبهة نقول له ما معنى إيمانك بالله، أليس هو أن تجعله سبحانه وتعالى حاكما في تصرفاتك في هذه الحياة، فأوجب عليك كذا وكذا، ومنع عنك كذا وكذا.
أما من لا يقنع إلا بشهواته ويجعلها مقدمة على عقله فقد قال المولى سبحانه وتعالى فيه: ﴿أَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيۡهِ وَكِيلًا﴾، وقد قال علماؤنا رضي الله عنهم: القلب فوق العقل، والعقل فوق السلوك، ومن عكس انتكس!
([1]) حالة التدين في مصر، إلحاد الإسلاميين نموذجا- مراصد- كراسات علمية(ص 41) تأليف: أحمد زغلول شلاطة، مكتبة الإسكندرية، وحدة الدراسات المستقبلية، 2014م.
[2])) انظر: وهم الإلحاد: (ص 143ـ 144).
([3]) انظر المرجع السابق (ص 145).
([4]) الإلحاد المعاصر سماته وآثاره- مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر (ص 983) تأليف: سوزان بنت رفيق، ع 35، ج 2.
[5])) انظر: الإلحاد (مفهومه وأسبابه والموقف منه) (ص 16)، د. ابتسام بنت عبد الرحمن الفالح، مجلة معالم الدعوة الإسلامية ـ جامعة أم درمان الإسلامية، العدد 9، 2016.
([6]) انظر: الإلحاد في العالم العربي الأسباب والعلاج (ص 47) د/ حنان عطية ضيف الله، مجلة الجامعة العراقية، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ع 44، ج 2.
([7]) انظر: المصباح المنير (حقق).
([8]) انظر: حقوق الإنسان المفهوم والتطور التاريخي والفئات، المجلة المصرية للقانون الدولي، هشام بشير، مج 72 (ص 435- 437).
([9]) المرجع السابق (ص 444، 445).
([10]) انظر: الرق في الإسلام (ص 15) لأحمد شفيق، ترجمة أحمد زكي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
([13]) انظر: الرق في الإسلام (ص 17). وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه (ص 142) لعباس محمود العقاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
([14]) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (143).
([15]) انظر: الأشباه والنظائر (2/ 23) للسبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1991م.
([16]) الحاوي الكبير (14/ 174) للماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1999م.
([17]) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ (1625) من حديث أنس بن مالك. قال البوصيري: «هذا إسناد حسن». انظر: مصباح الزجاجة (3/ 139) للبوصيري، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
([18]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي (2552)، ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد (2249) من حديث أبي هريرة.
([19]) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (1659).
([20]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (2545)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه (1661).
([21]) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (ص 142- 144). والمساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق (ص 20- 23) د. علي جمعة، دار المعارف، 2013م.
([22]) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 463).
([23]) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 45) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية.
([24]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق (2503)، ومسلم في مقدمة كتاب العتق (1501).
([25]) الوسيط في المذهب (7/ 463) للغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، الطبعةالأولى، 1417هـ.
([26]) انظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي (10/ 394) لابن حجر الهيتيمي، المكتبة التجارية الكبرى، 1357هـ- 1983م.
([27]) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (4/ 359) دار الفكر، بيروت.
([28]) التحرير والتنوير (2/ 340) للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
([29]) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي (1/ 104) علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 2000م، والتفسير المنير (3/ 91) د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانية، 1418هـ.
([30]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي (5127).
([31]) المساواة الإنسانية في الإسلام (ص 23- 28).
([32]) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (3/ 935).
([33]) تفسير الطبري (8/ 260، 265).
([34]) المساواة الإنسانية في الإسلام (ص 30).
([37]) انظر: المساواة الإنسانية في الإسلام (ص 42).
([38]) الحديث بتمامه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: ((يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار)) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن))، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)) قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُم)) قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان دينها)). أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (304)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (80).
([39]) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ومسلم في الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (160).
([40]) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (14/ 30).
([41]) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 68).
([42]) انظر: فتح الباري (1/ 407).
([43]) انظر: النسوة العابدات (ص 387) لأبي عبد الرحمن السلمي، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998 م
([44]) انظر: تاريخ الإسلام (4/ 617).
([45]) انظر: لسان العرب (باب الراء ، فصل الهمز مع السين).
([46]) انظر: الأحكام السلطانية (1/ 207) للماوردي- دار الحديث – القاهرة.
([47]) انظر: معاملة أسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي (ص234) إحسان عبد المنعم سمارة- مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية- المجلد الثالث- العدد: 12 – محرم لعام 2011م.
([48]) انظر: تاريخ ابن خلدون (1/ 334) تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ- 1988م.
([49]) انظر: تاريخ الأسرى (ص 6) عبد الكريم فرحان- دار الطليعة – بيروت – الطبعة الأولى – 1979م.
([50]) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (14/ 144) دار الساقي – الطبعة الرابعة- 2001م.
([51]) انظر: مفاتيح الغيب (30/ 216) للرازي – دار الكتب العلمية – بيروت – 1421هـ.
([52]) انظر: تفسير الطبري (24/ 97) تحقيق: أحمد شاكر – مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى – 1420هـ – 2000م.
([53]) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الصغير (409) وفي الكبير (22/ 393) من حديث أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير رضي الله عنهما، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 86).
([54]) ذكره الواقدي في مغازيه (2/ 514).
([55]) أخرجه الطبري في تاريخه (2/ 460) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2968) من حديث نبيه بن وهب منقطعًا، وتقدم تخريجه بنحوه من حديث أبي عزيز بن عمير.
([56]) انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص 405) وهبة الزحيلي– دار الفكر– دمشق– الطبعة الثالثة– 1419هـ- 1998م.
([57]) انظر: المرجع السابق (407).
([58]) انظر: فتح الباري (6/ 152) لابن حجر – دار الفكر.
([59]) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص 122، 123) محمد أبو زهرة – دار الفكر العربي – 1415هـ – 1995م.
([60]) المغني (9/ 221) لابن قدامة– مكتبة القاهرة- 1388هـ- 1968م.
([61]) أحكام القرآن (5/ 296) للجصاص- تحقيق: محمد صادق القمحاوي – دار إحياء التراث العربي – بيروت- تاريخ الطبع: 1405هـ.
([62]) انظر: جوامع السيرة (ص 139) لابن حزم الأندلسي الظاهري، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
([63]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل (3043)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد (1768).
([64]) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 221).
([65]) أخرجه بنحوه الحاكم في مستدركه (433) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي ومعناه صحيح: فقد أخرج مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع (2588) من حديث أبي هريرة مرفوعا وفيه: ((وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزًّا)).
([66]) ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (4339) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
([67]) آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص438).
([68]) الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 298).
([69]) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص 122).
([70]) الرق في الإسلام، رد مسلم على الكردينال لافيجري (ص 77- 78) أحمد شفيق – ترجمة: أحمد زكي- مؤسسة هنداوي- القاهرة.