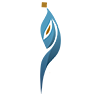الشُّبهة الأولى: شبهة علاقة الدين بالعنف.
من الشبهات السائدة خاصة في الإلحاد العربي: علاقة الدين بالعنف، وهي من الشبهات التي يثيرُها الملحدون في المجتمع المسلم لتنفير الناس من الدين، وتأكيدًا لمفهوم الإسلاموفوبيا، وتندرج هذه الشبهة تحت نوعَيْن من الإلحاد:
ثانيا: إلحاد المحامي الفاشل.
أما جهة اندراجها تحت إلحاد الشبهات فذلك لأنَّ الملحدين يركزون من خلال هذه الشبهة على أمور واردة في القرآن أو في السنة النبوية أو في التاريخ الإسلامي تُظْهِرُ أنَّ الدين الإسلامي دينُ عنفٍ ودين قسوة، وهذا نتيجة لقراءة خاطئة.
وقد ركزت منصات الإلحاد العربية بل والغربية أيضًا على هذه الشبهة تحديدًا في استقطاب المتشككين والشباب إلى الإلحاد، فنجد مثلًا أنه في الشبهات التي تتعلق بالقرآن الكريم وتمثل عشرين بالمائة في مؤشراتنا للإلحاد: عشرة بالمائة منها تمثل هجومًا على القرآن الكريم باعتباره مصدرًا للإرهاب، وكذلك عشرة بالمائة فيما يتعلق بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم اتهام له بأنه شخصية تحضُّ على الإرهاب، وأن غزواته غزوات نهب وسلب، بل بالتتبُّع للإحصائيات التي ستَرِدُ في نهاية هذا البحث نجد أن ما يتعلَّق بشبهة علاقة الدين بالعنف المباشر أو العنف البنيوي أو الثقافي تصل إلى العشرة بالمائة تقريبًا.
وأما جهة اندراجها تحت إلحاد المحامي الفاشل فلأن إلحاد المحامي الفاشل إلحادٌ قائمٌ على خطأ منهجي، يحمِّل فيه الملحد الإسلامَ وزرَ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض من ينتسبون إليه، وأغلب الملحدين في هذا النوع من الغرب المتأثرين بالإسلاموفوبيا، أو العرب الذين عانوا من وطأة التيارات الإسلامية المتشددة، لكنه بدلًا من أن يتحقق من كون الممارسات هي نتاج فهم صحيح أو خاطئ للدين، حمَّل الملحدُ الدينَ الوزرَ ولم يفرقْ بين الدين وبين المنتسبين إليه.
ولما كانت هذه الأفعال الصادرة عن المتطرفين لا يمكن أن تكون مرجعيتها الدينية منضبطة، فقد اتجهوا بدلًا من محاولة تبرئة الدين إلى نفيه جملة وتفصيلًا، وأن ما يسمى بالدين هو محضُ أفعالٍ بشرية غير سوية لمجموعة من المتطرفين.
وسنتعرَّض في بيان هذه الشبهة لأهم الشبهات المنبثقة عنها التي يدور حولها الملحدون مع بيان الرد عليها، وأهم هذه الشبهات المتعلقة بعلاقة الإسلام بالعنف:
- القرآن يحض على العنف وذلك من خلال آيات الجهاد.
- شبهات تتعلق بأن السنة النبوية تدعو إلى العنف وقتل غير المسلمين.
- تصرفات بعض المسلمين التي لها علاقة بالعنف.
أولا: شبهة أن القرآن يحض على العنف وذلك من خلال آيات الجهاد
وهذه الشبهة التي وجدت في كتب الملحدين أعانهم على تثبيتها في عقول البعض خوارجُ العصر من الدواعش وغيرهم من الجماعات الإرهابية؛ إذ رفعوا علم الجهاد، وشوَّهوا صورة الإسلام في أعين الناس، وهي تندرج تحت نوعَي الإلحاد السابق ذكرهما.
لقد شُرع الجهاد في سبيل الله لأجل غايات نبيلة وأهداف كريمة عزيزة وليس لأجل القتال للقتال، أو القتال لاحتلال دول أخرى بهدف الاستيلاء على خيراتها واسترقاق رجالها وسبْي نسائها!
وقد وقعت الجماعات المتطرِّفة في أخطاء جسيمة في فهم الجهاد وما جاء فيه من نصوص الشَّريعة، فلوَّوا أعناقها، وفرَّقوا بين ما حقه أن يجمع، وجعلوا لأنفسهم جهادًا مستقلًّا عن فهم علماء أهل السنة، فهبوا لا ليقاتلوا المعتدي على الأرض كما هي شعاراتهم ودعاواهم، بل كان القتال للمسلمين الموحدين، فهو جهاد خاص بدين هؤلاء الخوارج لا الجهاد الذي شرعه الله ورسوله، نستشفُّ ذلك من مقدمة الضال عبد الرحمن العلي المعروف بالمهاجر في (مسائل من فقه الجهاد) حيث يقول: «وإن كان من كلمة تقال بين يدي هذا الجزء فهي أني ما كتبت هذه الرسالة للمعرضين عن أمر الله، النافرين من شرعه، المستهزئين بأحكامه، الكارهين لما أنزل، كما لم أكتبها للمقدمين عقولهم بين يدي الله ورسوله، المستبدلين بنور السماء ظلمات الأرض من زبالة الآراء، ونحاتة الأفكار والأهواء، وسياسات كفرة الشرق والغرب، كما لم أكتبها كذلك لأولئك المنهزمين أمام واقعهم، الملبسين الحق بالباطل، المداهنين في أمر الله من أهل الترقيع والتلفيق بزعم الإصلاح والتوفيق؛ أولئك الذين يرغبون في كل شيء إلا في أخذ الدين بقوة!
وإنما كتبتها للخاضعين لأمر الله، المذعنين لأحكامه، المستسلمين لشرعه كاستسلام الميت بين يدي مغسله، بل أشد…
كتبتها لهذه الفئة القليل عددها، العظيم عند الله قدرها»، ليعدد بعد ذلك صفات تلك الطائفة قائلًا في نهاية مقدمته: «لهؤلاء ولهؤلاء فقط كتبت هذه الرسالة»، ويعني بالطبع جماعتَه من خوارجِ العصر في قاعدة الجهاد سابقًا، وتنظيم الدولة لاحقًا.
لقد صار للجهاد عند هؤلاء نسق خاص، وتطبيق خاصٌّ بهم، لا يتحقق إلا به، نسق يتخلَّص فيه المسلم من آدميته وأخلاقه الإسلامية ليفسدَ في الأرض بعد إصلاحها، ويحرق ويقطع، ويلبي شهواته الحيوانية، متسترًا بغطاء الشرع، وهو منه براء، وصدق الله إذ يقول: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ٢٠٤ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ﴾ [البقرة: 204، 205].
وقد نبَّأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبارهم وحذَّرنا من أفعالهم، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: «إنما أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيَأْمَنُني الله على أهل الأرض فلا تَأْمَنُوني» فسأله رجل قَتْلَه، -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعه، فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذا، أو: في عقب هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»([1]).
والجهاد يأتي لغة مشتقًّا من (جهد) وهي دالة على المشقة وبذل الوسع. قال الفيُّوميُّ في المصباح المنير: «جاهد في سبيل الله جهادًا واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته»([2]). وقال الرَّاغب الأصفهانيُّ: «الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوِّ، والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوِّ الظَّاهر ومجاهدة الشَّيطان، ومجاهدة النَّفس»([3]) اهـ.
وما ذكره الرَّاغب الأصفهانيُّ من جهاد غير العدوِّ -أي الشَّيطان والنَّفس- هو ما جاء به الحديث النَّبويُّ في الكلام عن (الجهاد الأصغر) و(الجهاد الأكبر)، ففيه: «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه»([4]).
وأما في الشَّرع: وهو ما تواردت عليه كتب الفقهاء من اختصاص كلمة الجهاد بـ(القتاليِّ) وعرَّفوا الجهاد فيه بـ(القتال)، فكما عرَّفه ابن الكمال: «بأنَّه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةً أو معاونةً بمالٍ، أو رأيٍ أو تكثير سوادٍ أو غير ذلك»([5])، قال ابن عابدين: «كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب»([6]) وهذا المعنى للجهاد هو الَّذي ذكروا له من الشُّروط والأحكام ما سيأتي بعضه في موضعه، ويأتي ذكر الجهاد في كتب الفقه بأبوابٍ إمَّا مترجمة باسم (الجهاد) أو باسم (السِّير) أو باسم (المغازي) لأنَّ الأحكام الَّتي تذكر فيه متلقاة من سير الرَّسول صلى الله عليه وسلم وغزواته([7]).
الفرق بين مصطلح الجهاد ومصطلح الحرب:
والجدير بالذكر هنا أن نبين اختلاف مفهوم الجهاد عن مفهوم الحرب في فقه القانون الدولي الحديث؛ حيث ينظر فقهاء القانون الدولي للحرب على أنها وسيلة لغاية السياسة للحصول على بعض المكاسب المادية أو السياسية دون مراعاة للقيم أو المبادئ الأخلاقية او الروحية.
وقد عرَّف فقهاء القانون الدولي الحرب بأنها: حالة قانونية تتولد عند نشوب كفاح مسلح بين القوات المسلحة كدولتين أو أكثر مع توفر نية إنهاء العلاقات السلمية بين إحدى هذه الدول، أو لديها جميعًا([8]).
فالحرب عبارة عن صراع دموي بين إرادتين مراد كل منهما التفوق على الأخرى، وتحطيم مقاومتها، وحملها على التسليم لها بما تريده من شروط معينة يفرضها الطرف القوي، وينزل عليها الطرف الضعيف المنهزم، وصورة هذا الصراع هي العنف أبدًا، وشكله القتال بين قوتين متخاصمتين، وبذلك تكون الحرب هي أقصى صورة للتنافس البشري، وهي أشبه ما تكون بعملية التطور الذي يأخذ دوره بين الكائنات الحية في صورة صراع دائم ينتهي ببقاء الأقوى أو الأصلح، ثم يتجدد بظهور عناصر أقوى وأصلح تقضي على ما قبلها.
أما علماءُ الفقه الإسلامي فإنهم لم يعبروا عن مفهوم الجهاد بالحرب اتباعًا للقرآن الكريم، ولما تحمله هذه الكلمة من معنى الصراع والتناحر ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات الغير بغير وجه حق، إنما عبروا بلفظ الجهاد وهو لفظ شرعيٌّ، ولم يكن الجهاد يومًا مقصورًا على القتال وحده، ولم تكن كذلك كلمة الجهاد في عرف المسلمين ولا مفهوم أهل اللغة مرادفة لمفهوم الحرب، بمعنى إرغام الناس على اعتناق دين معين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم، كما فهم ذلك خطأً بعضُ علماء الغرب وشعوبهم.
ونظرًا لتمايز مفهوم الجهاد في المنظور الإسلامي عن مفهوم الحرب في منظور القانون الدولي الحديث، تمايز تبعًا لذلك مفهومُ العهد أو المعاهدة بين المنظور الإسلامي والقانون الدولي. ويوضح الدكتور خالد رمزي الفرق بين المعاهدات في الإسلام والمعاهدات الحديثة بقوله: يفهم من قوله تعالى: ﴿فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 4] عدم قتال أهل العهد ما داموا في عهدهم، وحتى إن نقضُوا عهدهم، فإنَّ الأصل ألا يقاتلوا إلا بعد إعلامهم أنَّ العهد معهم تم نقضُهُ من طرفهم، ولا يمكن تصور قتالهم غدرًا من قبل المسلمين؛ لأنَّ النُّصوص الشَّرعية تعتبر الغدر خُلقًا ذميمًا ينبغي البعد عنه.
بينما النَّاظر في أحوال الحروب الحديثة يرى أنها لا تُراعي حرمة المعاهدات، إنما تعتبرها حبرًا على ورق، ومقياس الالتزام بهذه المعاهدات في أيامنا هذه مدى ما تحققه من مصالح، بعكس النظرة الإسلامية لمسألة الالتزام بالمعاهدات، فإنَّها غيرُ مرتبطة بالمصالح، وإنما بمسألة الوفاء بالعقود، وهي مسألة تتعلَّق بأصول العقيدة، مما يعطي المسألة بُعدها الدِّينيِّ اهـ([9]).
ومن خلال تحليل هذه التعاريف يتبين لنا الآتي:
– أنَّ الجهاد غايتُهُ إعلاء كلمة الله تعالى، ويكون ابتداء بالطُّرق السِّلمية، وذلك بالدَّعوة الصحيحة إلى دين الله عزَّ وجلَّ بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو جهاد الحجة.
– أن الجهاد كما يكون بالحجة، قد يلجأ فيه إلى القتال، وإن وقع القتال فإنه يكون بين المسلمين وأعدائهم من الكافرين -المعتدين المحاربين- ولا يمكن تصور وقوعه بين المسلمين أنفسهم، وحين يلجأ ضرورة للقتال فإن الغرض منه يكون واضحًا، وهو حمايةُ دولة الإسلام ورعاياها والمحافظة على سير الدعوة الإسلامية دون صعوبات، ولا يمكن أن يكون غرضُ الجهاد التسلُّط على رقاب الناس وسيادة الأمم، وهذا بخلاف ما نصَّ عليه فقهاء القانون الدولي في تعريف الحرب فإنَّهم لم يراعُوا في تعاريفِهم سوى الاستيلاء والسَّيطرة على ممتلكات الغير، وتدمير مقاومة الخصم، حتى ولو كانوا جميعًا من نفس الدِّين.
إنَّ فهْم قضية الجهاد والتعامُل معه التعاملَ الصَّحيح يقتضي أن يُنظر إلى تاريخ مشروعيَّته، وكيف كانت مراحله المختلفة الَّتي شُرع من خلالها حتى وصل إلى صورة الجهاد الموجود في كتب الفقه؛ وهو الجهاد الَّذي يُحفظ به الإسلام، ويردُّ به العدوان، وتحفظ به مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، وهذه الأهميَّة يدلُّنا عليها استفاضة كتب الفقه في ذكر مراحلها التاريخيَّة في استهلال الكلام على الجهاد في بابه ابتداءً من البعثة أحيانًا، وابتداءً من دعوة الأنبياء على العموم أحيانًا أخرى.
والجهاد ليس حكمًا تشريعيًّا خاصًّا بالأمَّة الإسلاميَّة فقط، بل هو من الأحكام الَّتي جعلها الله سبحانه وتعالى لكلِّ أمَّةٍ، دلَّنا على هذا آياتُ القرآن في قصَّة طالوت وجالوت، وما كان بين سليمان وملكة سبأ، وما كان من قصَّة ذي القرنين.
أمَّا الجهاد في الإسلام فكان بالأصالة مشروعًا في فترة دعوة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قومه بمكة، إلَّا أنَّ الفارق بين هذا الجهاد وجهاد ما بعد الهجرة النبويَّة هو أنَّ جهاد مكة كان ممنوعًا فيه القتال، قال الإمام النَّوويُّ: «وكان القتال ممنوعًا منه في أول الإسلام وأمروا بالصَّبر على أذى الكفَّار، فلمَّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجبت الهجرة على من قدر، فلمَّا فتحت مكة ارتفعت الهجرة منها إلى المدينة، ونفي وجوب الهجرة من دار الحرب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، ثمَّ أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفَّار بقتال»([10]).
وأمَّا الجهاد الَّذي كان بمكَّة فقد أشارت سورة الفرقان -وهي مكِّية النُّزول- في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا﴾ [الفرقان: 52] وفي سورة النَّحل: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [النحل: 110]، وهي مكِّية كلها عند جمهور علماء التفسير ومنهم ابن الزُّبير، والحسن البصريُّ، وعكرمة، وعطاء، وجابر، وقال ابن عباس هي مكِّية إلا ثلاث آيات منها وهي الآيات [95، 96، 97] بدءًا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشۡتَرُواْ بَِٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [النحل: 97]؛ أي فليس منها الآية الَّتي نحن بصددها، بل هي مكِّية على كلا القولين.
وخالفت قلة فذهبت إلى أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾ الآية، ممَّا نزل بالمدينة([11]). فهو «مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين ومن ورائه أصحابه بدعوته إلى الحقِّ وتفنيد ما كانوا يعكفون عليه من تقاليدِ الآباء والأجداد، وإنَّ من أهمِّ أنواعه ثباته وثباتهم معه على الصَّدع بكلمة الحق مهما جرَّ ذلك عليهم من أنواع الشِّدة والإيذاء، وإن من أهمِّ أنواعه مضيَّهم في التَّبصير بكتاب الله والتَّعريف به والتَّنبيه إلى إخباراته وأحكامه دون أيِّ مبالاةٍ بالأخطار الَّتي كانت تحدق من جرَّاء ذلك بهم»([12]).
ثمَّ لمَّا هاجر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد «القتاليَّ» ولم يكن هكذا دفعةً واحدةً؛ بل كان على مراحلَ، كلُّ مرحلة لها أسبابها تبيِّنه آيات الجهاد في القرآن الكريم.
قال ابن عابدين: «ثمَّ اعلم أنَّ الأمر بالقتال نزل مرتبًا، فقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورًا أوَّلًا بالتَّبليغ والإعراض: ﴿فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [الحجر: 94]، ثمَّ بالمجادلة بالأحسن ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: 125] الآية، ثمَّ أذن لهم بالقتال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْ﴾ [الحج: 39] الآية، ثمَّ أمروا بالقتال إن قاتلوهم: ﴿فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ [البقرة: 191]، ثمَّ أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] ثمَّ أمروا به مطلقًا: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾»([13]).
فابتدأ الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد (القتاليِّ) بآية: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْ﴾ [الحج: 39] الآية، قال قتادة: «وهي أوَّل آية نزلت في القتال، فأذن لهم أن يقاتلوا»([14])، ثمَّ بيَّن الله سبحانه وتعالى سبب هذا الإذن بقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ﴾ [الحج: 40].
قال الطَّبريُّ في تفسيره: «أذن الله للمؤمنين الَّذين يقاتلون المشركين في سبيله بأنَّ المشركين ظلموهم بقتالهم»([15]).
وقد استمرَّ أمر القتال في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قائمًا على رد العدوان من المشركين، حتَّى نزلت آية التوبة: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 5].
قال البدر العيني: «هذه الآية الكريمة في سورة براءة، وأوَّلها قوله عز وجل ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 5]، نزلت في مشركي مكَّة وغيرهم من العرب؛ وذلك أنَّهم عاهدوا المسلمين، ثمَّ نكثوا إلَّا ناسًا منهم، وهم بنو ضمرة وبنو كنانة، فنبذوا العهد إلى النَّاكثين، وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين إن شاؤوا لا يتعرض لهم، وهي الأشهر الحرم، وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها، فإذا انسلخت قاتلوهم»([16]).
وقال الحلبيُّ في السِّيرة: «ثمَّ لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس، وتعرَّضوا لقتالهم من كلِّ جانب، كانوا لا يبيتون إلَّا في السِّلاح، ولا يصبحون إلَّا فيه، ويقولون: ترى نعيش حتَّى نبيت مطمئنِّين لا نخاف إلَّا الله عز وجل، أنزل الله عز وجل: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗا﴾ [النور: 55] ثم أذن في القتال أي أبيح الابتداء به حتَّى لمن لم يقاتل أي لكن في غير الأشهر الحرم أي الَّتي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم؛ أي بقوله: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] الآية، ثم أمر به وجوبًا أي بعد فتح مكة في السَّنة الثَّانية مطلقًا؛ أي من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ﴾ [التوبة: 36]؛ أي جميعًا في أيِّ زمن»([17]).
فالمستقر من هذه الآيات أنَّ السَّبب التَّشريعيَّ الأوَّل في الجهاد هو دفع الظُّلم الواقع على المسلمين بما كان من تعذيب المشركين للمؤمنين وإيذائهم لهم وإخراجهم من أوطانهم ومصادرة أموالهم حتَّى جاء أمر الله بالهجرة، فشرع الله الجهاد حمايةً للإسلام وللمؤمنين ودولتهم، وردًّا للظُّلم والعدوان الواقع عليهم، كان في بداية الأمر دفعًا للقتال بمثله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾ [البقرة: 190]، ﴿فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ إلى آخر هذه الآيات، ثمَّ لما ظهر العناد المستمر من العرب، بل وعدم احترامهم للعهد، مع إظهار الله سبحانه وتعالى الآيات والعلامات الدَّالة لكلِّ مريد للحقِّ؛ أمر الله سبحانه وتعالى نبيَّه بتعميم أمر القتال في العرب، وهذا لأنَّ معنى القتال وهو العدوان ما زال فيهم لم يزل ولم يبق منهم إلَّا عناد وجهل، وهذا المعنى هو الَّذي يطلق عليه (الحرابة)، ومع هذا أعطى المولى سبحانه وتعالى لمن أراد معرفة الحقِّ أن يأخذ الأمان ليسمع آيات الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ﴾ [التوبة: 6].
ولأجل ما سبق بيانه كان المعنى في الجهاد هو (الحرابة) بمعنى الاعتداء من العدوِّ، وإعلانه الحرب.
مكانة الجهاد من أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة ومقاصدها
النَّاظر للجهاد– كما وضحناه- يجد أنَّ معنى الحرابة واضحٌ فيه؛ فالجهاد باعتباره فردًا من أفراد قسم المعاملات في الفقه الإسلامي ليس مشروعًا لذاته، ولا لأجل اختلاف الدين، ولا لحمل الناس على الدخول في الإسلام، بل هو مشروعٌ لأجل حفْظِ مقاصدِ الشَّريعة الإسلاميَّة جميعها.
قال العلائيُّ في قواعد المذهب: «والضَّرب الثَّاني -أي من أقسام المعاملات- هو أقسام المضارِّ الخمس الضَّروريَّة، وهي: مضرَّة النُّفوس، والأديان، والأموال، والأنساب، والعقول، فيدخل في الأوَّل أحكام القصاص في النَّفس والطَّرف وأحكام الدِّية فيهما وما يتعلَّق بذلك، ويدخل في الثَّاني أحكام الكفر والإسلام وما به يصير الشَّخص مسلمًا وكافرًا وأحكام الرِّدَّة ومن يقرُّ على دينه من الكفَّار بالجزية وما يتعلق بها من الأحكام ويتَّصل بذلك عقد الهدنة أيضًا»([18]).
وقال البيجوريُّ في حاشيته تعليقًا على قول صاحب الجوهرة:
| وحفظ دين ثمَّ نفس مال نسب | ومثلها عقل وعرض قد وجب |
«قوله: «دين» أي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، والمراد بحفظه صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات، فانتهاك حرمة المحرَّمات أن يفعل المحرَّمات غير مبالٍ بحرمتها، وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبالٍ بوجوبها، ولحفظ الدِّين شرع قتال الكفَّار الحربيين وغيرهم كالمرتدِّين»([19]).
وقال ابن عابدين في حاشيته في مقصود الجهاد: «إخلاء الأرض من الفساد»([20]).
فمشروعيَّة الجهاد آتية بسبب ما سمي بـ(الحراب). قال الكاساني: «فالمبيح للدَّم على ذلك هو الكفر الباعث على الحراب»([21]) وهو الاعتداء.
و«الحراب» في اللغة من الحرب، قال في تاج العروس: «حاربه محاربةً وحرابًا، وتحاربوا واحتربوا وحاربوا بمعنى»([22]).
وهذا المعنى في الجهاد وهو الحرابة هو قول جماهير العلماء .
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: «ولا يقتلوا امرأةً ولا صبيًّا ولا شيخًا فانيًا ولا مقعدًا ولا أعمى؛ لأنَّ المبيح للقتل عندنا هو الحراب، ولا يتحقَّق منهم»([23]).
وقال الكاسانيُّ في البدائع: «لا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي، ولا شيخ فانٍ، ولا مقعد ولا يابس الشِّق، ولا أعمى، ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى، ولا معتوه، ولا راهب في صومعة، ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس، وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب، أمَّا المرأة والصبي فلقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم «لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا»([24]) وروي أنه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة، فأنكر ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: «هاه ما أراها قاتلت، فلم قتلت؟ ونهى عن قتل النساء والصبيان»([25]) ولأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل القتال، فلا يقتلون، ولو قاتل واحد منهم قتل، وكذا لو حرَّض على القتال، أو دلَّ على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعًا، وإن كان امرأة أو صغيرًا؛ لوجود القتال من حيث المعنى.
وقد روي أنَّ ربيعة بن رفيع السلميَّ رضي الله عنه أدرك دريد بن الصِّمَّة يوم حنين، فقتله وهو شيخ كبير كالقفة، لا ينفع إلا برأيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه([26])»([27]).
وقال ابن قدامة في المغني: «ولا تقتل امرأة ولا شيخ فانٍ، وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن أبي بكر الصدِّيق، ومجاهد، وروي عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾ [البقرة: 190]. يقول: لا تقتلوا النِّساء والصِّبيان والشَّيخ الكبير»([28]).
وقال الدَّردير في الشَّرح الكبير: «المرأة فلا تقتل إلا في مقاتلتها، فيجوز قتلها إن قتلت أحدًا، أو قاتلت بسلاح كالرِّجال ولو بعد أسرها، لا إن قاتلت بكرميِّ حجر فلا تقتل ولو حال القتال، وإلَّا الصبي المطيق للقتال فلا يجوز قتله، ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل.
وإلَّا المعتوه أي ضعيف العقل فالمجنون أولى كشيخ فانٍ لا قدرة له على القتال، وزمن -بكسر الميم- أي عاجز، وأعمى عطف خاص على عام، وراهب منعزل عن أهل دينه بدير أو صومعة؛ لأنَّهم صاروا كالنِّساء حال كونهم بلا رأي وتدبير، وإذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفَّار الكفاية فقط؛ أي ما يكفيهم حياتهم على العادة، وقدم مالهم على مال غيرهم، ويؤخذ ما يزيد على الكفاية، فإن لم يكن لهم ولا للكفَّار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن»([29]).
– الأدلة على أن الحرابة والاعتداء هي مناط تشريع القتال وليس مجرَّد الكفر:
واستدلالات الجمهور في ذلك كثيرة، قال الشَّيخ عبد الوَّهَّاب خلَّاف: «واحتجُّوا على هذا ببراهين:
أوَّلًا: أنَّ آيات القتال في القرآن الكريم جاءت في كثير من السُّور المكِّية والمدنيَّة مبيِّنة السبب الذي من أجله أذن في القتال، وهو يرجع إلى الكفَّار على عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المشركين أم من أهل الكتاب، أمعنوا في إيذاء المسلمين بألوان العذاب فتنة لهم وابتلاء حتَّى يرجعوا من أسلم عن دينه، ويثبطوا من عزيمة من يريد الدُّخول في الإسلام، وغايتهم من هذه الفتن والمحن أن يخمدوا الدعوة، ويسدُّوا الطَّريق في وجه الدُّعاة، فالله سبحانه أوجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء المعتدين دفعًا لاعتدائهم، وإزالةً لعقباتهم حتَّى لا تكون فتنة ولا محنة، ولا يحول حائل بين المدعوِّين وإجابة الدَّعوة، وإذ ذاك يكون الدِّين كلُّه لله»([30]).
قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: 191- 193].
قال الطَّبريُّ: «عن يحيى بن يحيى الغسَّاني قال: كتبتُ إلى عمر بن عبد العزيز أسألهُ عن قوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ قال: فكتب إليَّ: إنَّ ذلك في النِّساء والذريَّة ومن لم يَنصِبْ لك الحرَب منهم»([31]).
وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 75].
وقوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ [الأنفال: 39].
وقوله تعالى: ﴿أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوۡمٗا نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ وَهَمُّواْ بِإِخۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍۚ أَتَخۡشَوۡنَهُمۡۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَوۡهُ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ [التوبة: 13].
وقوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39، 40].
وقوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8، 9].
قال الدُّكتور البوطيُّ رحمه الله: «فهذه الآيات صريحة الدَّلالة على أنَّ علَّة الجهاد القتاليَّ للكافرين هي الحرابة، وقد تفرَّق نزولها في آمادٍ مختلفة من العهد المدنيِّ، وفيها ما قد نزل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهرٍ، ومن ثمَّ فيه الحجَّة لمذهب الجمهور»([32]).
– الأدلة من السنة على أن الكفر وحده ليس مبيحًا للقتال:
عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها النَّاس، فأفرجوا له، فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل، ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله يأمرك بقول: لا تقتلنَّ ذريَّة ولا عسيفًا»([33]).
وقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «انطلقوا باسم الله، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةً ولا تغلوا، وضمُّوا غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا إنَّ الله يحبُّ المحسنين»([34]).
وفعل أبي بكر وما أوصى به أسامة وأصحابه غداة توديعه له وتسييره لجيشه، وقد كان ذلك أول عملٍ قام به أبو بكرٍ، فقد جاء في وصيَّته: «لا تخونوا ولا تغدروا، لا تغلوا ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا طفلًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة… وإذا مررتم بقومٍ قد فرَّغوا أنفسهم في الصَّوامع فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له»([35]).
فالَّذي استدل به الجمهور من هذه الأحاديث هو النَّهي عن قتال غير المقاتلة – أي بالقوَّة- ولهذا لما مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقتلى ووجد امرأة مقتولة قال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل»([36])، فكان إنكارًا من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لقتل مثل هذه المرأة التي لا يتأتى منها نوع قتال أو اعتداء.
قال الشَّيخ عبد الوهَّاب خلَّاف: «احتجُّوا باتِّفاق جمهور المسلمين على أنَّه لا يحل قتل النِّساء والصِّبيان والرُّهبان والشَّيخ الكبير والأعمى والزَّمِن ونحوهم لأنَّهم ليسوا من المقاتلة، ولو أنَّ القتال كان للحمل على إجابة الدَّعوة وطريقًا من طرقها حتى لا يوجد مخالف في الدِّين ما ساغ استثناء هؤلاء، فاستثناؤهم برهان على أنَّ القتال إنَّما هو لمن يقاتل دفعًا لعدوانه. ولو قيل: إنَّهم استثنوا لأنَّهم لغيرهم تبع، فهذا إن سلِّم في الصِّبيان والنِّساء لا يسلَّم في البواقي، وخاصَّة في الرُّهبان.
وثالثًا: وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدَّعوة إلى الدِّين؛ لأنَّ الدِّين أساسه الإيمان القلبيُّ والاعتقاد، وهذا أساسٌ تكونه الحجَّة لا السَّيف، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ﴾ [يونس: 99]. فهذا المعنى هو مبنى أمر الجهاد، دفع اعتداء الغير عن ديار الإسلام»([37]).
ثم قال رحمه الله: «والنظر الصحيح يؤيد أنصار السِّلم القائلين بأنَّ الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال إلا إذا أُريدوا بسوء لفتنتهم عن دينهم، أو صدِّهم عن دعوتهم، فحينئذ يُفرَض عليهم الجهاد دفعًا للشر، وحمايةً للدَّعوة، وهذا بيِّنٌ في قوله تعالى في سورة الممتحنة المدنيَّة: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8، 9]، وقوله تعالى في سورة النِّساء المدنيَّة: ﴿فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا﴾ [النساء: 90]، وقوله في سورة الأنفال المدنيَّة: ﴿۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: 61]. وفي كثير من آي الكتاب وأصول الدِّين ما يعزز هذه الرُّوح السلميَّة، ويبعُد أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدَّائمة، وأن يكون فرَض الجهاد وشرع القتال على أنه طريقُ الدعوة إلى الدِّين؛ لأنَّ الله نفى أن يكون إكراه على الدِّين، وأنكر أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكيف يتكون الإيمان بالإكراه ويصل السَّيف إلى القلوب.
إن طريق الدَّعوة إلى التَّوحيد والإخلاص لله وحده هي الحجَّة لا السَّيف، ولو أنَّ غير المسلمين كفُّوا عن فتنتهم، وتركوهم أحرارًا في دعوتهم، ما شهر المسلمون سيفًا، ولا أقاموا حربًا.
وما احتج به بعضهم على خلاف ذلك من أن التي جاءت مطلقة ليس برهانًا قاطعًا على ما يقولون لأنَّه لم يوفق بين هذه الآيات المطلقة والآيات المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن الله سبحانه أذن في القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة، وتارة ذكره مقرونًا بسببه، وتارة ذكره مطلقًا اكتفاءً بعلم السبب في آيات أخرى. ولو كان بين الآيات تعارض كانت المتأخرة ناسخة للمتقدمة، فلم يذكر السبب الذي من أجله أذن في القتال آخرًا كما ذكر السبب في الإذن به أوَّلًا، وكيف تكون الآيات المقيدة منسوخة مع أن وجوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحد؟! فلا موجب لتقرير تعارض الآيات والقول بنسخ المطلق للمقيد؛ لأنَّ هذا تمزيقٌ للآيات، ويترتب عليه نسخُ كثيرٍ منها، حتى قال بعض المفسرين: إنَّ المنسوخ بآية السيف نحو مائة وعشرين آية، ومن هذه الآيات كل ما يدلُّ على أخذٍ بالعفو، أو دعوةٍ بالحكمة، أو جدالٍ بالحسنى، أو نفيٍ للإكراه على الدِّين»([38]).
قال ابن تيمية: «وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدِّين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة: كالنِّساء، والصِّبيان، والرَّاهب، والشَّيخ الكبير، والأعمى، والزَّمِن، ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلَّا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلَّا النِّساء والصِّبيان لكونهم مالًا للمسلمين، والأول هو الصَّواب؛ لأنَّ القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: «أنه مرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه، قد وقف عليها الناس. فقال: ما كانت هذه لتقاتل»([39])، وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريَّة ولا عسيفًا»([40]). وفيها أيضًا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة»؛ وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ﴾ [البقرة: 191]؛ أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفَّار من الشَّر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلَّا على نفسه»([41]).
وهذا المعنى هو المتَّفِق والملائم لما صدَّرنا به هذا المبحث من إتيان أمور المعاملات -والَّتي منها الجهاد- مراعية لمقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة.
ثمَّ إنَّ العلماء يزيدون هذا المعنى إيضاحًا في بيان كيفية حصول فرض الجهاد:
قال ابن عابدين: «ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية لقتال العدو، فإن قاموا به سقط عن الباقين، وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة، وخيف عليهم من العدوِّ، فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم، وأن يمدوهم بالسِّلاح والكراع والمال لما ذكرنا أنَّه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد، ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض، فما لم يحصل لا يسقط اهـ.
قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه، وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدوِّ»([42]).
وهذا المعنى الذي ذهب إليه الجمهور نراه عين ما قال به متأخرو الشافعيَّة.
قال ابن حجر في التحفة: «وأما بعده فللكفار الحربيين (حالان: أحدهما يكونون) أي كونهم (ببلادهم) مستقرين فيها غير قاصدين شيئًا (فـ) الجهاد حينئذ (فرض كفاية) إجماعًا، كما نقله القاضي عبد الوهَّاب، ويحصل إمَّا بتشحين الثغور، وهي محالُّ الخوف الَّتي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنُّصح للمسلمين، وإمَّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم.
وظاهر أنَّه إن أمكن بعثها في جميع نواحي بلادهم وجب، وأقله مرة في كل سنة، فإذا زاد فهو أفضل، هذا ما صرَّح به كثيرون، ولا ينافيه كلام غيرهم؛ لأنَّه محمول عليه وصريحه الاكتفاء بالأول وحده، ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام، وهو باطل إجماعًا، ويرد بأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم، وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا، ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثر من مرة وجب، فكذا إذا اكتفينا هنا بتحصين الثغور واحتيج لقتالهم وجب»([43]).
وقال الرَّملي في النهاية: «ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنُّصح للمسلمين، وإمَّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم؛ لأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا». قال عليٌّ الشبراملسي في حاشيته عليه: «ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين: إمَّا إشحان الثغور، وإمَّا دخول الإمام أو نائبه. قال محمد الرَّملي: وهو المذهب»([44]).
وقال القليوبيُّ في حاشيته على المحلي: «ويغني عن ذلك أن يشحن الإمام الثغور بمكافئين مع إحكام الحصون، أي الثغور وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفار بالجيوش لقتالهم، فأحد هذين الأمرين كافٍ عن الفعل المتقدم على المعتمد»([45]). وقد اقتصر البيجوريُّ على ذلك في حاشيته على ابن قاسم([46]).
فهذا المعنى متفقٌ عليه بين الجميع، وهو أن الجهاد ليس مشروعًا لذاته، فلم يأتِ الإسلام لتلك الشَّهوة من القتل وسفك الدماء كما يبيِّن الخوارج دائمًا هذا المعنى، كلا؛ فالجهاد مشروع لغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، ومن ثمَّ كان الفرض فيه في حالة عدم وجود قتال بين الأعداء تحصين الثُّغور والذود عن البلاد، فإذا حصل الاعتداء فرد الاعتداء واجب.
وقد كانت علاقات الأمم في الماضي في غاية التَّعقد، ولم يكن ثمَّة ما يمكن أن يكون وسيلة للتواصل فيما بينها، وكان اجتماعها على الرأي صعب المنال.
يقول عبد الوهَّاب خلَّاف: «الأمم قديمًا كانت حالها لا تساعد على وجود صلات بين إحداها والأخرى؛ لأنَّ القوية كانت تطمع في استبعاد الضَّعيفة، والضَّعيفة كانت في خوف من تغلُّب القويَّة، وما كانت إذ ذاك ضمانات تقف بالمطامع أو تنفي المخاوف، فلهذا كانت كل أمة في عزلة عن الأخرى، وما كانت لواحدة منها سياسة خارجية إلا تدبير الحروب والإغارات»([47]).
ولما كانت رسالة الإسلام دفع الضرر عن الخلق «لا ضرر ولا ضرار»([48])، أو بعبارة الفقهاء: «الضرر يزال»([49]) جاء الجهاد في الإسلام مقررًا لهذا المعنى؛ دفع الضَّرر عن هذه المقاصد الشرعية.
يقول الشَّيخ محمَّد أبو زهرة: «النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قاتل لأمرين:
الأمر الأوَّل: دفع الاعتداء، وقد وقع الاعتداء على الأنفس والأموال بالفعل، وما كان -وهو الذي يدعو إلى الحقِّ الذي لا ريب فيه- أن يترك الباطل يستغلظ ويقوى، ويستخذي هو ويستسلم، فلا بد أن يضرب الباطل فيصيب من الشَّر دماغه، وهو الحكام المستبدون الظالمون، وإنَّ فضائل الإسلام إيجابية تقاوم، وليست سلبية تستسلم، ولذلك كان القتال وكان ماضيًا إلى يوم القيامة ما بقي الشَّر ينازع الخير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة»([50])؛ لأنَّ نزاع الخير والشَّر ماضٍ إلى يوم القيامة.
الأمر الثَّاني: تأمين الدَّعوة الإسلاميَّة لأنَّها دعوة الحقِّ، وكلُّ مبدأ سامٍ يتجه إلى الدِّفاع عن الحرِّية الشَّخصيَّة، يهمُّ الدَّاعي إليه أن تخلو له وجوه النَّاس، وأن يكون كل امرئ حرًّا فيما يعتقد، يختار من المذاهب ما يراه بحريةٍ كاملةٍ، ويختار ما يراه أصلح وأقرب إلى عقله»([51]).
والوضع الحالي للأمم ليس كحاله في الماضي، فالأمم حديثًا -كما يقولون- كالقرية الواحدة، تؤثر كل واحدة في الأخرى، وتحتاج كل واحدة للأخرى، وهذا دفعها إلى وضع تلك القوانين الَّتي تتعهد كلُّ دولة بتحقيقها بغضِّ النَّظر عن ماهيَّة هذه الدَّولة، هذه القوانين الَّتي تراعي أن يحافظ على حرية الشَّخص وعدم المساس بها، وبالتالي يتحقق ما هو مقرر في الشَّريعة الإسلاميَّة وهو حفظ الدِّين الَّذي شرع الجهاد في الأساس لأجل حفظه مع النَّسل وغير ذلك.
يقول عبد الوهَّاب خلَّاف: «ولهذا وضع علم القانون الدولي لتقرير القواعد الَّتي تستبين بها حقوق كلِّ دولةٍ وواجباتها قِبَل غيرها من الدُّول في حالي السِّلم والحرب. وأول ما قرره العلماء من قواعده أن تكون علاقات الدُّول أساسها السِّلم حتَّى يتيسَّر لها تبادل المنافع والتعاون على بلوغ النَّوع الإنساني درجة كماله، وقرروا أنَّه لا يسوغ قطع هذه الصلة السِّلمية إلا عند الضَّرورة القصوى الَّتي تُلجئ إلى الحرب، وبعد أن تفشل جميع الوسائل السِّلمية في حسم الخلاف. وسنُّوا لحال السِّلم أحكامًا تكفل لكل دولة حقوقها وواجباتها قبل غيرها حتَّى تقطع أسباب الخلاف بالقدر الممكن، وسنُّوا لحال الحرب -إذا اضطر الخلاف إلى وقوعها- أحكامًا تخفِّف ويلاتها، وتهوِّن من شرورها بالقدر الممكن كذلك»([52]).
إنَّ هذه المعاني الَّتي هي مقرَّرة في تلك القوانين في تعامل الأمم مع بعضها مع بعض كما هو معلوم مطالب من المسلمين تحقُّقها، ونشرها للعالمين، فهي عين ما شرعت التشريعات لأجله، ومنها الجهاد، ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
وهذا المعنى يقررُه الخطيب الشربينيُّ من الشافعيَّة قائلًا: «وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد، إذًا المقصود بالقتال إنَّما هو الهداية وما سواها من الشهادة، وأمَّا قتل الكفَّار فليس بمقصودٍ حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدَّليل بغير جهادٍ كان أولى من الجهاد»([53]).
سبق أن بيَّنَّا دور الإمام وما جعله الإسلام له من سلطة في تقييد المباحات من أمور المعاملات فيما تقتضيه المصلحة العامَّة.
والجهاد يترتب عليه من الأمور ما بيَّنَّاه من تحقيق غاية الإسلام في حفظ المقاصد الشَّرعيَّة، ولذا جعل أمر الجهاد مرجعه للإمام ابتداءً وانتهاءً، بل وما يتعلق به.
قال في المغني: «وأمر الجهاد موكولٌ إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرَّعيَّة طاعته فيما يراه من ذلك». وقال السرخسي في المبسوط: «على إمام المسلمين في كلِّ وقتٍ أن يبذل مجهوده في الخروج بنفسه أو يبعث الجيوش والسَّرايا من المسلمين ثمَّ يثق بجميل وعد الله تعالى بنصرته»، وفي الشَّرح الكبير للدَّردير: «ونقل عن ابن عبد البر أنَّه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع الأمن»([54]).
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: «قال اللخميُّ عن الداوديِّ: بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه»([55]) وفيه: «إن نهَى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلَّا أن يدهمهم العدوُّ»([56]).
«والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهمِّ جهة إذا كان العدوُّ في جهات، وكان ضرره في بعضها أكثر من ضرره في غيرها، فإن أرسل الإمام لغير الأهمِّ أثم كما صرَّح به اللقانيُّ، فإن استوت الجهات في الضَّرر خيِّر الإمام في الجهة الَّتي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات، وإلَّا وجب في الجميع، وإن كان في جهة واحدة يعيَّن القتال فيها»([57]).
قال الدكتور البوطي رحمه الله: «يعد الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة، بل لا أعلم أيَّ خلافٍ في أنَّ سياسة الجهاد إعلانًا وتسييرًا وإنهاءً ونظرًا لذيوله وآثاره، كل ذلك داخل في أحكام الإمامة، وأنَّه لا يجوز لأي من أفراد المسلمين أن يستقل دون إذن الإمام ومشورته في إبرام شيء من هذه الأمور».
وهذا الأمر بالطبع إذا لم يكن الجهاد العينيُّ بدخول العدو ديار الإسلام، قال رحمه الله: «إذن فنحن لا نتحدَّث الآن عن حالة النَّفير العام الَّتي تدخل في باب الصيال، وإن كان عموم معنى الجهاد يشملها وتنطبق عليها سائر أحكامه، وإنَّما نتحدث عن الجهاد القتالي عندما يكون فرض كفاية على مجموع المسلمين لا على جميعهم أي كلِّ فرد منهم».
بعد أن ذكرنا مقاصد الجهاد في الإسلام، وهي مقاصدُ يفخر بها المسلم، فلقائل أن يقول: أنتم أيها المسلمون تتحدثون عن مقاصد الجهاد، وأنَّ الجهاد أساسه نشر العدل والسِّلم في العالم، وكتب الفقه لديكم مليئة بكل ما يعارض هذا، ويسرد لنا فروعًا فقهية وتفصيلات اجتهادية يأتي بها من كتب الفقه القديمة ليؤكد أن الجهاد في الإسلام قائم على التَّوحش والغدر والبطش، ونحن لا ننكر أنَّ مثل هذه الاجتهادات مسطورة في كتب التُّراث، وهي في تفصيلاتها تحتاج لمناقشةٍ بشكلٍ إجماليٍّ، حتَّى نتفهَّم سبب وجود هذه الاجتهادات، وبالتالي نعلم أنَّ ما هو موجود في هذه الكتب لا إشكال فيه عند النظر إليه في سياقه التَّاريخي، مع رفضنا لبعض الاجتهادات الَّتي لا دليل عليها، أو تلك القائمة على دليلٍ ضعيفٍ لا حجَّة فيه.
وبدايةً لهذه المناقشة نقول: إن هذه التَّفصيلات الفقهيَّة تتسم بصفات معيَّنة، وهي:
أوَّلًا: أنَّها تنتمي إلى ما يسمَّى بالفقه المتغيِّر.
ثانيًا: هي تابعة في معظمها للأعراف الدولية السائدة في زمن صدورها.
ثالثًا: اندراجها تحت باب الوسائل في الفقه الإسلاميِّ.
رابعًا: مبنيَّة على المصلحة الَّتي قد تتغيَّر من حين لآخر.
خامسًا: بعضها قائمٌ على معانٍ فضفاضةٍ غير محددةٍ بحدودٍ من مثل النِّكاية في العدوِّ وإغاظته، وغيرها من المعاني الَّتي لا ضابط لها.
ومناقشة هذه التَّفاصيل الفقهيَّة سيتم ضمن الحديث عن هذه السمات بشكلٍ موسَّع حتَّى تتضح لنا الرُّؤية وتزول الإشكاليَّة:
– السِّمة الأولى: اندراج الاجتهادات في باب الجهاد تحت باب الفقه المتغيِّر:
إنَّ التفصيلات الفقهية في أحكام الجهاد ليست من باب الثَّوابت التي لا يجوز خرقها أو تغييرها، فمن المعلوم أنَّ أحكام الشَّريعة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أحكامٌ ثابتةٌ لا تتغيَّر مهما تغيَّرت الظُّروف من مثل أحكام العبادات والزواج والطَّلاق والميراث، فهذه الأحكام لا يطرأ عليها التغيير لأنها ثبتت بنصوص قطعيَّة الثُّبوت قطعيَّة الدَّلالة، فلا سبيلَ إلى التبديل فيها.
القسم الثاني: أحكام قابلة للتغيير لأنَّها ثبتت بناء على اجتهاد من نصوص ظنيَّة الدَّلالة أو قياس وغير ذلك، وهذه الأحكام تتدخل فيها عواملُ تجعلها تتغيَّر كالمصلحة واختلاف الزَّمان والمكان، ويمثل لهذا القسم أحكام الإمامة والسِّياسة الشَّرعية، والنَّوازل التي لا نص فيها.
وسبب انقسام الأحكام هو انقسامُ الأدلَّة الشَّرعية إلى ظنيٍّ وقطعيٍّ؛ يقول الشَّاطبيُّ في الموافقات: «كلُّ دليل شرعيٍّ إمَّا أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا، فإن كان قطعيًّا فلا إشكالَ في اعتباره كأدلَّة وجوب الطَّهارة من الحدث، والصَّلاة، والزَّكاة، والصِّيام، والحجِّ، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، واجتماع الكلمة، والعدل، وأشباه ذلك، وإن كان ظنيًّا فإمَّا أن يرجع إلى أصلٍ قطعيٍّ أو لا، فإن رجع إلى قطعيٍّ فهو معتبر أيضًا، وإن لم يرجع وجب التَّثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله»([58]).
يفهم من هذا النَّقل أنَّه بناء على اختلاف ثبوت الأحكام ودلالتها تختلف صفة الأحكام ما بين ثابت غير قابل للتَّبديل، وضرب الشَّاطبي مثالًا عليه كأحكام الصَّلاة والزَّكاة والصِّيام، ومنها ما هو جائزٌ فيه التَّغيير وهو ما يسمى بالفقه المتغيِّر.
والأحكام الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنها والمبثوثة في أبواب الجهاد من كتب الفقه هي من أحكام الإمامة والسِّياسة الشَّرعيَّة التي ترجع فيها الأمور إلى نظر الحاكم وما يرى فيه من الأوفق والمناسب للمسلمين، ومثل هذه الأحكام هي من قبيل القسم الثَّاني فهي قابلة للتَّغيير؛ لأنَّها لم تقم على نصوص قطعيَّة الدلالة والثبوت، فمن المعلوم أن الاجتهاد لا يجوز فيما ورد فيه نصٌّ قطعي الثبوت، قطعي الدَّلالة.
وإذا علمنا هذا كان من الممكن البحث في هذه الاجتهادات بما يحلُّ الإشكال التي فيها طالما أنَّها قابلة للتَّغيير غير ثابتة.
السِّمة الثَّانية: أنَّ هذه التَّفصيلات الفقهيَّة متوافقة مع ما كان سائدًا من الأعراف الدوليَّة:
وهي التفصيلات الفقهية التي اجتهد الفقهاء المسلمون على أساسها بما يناسب ذلك الواقع، مما يعني أن تلك الاجتهادات كانت سائغةً في وقتها، وبما أنَّ العرف الدوليَّ قد تغير اليوم حيث صار هناك اتفاقيات دولية تنظم حالة الحرب والسِّلم مع مواثيقِ مجلس الأمن لحقوق الإنسان وغير ذلك من المظاهرِ المشيرة إلى تغيُّر الأعراف الدوليَّة في مسائل القتال، وجب احترام القوانين الدولية المنظمة لذلك الأمر، ولا يجوز التمسُّك باجتهادات وتفاصيل تجاوزها الواقع ولم يعد من المناسب ولا المحقق لمقاصد الشريعة التشبُّث بها؛ لأنَّ الزَّمان قد تغيَّر، وبالتَّالي تغيَّرت معه الأعراف.
ومن المعلوم أنَّ العرف يعتبر من الأدلَّة التي تبنى عليها الأحكام، ويترك به القياس، وتخصص به النُّصوص عند جمهور الفقهاء، فينتج عن ذلك تغيُّر الأحكام الاجتهادية التي بُنيت عليه في حال تغيره، يقول الإمام القرافيُّ في الفرق بين قاعدة العرف القولي والعرف العملي عند الكلام على اعتبار العرف وتغيره: «فمهما تجدَّد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمُدْ على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجْرِه عليه وأفْتِهِ به دون عُرف بلدك والمقرَّرِ في كتبك، فهذا هو الحقُّ الواضحُ، والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدِّين، وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسَّلف الماضين»([59]).
والعرف في نظر الشَّريعة الإسلاميَّة له سلطان واسع المدى في توليد الأحكام وتجديدها وتعديلها وتحديدها وإطلاقها وتقييدها؛ لأنَّ العرف وليد الحاجة المتجددة والمتطورة، وقد قام العرف بدورٍ هام في تفسير ألفاظ الأحكام وإنشاء أحكام جديدة وتعديل أحكام قائمة، وأحكام الجهاد من الأحكام التي تتأثر بتغير العرف، وبالتالي يجوز تعديلها بما لا يخالف أصلًا من أصول الدِّين وقطعياته.
ومن المقرَّر في فقه الشَّريعة أن لتغيُّر الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرًا كبيرًا في كثير من الأحكام الاجتهادية التي تنظم ما أوجبه الشَّرع، وأحكام الجهاد هي في جوهرها تنظيم لما أوجبه الله من فريضة الجهاد، وبالتالي إذا عرض ما يفرض تغيير هذا التنظيم فذلك سائغ لا إشكال فيه، وخاصة أن كثيرًا من الأحكام الاجتهادية كانت تدبيرًا وعلاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معيَّن، فأصبحت بعد جيل أو أجيال لا تُوصل إلى المقصود أو أصبحت تفضي إلى عكسه لتغير الأوضاع، ومن هنا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتَّى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم، وصرَّح هؤلاء المتأخرون بأنَّ سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزَّمان.
وكتب الفقهاء طافحة بنصوص تعتبر العرف وتعده مصدرًا من مصادر الشَّريعة، وتقوم بمسايرته في أحكام اليمين والنذر، فمن باب أولى أن نعتبره في أحكام القتال والجهاد، فلماذا لا يكون لتغيُّر العرف أثرٌ في تغيُّر هذه الأحكام؟ وخاصَّة أنَّ العلماء لم يوجبوا في اجتهاداتهم الفقهية كيفيَّة معينة في القتال مع العدوِّ، بل ذكروا أحكامًا لأعمال حربية كانت منتشرة في ذلك الوقت ضمن إطار الفقه العام، والشَّريعة الإسلاميَّة صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان؛ لما فيها من قواعدَ مرنةٍ تكفل لها التجدُّد في كلِّ عصر بما يتوافق مع حال العصر وأعرافه.
وعلينا أن نلفت النظر هنا إلى أنَّ الأعراف الدوليَّة إذا صادم منها ما هو قطعي الدَّلالة والثُّبوت في ديننا فلا يؤخذ به ولا يراعى أبدًا، أمَّا إذا كان العرف الدولي مما يسير في فضاء الأحكام الاجتهادية القابلة للتغير فلا ضير على المسلمين أن يلتزموا به، ويستنبطوا اجتهادات تساير هذه الأعراف التي هم جزء من تكوينها، وقد قبلوا بها من قبلُ طالما لم تعارض دليلًا أو أصلًا من أدلة وأصول الشَّريعة الإسلاميَّة.
– السِّمة الثَّالثة: اندراج أحكام الجهاد تحت باب الوسائل في الفقه الإسلامي وليست من المقاصد في شيء.
الأحكام الفقهية في أبواب الجهاد هي للوسائل القتالية التي تتم خلال الحرب مع الأعداء، وهذه الوسائل هي وسيلة للجهاد الذي هو وسيلة لتحقيق مقاصد أشرنا إليها في الحديث عن مقاصدِ الجهاد في الإسلام؛ يقول العزُّ بن عبد السَّلام: «وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الَّذي هو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل»([60]).
إذا علمنا هذا فعلينا أن نعلم أنَّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وأنَّ فضل الوسيلة مترتب على فضل المقصد جاء في كتاب القواعد الصُّغرى للإمام العزِّ: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائلُ، وللوسائل أحكامُ المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة… واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد، والأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف، والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر»([61]).
إذًا حكم الوسائل هو حكم المقاصد، فالأحكام التي وضعت في أبواب الجهاد لوسائل القتال أثناء جهاد المسلمين لها حكم مقاصد الجهاد، وبما أن الوسائل متغيِّرة والمقاصد ثابتة فقد تتغيَّر الظُّروف والأحوال وتصبح وسائل الأمس غيرَ مناسبةٍ لواقع اليوم، نقول هذا ونحن نعلم تأكيد العلماء أنَّ الوسيلة لم تكن يومًا مقصودة لذاتها؛ يقول الإمام الشَّاطبيُّ: «وقد تقرَّر أنَّ الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودةٍ لأنفسها، وإنَّما هي تبعٌ للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث»([62]).
ويقول في موضعٍ آخر: «فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء القصد إلَّا أن يدل دليلٌ على الحكم ببقائها، فتكون إذ ذاك مقصودةً لنفسها»([63]).
يؤكِّد الإمام القرافيُّ القاعدة هذه بقوله: «القاعدة أنَّه كلَّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنَّها تبعٌ له في الحكم»([64]).
إذًا الوسائل ليست مقصودةً لذاتها؛ بدليل أنَّ انتفاء المقصد كافٍ في انتفاء الوسيلة وعدم الالتفات إليها، وبما أن الوسائل غير ثابتة والمقاصد هي الثَّابتة فلا نجد أنفسنا ملزمين باتباع الأحكام الفقهية لوسائل الجهاد القديمة الَّتي كان لها ظروفها وأحوالها إذا كان ثمة وسائلُ أخرى تفي بالمقصود، وخاصَّة أنَّنا علمنا أن أحكام الجهاد هي من قبيل الأحكام القابلة للتغيير.
وبما أنَّ الحديث عن الوسائل فلنعلم أنَّ أيَّ وسيلة تؤدِّي إلى مقصدٍ مشروع ينبغي أن لا يترتب عليها مفسدة، فإذا صادفتنا وسيلة من الوسائل أثناء الجهاد يترتب عليها ضرر أو فيها مفسدة تكرُّ على مقاصدِ الجهاد بالبطلان، فالوسيلة عندئذ تُلغى ولا يُلتفت إليها.
فالعبرة في الوسيلة أن تُحقِّق مصلحةً راجحة؛ لأنَّها كما ذكرنا ليست مقصودةً بعينها، ولذلك وجدنا الفقهاء يجيزون دفع المال إلى الأعداء من أجل فكِّ الأسرى المسلمين، أو دفع المال لهم اتقاء شرِّهم، مع أنَّ هذا الفعل إذا نظر إليه بعينه دون النَّظر إلى مسألة المقاصد والوسائل لكان محرمًا، لكن لما كانت هذه الوسيلة تجلب مصلحة راجحة أخذنا بها، يقول الإمام القرافيُّ: «قد تكون وسيلة المحرم غير محرمةٍ إذا أفضت إلى مصلحةٍ راجحة كالتَّوسُّل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفَّار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشَّريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى، ولكنَّه اشترط فيه أن يكون يسيرًا، فهذه الصُّور كلُّها الدَّفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به؛ لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة»([65]).
وعلى كلٍّ فالوسيلة إذا لم تُفْضِ للمقصد الَّذي وضعت من أجله سقط اعتبارها([66])، وهذا يطبق على أحكام الوسائل القديمة في الجهاد، فإنَّها إذا لم تؤدِّ إلى مقاصد الجهاد في واقعنا الذي نعيش فيه من نشر السِّلم والعدل فلا اعتبار لها، فنحن لسنا متعبدين بها.
– السِّمة الرَّابعة: الاجتهادات الفقهيَّة في أبواب الجهاد مبنيَّة على المصلحة.
أحكام الجهاد التي نجدها مبثوثة في كتب الفقه هي في معظمها تلحظ المصلحة، فالفقهاء عند استنباط أحكام القتال كانت مصلحة الإسلام والمسلمين منطلقهم، وهذا كلام لا غبار عليه، وهو ملاحظ عند كل من اطَّلع على نصوصهم الفقهيَّة، والنَّاظر اليوم إلى أحوال المسلمين يجد أنَّ المصلحة التي كانت بالأمس منطلقًا لأحكام الفقهاء ليست هي نفسها الآن، فالإسلام في ضعفٍ والمسلمون في استضعافٍ وتأخُّر يدمي القلب، وبالتالي فالمصلحة قد تغيرت وتبدلت، والأحكام تتغير تبعًا لتغير المصلحة، ويمكن لنا أن ننتقل من حكمٍ كان معمولًا به إلى حكمٍ آخر لمصلحةٍ طرأت علينا فرضتها الظُّروف والأحداث التي نعيشها، وعلينا أن نؤكِّد مسألة مهمة في هذا السِّياق؛ وهي أنَّ جمهور الفقهاء يخصون التَّبديل بالأحكام في إطار ما لا نص فيه ولا إجماع صحيح؛ وذلك سدًّا لباب التَّلاعب بالدِّين وتحكيم الهوى والغرض، والقول بالتبديل بصفةٍ عامَّةٍ عند اقتضاء المصلحة ذلك قال به العلماء ممن فهموا روح الشَّريعة ومراميها، ويذكر ابن القيم أنَّ تغييرَ الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد معنًى عظيمُ النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشَّقة ما يُعلم أن الشَّريعة لا يعقل أن تأتي به([67]). وهذا النقل يؤيد ما نقول به من تبديل الأحكام المبنيَّة على المصلحة حتى لا يكون هناك انفصال بين الأحكام الفقهية وبين شؤون الناس ومصالحهم، فإن ذلك الانفصال لا يتفق مع ما عُلم من الدِّين بالضَّرورة من أن الشَّريعة صالحة لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، فكان لا بد من أن تساير الأحكام شؤون النَّاس ومصالحهم ما دام ذلك متفقًا مع روح الشَّريعة ومسايرًا لما يفهمه الأئمة والفقهاء من اتجاهاتها.
إذًا التَّصرُّف في الأحكام إذا اقتضته المصلحة أمرٌ مشروع، كما يدلُّ عليه تصرفات الصَّحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الَّذي طالما غيَّر بعض الأحكام إلى ما يرى أنَّه مصلحة، مع تفسيره للنُّصوص تفسيرًا يتفق مع المصلحة، وهي تصرفات تبيِّن أنَّ تغييرات الأحكام تبعًا للمصلحة في عصر الصحابة كانت كثيرةً، وهو ما درج عليه التابعون، والفقهاء من بعدهم.
ثم إن الحكم المجتهد فيه لا ينبغي أن يكون لزامًا على الناس لا يقبل تحويلًا ولا تبديلًا، فقد روي عن الإمام عليٍّ أنه قال: قلت: يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشَّاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب([68]).
وهذا يدلُّ على أن مراعاة المصلحة أمرٌ له خطره ويسمح بالتصرُّف حتى في أثناء نزول الوحي ما دام الشَّخص في مكان تدعو ظروفه إلى التَّصرف([69]).
وهذا الذي نحن بصدده من أحكام واجتهادات فقهية في أبواب الجهاد إذا وجدنا أن مصلحة المسلمين والإسلام قد تتضرر فلسنا مجبرين على العمل بها، فسلفنا رضي الله عنهم الذين وضعوا هذه الاجتهادات لم يعيشوا وقتنا، وهذا سرُّ عبارة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشَّاهد يرى ما لا يرى الغائب، ونحن الآن شهود على حال المسلمين وما يناسب مصلحتهم، ثمَّ إن الاجتهادات الفقهية في باب الجهاد من قبيل تصرفات الحاكم والسِّياسة الشَّرعية كما علمنا والتي ينظر فيها في المقام الأول إلى المصلحة العامَّة، فإذا تغيَّرت هذه المصلحة تغيَّرت معها الأحكام تبعًا.
– السِّمة الخامسة: إناطة بعض أحكام الجهاد بمعانٍ عامَّة؛ كنكاية العدوِّ وإغاظته:
المطَّلع على أبواب الجهاد في كتب الفقه الإسلامي يجدُ فيها أحكامًا مرتبطة بمعانٍ عامة قابلةٍ للتغير بحسب الزَّمان والمكان، فمثلًا مسألة النكاية في العدوِّ وإغاظته التي ارتبطت فيها أحكام كثيرة هي مسألة اعتبارية تخضع لعواملَ مختلفةٍ تجعل الحكم متغيرًا بتغير تلك العوامل، فما يكون فيه نكاية بالعدو في زمن قد لا يكون مثله في آخر، وما يغيظ العدو في حال قد لا يغيظه في آخر، ثمَّ إن الموضوع قد يختلف باختلاف العدوِّ نفسه وما قدراته وإمكانيَّاته، فما ذكر من أحكام لتحقيق النكاية بالعدو وإغاظته هو في طبيعة الأمر مبنيٌّ على ما كان سائدًا في ذلك الوقت، فقد تطبق نفس الأحكام اليوم ولا تحصل النكاية بالعدوِّ.
ثمَّ إن تطبيق أحكامٍ فقهية في كتب الفقه في هذا العصر تحت بند النكاية بالعدو قد يترتب عليه إضرار بالإسلام والمسلمين؛ كتشويه صورة الإسلام والتنفير منه، وهذا ليس من الفقه في شيء، وخاصَّة أنَّنا نعلم أنَّ تحقيق مقاصد الجهاد هو الأساس وهو الواجب على المسلمين، فليس مقصود المسلمين في الجهاد هو القتال من أجل القتال، وبالتالي فمسألة النكاية والإغاظة بالكفَّار لم تكن أساسيَّة في فقه الجهاد، بل العبرة هو نشر تعاليم الإسلام وقيمه من أجل أن يسود السَّلام والعدل في العالم.
قد يقول قائل: إن هذه المعاني من إذلال العدو والنكاية فيه نحن محتاجون إليها إذا كان العدو قد اغتصب أرضنا فكل ما يمكن أن يلحق الغيظ والذُّلَّ والهوان فيه هو مطلوبٌ ومشروع. قلنا: إنَّ هذا حق كفلته جميع الشَّرائع، ودفع العدوِّ مطلوب بكل الوسائل، ولكن ينبغي أن تكون الأمور منضبطة ومتوافقة مع مصلحة الإسلام والمسلمين دون إلحاق ضررٍ أكبر بهم، فالمسألة تحتاج إلى وعيٍ وفقهٍ كبيرين، ولا يمكن أن نستلَّ من كتب الفقه أحكامًا وضعت في حالةٍ مخصوصة وزمنٍ مخصوصٍ ونطبقها بدعوى أنَّ هذه الأحكام أُنيطت بنكاية الأعداء وإغاظتهم، فأحكام الفقه المرتبطة بمعانٍ متسعة هي أحكام صفتها التَّغيُّر والتَّبدُّل لاتِّساع المعاني المناطة بها، فما جدوى أن نقوم بفعل كان يؤدِّي إلى نكاية العدو في الماضي، ولا أَثَرَ له في الحال إلا جلْب الهلاك والدَّمار على المسلمين.
إذا نحن لسنا ملزمين بتطبيق مثل هذه الأحكام والعمل به، ففقهاؤنا رحمهم الله كانوا محكومين بعصرهم، وهم لم يعيشوا عصرنا، فمن الخطأ أن نعيش عصرهم في زماننا هذا، وقد تركوا لنا قواعدَ عامةً نسير على هداها، وربما لو كان الواحد منهم في زماننا لتراجع عن كثير من الأحكام التي أفتى بها في زمانه بهدف إغاظة الكفَّار، فكما قلنا إنَّ ما يغيظ العدو في الأمس قد لا يفعل فعله الآن.
ثانيًا: إشكاليَّة التغاير بين بعض أحكام الجهاد وبين المواثيق والمعاهدات الدولية:
النَّاظر في كتب الفقه الإسلاميِّ يجد أنَّ بعضًا من أحكام الفقه في باب الجهاد قد تظهر مغايرة لما نصَّت عليه بنود المواثيق والمعاهدات الدوليَّة، فمن المعلوم أنَّ المجتمع الدولي قد قام بعقد اتفاقات دوليَّة في شأن الحرب والسَّلام، ونذكر على سبيل المثال من بين هذه الاتفاقات اتفاق سبتمبر 1949م في خصوص تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في وقت الحرب.
ويتضمَّن الباب الثَّاني من الاتفاق أحكام الحماية العامَّة للسكان المدنيين من عواقب الحرب، وفي هذا الشَّأن أشار الاتفاق إلى أنَّ جميع الأحكام واجبة التطبيق على مجموع سكان الدولة المشتركة في النزاع دون أي تمييز.
ويحظر الاتفاق مِن جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفًا للهجوم، أو شن هجوم عشوائي يصيب السُّكان المدنيين أو المناطق المدنية، وغير ذلك من بنود.
وفي الاتفاق بنود أخرى لسنا بصدد الحديث عنها، ومثل هذا الاتفاق معاهدات واتفاقيات دولية تشير إلى ما يشير إليه.
والإشكالية الآن أنَّنا إذا أردنا أن نطبق جميع الأحكام الفقهية المسطرة في أبواب الجهاد سنجد أنفسنا أمام أحكام مخالفة لما نصت عليه هذه الاتفاقات والمعاهدات، فما العمل عندئذ؟ وما الحل؟
ولنضرب مثالًا يوضح الصُّورة أكثر ويجلِّيها لنا: فالفقهاء في كتبهم ينصون على أنَّه في حال قامت الحرب بين المسلمين والكفَّار المحاربين جاز للمسلمين أن يقتلوا كل من كان مطيقًا للقتال، سواء شارك في القتال أم لم يشارك، وفي هذا الإطار يقول الإمام الكاساني: «والأصل فيه أن كلَّ من كان من أهل القتال يحل قتله، سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطَّاعة والتحريض، وأشباه ذلك على ما ذكرنا، فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس، والذي يجن ويفيق، والأصم والأخرس، وأقطع اليد اليسرى، وأقطع إحدى الرجلين، وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم من أهل القتال»([70]).
والآن وبعد سرد هذا النص ما موقفنا في ظل المواثيق والمعاهدات المهيمنة على العلاقات الدولية؟
بادئ ذي بدء نقول: إنَّ هذه الأحكام كما رأينا تتغايرُ في ظاهرها مع المواثيقِ الدولية في هذا العصر، والتي تحظر على الدول المتنازعة قتْلَ المدنيين حتى وإن كانوا مطيقين للقتال، وتعتبر قتْلَهم من جرائمِ الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي، ولكنها اجتهادات سائغة بحسب ما كان موجودًا في العصور الفائتة، وهي منسجمة مع الأعراف الدولية في حينها، ففي المسألة سالفة الذكر مثلًا التغاير ظاهريٌّ ولا تناقضَ أو تضادَّ بين مراد القانون الدولي وما يبغي إليه النص الفقهي، فاعتبار الفقهاء جواز قتل العدو المطيق للقتال وإن لم يقاتل لأمرين: الأول: طبيعة المقاتل، وثانيًا: الأسلحة المستخدمة حينئذ، فالمقاتل لم يكن من شروطه أن يكون تحت مظلة جيش نظامي مدرَّب، كذلك فالأسلحة البسيطة المستخدمة حينها يستطيع من له الطاقة والقوة القتالية أن يستخدمها في إيذاء الآخر أو قتله، وذلك للتكافؤ بين الأدوات الهجومية والدفاعية البسيطة البدائية كما هو معلوم.
أما في العصر الحديث فالمقاتلُ له طبيعةٌ خاصةٌ، فهو يقاتل تحت راية جيش نظامي، وله رتبة بداية من مرتبة الجندي إلى ما يعلوها من رتب، كذلك له ما يميزه من زيٍّ غالبًا، وله من التدريبات الخاصة سواء على الناحية البدنية أو القتالية أو المهنية في استخدام السلاح المعقد المتطور تكنولوجيًّا مما يحتاج إلى مهارة خاصة في استعماله لا تتوفر للرجل العادي وإن كان مطيقًا للقتال، كذلك للمقاتل من الوسائل الدفاعية الحصينة ما لا يستطيعُ الرجلُ الأعزلُ -وإن كان له من قوة الجسد أو المهارة- أن يقف أمامها وإن تقلَّد من الأسلحة البدائية، فصار الأعزل في حكم المدني وإن كان مطيقًا للقتال.
ظهر بذلك أن الصورة الفقهية لم تتناقض مع ما قرره القانون الدولي، وإنما كانت مغايرةً لتغيُّر العواملِ والظروف لا أكثر، ولو عاش الفقهاء لحين زماننا لقالوا به.
ثمَّ إن هذه المسألة وأشباهها من باب المباح حيث لا يوجد وجوب بقتل كل من أطاق القتال أثناء الحرب، وبالتالي فنحن غير مضطرين إلى العمل بها، وخاصة أن الدول الإسلاميَّة قد وقَّعت على هذه المواثيق، وقبلت الالتزام بها، وبما أنه يجوزُ للحاكم تقييدُ المباح، فلا يعمل بأي حكم ناقض تلك المعاهدات، ثمَّ إن العمل بنقيضها هو نكثٌ للعهود التي أمرنا الله بالوفاء بها فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ [المائدة: 1] وقال: ﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسُۡٔولٗا﴾ [الإسراء: 34].
وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الوفاء بالعهد ووصف فاعله بنقصان الدين فقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»([71])، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه»([72])، وقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ناكث العهد منافقًا خالصًا، فقال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»([73])، وألزم النبي صلى الله عليه وسلم أتْبَاعَه بالشروط التي التزموا بها في عقودهم واتفاقاتهم فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»([74]).
والآيات والأحاديث الَّتي ذكرنا عامَّة تشمل المسلم والكافر، فنقض العهد مع الكافر كنقضه مع المسلم، بل إنَّ نقضه مع الكافر أشدُّ خطرًا؛ لما فيه من تشويهٍ لصورة الإسلام والمسلمين عند الكفَّار ممن سمع بأخلاقيات الإسلام، فلا يجدر أن نُرِيَه عكسها في تصرُّفاتنا.
ويدلُّ على عدم التفريق بين المسلم والكافر في الوفاء بالعهد أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقض العهد مع الكفَّار حتَّى ينقضي أمده، أو ينبذ العهد إلى المعاهدين جهرًا حتى لا يغدر بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء»([75]).
ولا يقال: إن في التزام المسلمين بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية إعراضًا عن أحكام الشَّريعة، فهذه دعوى عريضة لا دليلَ عليها، فكل ما في الأمر أنَّنا وجدنا كلام الفقهاء في هذه الأمور من باب الإباحة لا الوجوب، فهو كلام تنظيمي يسير عليه المجاهد فيحدد تصرفاته بـ”يجوز ولا يجوز”، وإذا كان الأمر كذلك ساغ لنا أن لا نلتزم هذه الأحكام لأنَّها تنظيمية تختلف بحسب الوقائع والأزمان.
وعلى هذا الأساس فالتزامنا بالمعاهدات لا شيء فيه ما دام لا يناقض أصلًا من أصول الدِّين أو قطعيًّا من قطعيَّات الشَّريعة.
وبما ذكرناه يتبين لنا أن هذه الشبهة التي تلوكها ألسن الملحدين بعيدةٌ كلَّ البعد عن حقيقة ما في أذهانهم، وإنما أعانهم عليها كما ذكرنا خوارجُ العصر.
شبهة تحريض السنة النبوية على العنف
ومن أشهر ما يندرج تحت هذه الشبهة ما يلي:
أولًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»([76])، والأحاديث التي تأمر بقتل المرتد تتعارض مع حرية العقيدة التي جاء بها الإسلام.
وهذه القضية تمثل في الفكر الغربي إشكالية كبيرة، فيظنون أن الإسلام يكره الناس حتى يتبعوه، ويغفلون عن دستور المسلمين في قضية حرية الاعتقاد التي يمثلها قوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾ [البقرة: 265].
ويمكن النظر إلى قضية قتل المرتد من زاويتين:
الأولى: هي النصُّ الشرعيُّ النظريُّ الذي يبيح دم المسلم إذا ترك دينه وفارق الجماعة، وهي الأحاديث التي ذكرت في الشبهة.
الثانية: هي التطبيق التشريعي ومنهج التعامل في قضية المرتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضوان الله عليهم.
والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل عبد الله بن أبي، وهو الذي قال كما أخبر القرآن: ﴿لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّ﴾ [المنافقون: 8]، ويقصد بذلك رسول الله وقد وصفه بالذليل، وهذا أمر يخرج المرء من الملَّة، وكذلك الحال لم يقتل ذا الخويصرة التميمي الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم الغنائم ووصفه بالظالم، فقال له: اعدل يا محمد([77])، ولم يقتل من قال له: يزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به([78])، ولم يقتل القائل له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله([79])، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقُّص، وهي ألفاظ يرتدُّ بها قائلها قطعًا؛ لأنها اتِّهام للنبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله.
وقد كان في ترْكِ قتل من ذكرت وغيرهم مصالحُ عظيمة في حياته، وما زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه؛ فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا، وقد أشار إلى هذا بعينه، وقال لعمر رضي الله عنه لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»([80])، ولم يستخدم ما أباحه الله له في الانتقام من المنافقين ومعاقبتهم كما ورد في سورة الأحزاب، قال تعالى: ﴿۞لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلٗا ٦٠ مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا﴾ [الأحزاب:60، 61].
وكذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن أعرابيًّا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما المدينةُ كالكير تنْفِي خبَثَها، وينصع طيبها»([81])، فهو لم يقتله، فلماذا لم يقتل كل أولئك؟!
وأما في عهد الخلفاء، وبالتحديد في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، فقد رُوي أن أنسًا رضي الله عنه عاد من تستر، فقدم على عمر رضي الله عنه فسأله: ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: فأخذت به في حديث آخر ليشغله عنهم، قال: ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا في المعركة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قلت: يا أمير المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا استودعتهم السجن([82]). فلم يَرَ عمر رضي الله عنه قتلهم بدءًا رغم أنهم ارتدوا وقاتلوا المسلمين؛ لكنه رأى استتابتهم، وإلا سجنهم.
كل تلك الوقائع التي كانت في عهد التشريع جعلت فقهاء المسلمين يفهمون أن مسألة قتل المرتد ليست مسألة مرتبطة بحرية العقيدة والفكر، ولا مرتبطة بالاضطهاد، وأن النصوص التي شدَّدت في ذلك لم تَعْنِ الخروج من الإسلام بقدر ما عَنَت الخروج على الإسلام الذي يعدُّ جرمًا ضدَّ النظام العام في الدولة، كما أنه خروجٌ على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة، ويعتبر حينذاك مرادفًا لجريمة الخيانة العظمى التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين.
ويرى الشيخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق رحمه الله أن قتل المرتد ليس حدًّا، فيقول: وقد يتغيَّر وجه النظر في المسألة؛ إذ لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين.
فقتل المرتد لم يكن لمجرد الارتداد، وإنما للإتيان بأمر زائد مما يفرق جماعة المسلمين، حيث يستخدمون الردة ليردوا المسلمين عن دينهم، فهي حرب في الدين، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ [آل عمران: 72].
ويؤيد ذلك أيضًا ما ذكره الشيخ ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمَّن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه. وأمر بقتل القرنيين لما ضموا إلى ردتهم مثل ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السبَّ وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي السرح لما ضم إلى ردته الطعن والافتراء([83]).
ومما سبق يتبين لنا: أن قضية قتل المرتد غير مطبقة في الواقع العملي المعيش، ووجودها في المصادر التشريعية لم يكن عقوبة ضد حرية الفكر والعقيدة، وإنما تخضع للقانون الإداري([84]).
ومن تلك الشبه أيضًا تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»([85]) مع عدم إكراه الدين الإسلامي الناس على الدخول في الإسلام.
والجواب عن ذلك: أن الاسلام نهانا عن القتال من غيرِ سببٍ، ونهانا عن العدوان والطغيان، وشرع لنا الجهاد لصد العدو، وحرَّم علينا الاعتداء، قال تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: 190] فالجهاد إنما كان لدفع الطغيان، ولذلك أمرنا الله إلى الجنوح إلى السلام إن جنح له الطرف الآخر وكف عن قتالنا، قال تعالى: ﴿۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا﴾ [الأنفال: 61].
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في منتهى الرحمة يبني أمته ويعلم أصحابه أحكام الإسلام وتعاليمه، فكان المسلمون منشغلين بتطبيق هذا الدين والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ليس لديهم وقت لقتال الناس ولا لتتبعهم، ولكن المشركين أتوا للقضاء على المسلمين يريدون أن يستأصلوهم، وهذا ما فعله مشركو قريش في غزوة بدر، حيث خرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت المعركة التي لم يتجهز لها المسلمون أصلًا([86])، وكذلك الأمر في غزوة أحد فقد جاءت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم للثأر من هزيمتها في غزوة بدر، وفعلوا الشيء نفسه في غزوة الأحزاب حيث تآمر المشركون وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب لقتال أحد، إنما كان يدافع عن أمته، وعند حصول الاعتداء لا بد من الدفاع عن النفس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس»، وذلك لا علاقة له بالإكراه على الدين، فالقتال في الإسلام لصد العدوان؛ إذ كيف يكره النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الدين والله يأمره أن يخبر المشركين بأن ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]، و﴿فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ﴾ [الكهف: 29]، وينبهه سبحانه أن وظيفة النبي هي البلاغ لا الهداية، فالإيمان بيد الله تعالى فيقول: ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النور: 54]، ويقول سبحانه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [القصص: 56] ويقول عز وجلَّ: ﴿ فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ﴾ [الغاشية: 21، 22]، فكيف يؤمر النبي بإكراه الناس على الدين بعد هذه الآيات.
ثم إن من المعلوم أنَّ النفاق ممنوع في الإسلام قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا﴾ [النساء: 145]، والإكراه على الدين يعني بالضرورة وجود منافقين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام خوفًا من السيف، فإذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار كيف يسهم النبي في وجود هذه الظاهرة بإكراه الخلق على الإسلام؟!
إذن المقصود بالقتال في هذه الآية هو قتال لصد العدوان، والدليل على هذا أن المتأمل في هذا النص النبوي يجد أن التعبير جاء بلفظ «أقاتل» وليس (أقتل)، وشتان بين معنى اللفظتين فالأولى وهي التعبير بـ «أقاتل» كلمة على وزن أفاعل، وهذا الوزن يدلُّ على المشاركة، فالمقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، أي لا بد من شخص يقاتلني وأقاتله حتى يصحَّ التعبير ب «أقاتل»، وعلى هذا فمعنى الحديث: إذا قوتلت فإني أقاتل لصد العدوان عني.
فإذن هناك فرق بين القتال والقتل؛ يقول الإمام الشافعي: وليس القتال من القتل بسبيل، قد يجوز أن يحل قتال المسلم، ولا يحل قتله([87]).
ومما يدلُّ على التفريق بين المعنيين أنَّ تارك الزكاة تؤخذ منه الزكاة قهرًا ولا يقتل، ولكنه إن امتنع عن أداء الزكاة ونصب القتال فإنه يقاتل، ومن هنا قاتل سيدنا أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، فإباحة القتال لا تعني إباحة القتل.
وعلى هذا فإباحة قتال المشركين لا يعني إباحة قتلهم حتى يسلموا، وإلا لم يكن لحرية العقيدة أي معنى، فالمقصود قتال المشركين لصد حرابتهم وليس لكفرهم، ولو كانت العلة هي الكفر لَمَا جاز قبول الجزية من أهل الكتاب، فعُلم من هذا أنَّ أساس القتال هو لرد غائلة العدوان عن المسلمين، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ناحية أخرى يمكن أن نجيب على هذه الشبهة بأن الأمر الوارد في الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل»، ولم يقل: أمرتم أو أمرنا، فالمسألة زمنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للدفاع عن النفس ورفع الطغيان الذي سببه اليهود والمشركين.
وحيث لا يوجد عدوان أو حرابة فلا داعي للقتال، والإسلام إنما انتشر بالدعوة والأخلاق الحسنة، وعن طريق العائلة حيث كان المسلم يتزوَّج من أهل البلد الذي فُتِحَ، فتنشأ عائلة مسلمة يكون فيها الأبناء من المسلمين، وهكذا تأخذ العائلة في الانتشار، ويكثر المسلمون من غير حاجة إلى قتال أو سفك الدماء.
ثالثا: تصرفات بعض المسلمين التي لها علاقة بالعنف سواء في التاريخ أو في العصر الحاضر
فمما يتمسَّك به كثيرٌ من الملحدين في هذه الأيام هو سلوكيات بعض من ينتمون للإسلام، ليقولوا للناس: إن هذه السلوكيات هي علامة على أن الدين الإسلامي غيرُ صحيح، وهذا نتيجة عقلية لا تفكر بشكل سليم ألبتة، ذلك أنَّ النظرَ والتفكُّر في الأمور يجب أن يكون بصورة موضوعية بغض النظر عن العوامل الخارجية، كمن ينتسب إلى الإسلام في حالتنا هذه.
والإسلام نفسه من خلال ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم حذَّرنا من تصرُّفات بعض المسلمين، وما يتخذه الملحدون ورقة يشهرونها في وجوه الشباب لتبغيضهم في الإسلام هو عين ما حذَّر منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو منهج الخوارج، فلنأتِ في هذه السطور لشرح شيء مما يتعلَّق بمنهج الخوارج.
معنى الخوارج في اللُّغة والاصطلاح:
أصلُ التَّسمية: الخوارج من حيث التوصيف التاريخي تطلق على تلك الطائفة التي خرجت على الإمام علي بن أبي طالب بعد واقعة صفين عندما وقع التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، فثارت الخوارجُ عليه وقالوا: لا حكم إلَّا لله، وترتَّب على ذلك من الحوادثِ التي أدَّت لقتالهم بالنهروان وهزيمتهم، إلى آخر ذلك من الأحداث، وهذا هو أول أمرهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح([88]).
انقسمت الخوارج بعد ذلك فِرَقًا شتَّى، كالأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق، والحرورية، والإباضية وغيرهم.
والملاحظ في هذه الطائفة على اختلاف تشعباتها أنها تأتي بأمور مبتدعة، مبتكرةٍ من عنديَّاتها، أمورٍ غيرِ مألوفة عمَّن سبق تخرج عن الجادَّة والصراط المستقيم، وهذا المنحى التاريخي وإن كان متقدمًا على وقوع هذه الآثار والأمور المبتدعة منهم إلا أنه أمر معتبر في تسميتهم بـ «الخوارج» لا شكَّ في ذلك.
وتستمدُّ أصل التسمية عند بعض العلماء من الأحداث التي أسلفنا الإشارة إليها على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونجده عند البعض مستمدًّا من أصل واردٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالأمر دائر على منحيين:
- المنحى الأول: الاستمدادُ من الواقع التاريخي.
- والمنحى الثاني: الاستمداد من النص.
مع اعتبار أن هذا المنحى الثاني لم يُغفل الواقع التَّاريخي بحال من الأحوال.
والمنحى التاريخي هو الخروجُ على الإمام عليٍّ وعلى جماعة المسلمين، وتكفيره هو ومعاوية وأتباعه، وحصر الإسلام بأصحاب هذه الدعوة دون سواها، مع ما ترتب على هذا من استحلالٍ لدماء المسلمين وأموالهم لأنهم مرتدون، قال ابن حجر في الفتح:
«أما الخوارج فهم جمع خارجة؛ أي: طائفة، وهم قوم مبتدعون، سُموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين، وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه»([89]). وقال البدر العيني: «وإنما سموا به لخروجهم على عليٍّ»([90]).
وقد جعل العلماء هذا الاسم متحققًا في كل من خرج على الإمام، يقول الشهرستاني: «الخوارج: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًّا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان»([91]).
والخوارج على هذا -كما قال ابن حجر- على قسمين: أحدهما من خرج داعيًا إلى معتقده، والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضًا: قسم خرجوا غضبًا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة([92]).
والمنحى الثاني في أصل التسمية: مستمدٌّ من النص، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج والتي نادرًا ما خلا منها كتاب من كتب السنة، ونورد هنا ما استدل به العلماء على أصل التسمية.
فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»([93]).
والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- يمرقون من الدين مروقَ السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء»([94]).
والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»([95]).
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سيخرج قوم في آخر الزمان» وقوله صلى الله عليه وسلم «يخرج في هذه الأمة» وقوله صلى الله عليه وسلم «يخرج من ضئضئ هذا قوم» جعله بعض العلماء أصلًا في التسمية.
يقول أبو بكر بن العربي: «الخوارج إنما قيل لهم خوارج لقوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج فيكم» ومعنى، «فيكم» أي: عليكم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ﴾ [طه: 71] فكان خروجهم ومروقهم في زمان الصحابة، فسُموا الخوارج من قوله: «يخرج فيكم» وسمُّوا أيضًا: «المارقة» لقوله: «يمرقون من الدين» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تقتتل طائفَتان من أمَّتي، فتمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق»([96]).
وقال ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري: «أسلفنا سبب تسميتهم خوارج، وأنَّ سببه قوله عليه السلام: «سيخرج في آخر الزمان» فهذا هو الأصل الذي سمِّيت به الخوارج والمارقة»([97]).
وقال الإمام النووي: «وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة، وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة، وقيل: لقوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج من ضئضئ هذا»([98]).
وعلى هذا فإنَّ أصل التسمية هنا أعمُّ من الأول، وبه يُزال التلازم الشائع بين اسم الخوارج وخروجهم على الإمام علي، ويفهم به ما جاء في سياق كلام الأئمة من عدم الربط بين اسم «الخوارج» وبين أمور أخرى ليس من بينها الخروج على الإمام، بل نرى إطلاق لفظ «الخوارج» وإن لم يخرجوا أصلًا؛ بل وإن أقاموا الدولة -كما حدث في بلاد المغرب- حيث لا زالت التسمية حاصلة لهم؛ لتحقق الوصف وهو «الخروج» الذي جاء به الحديث النبوي الشريف، قال المرتضى الزبيدي في تاج العروس عن الخوارج:
«قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة. انتهى، وهم الحرورية، والخارجية طائفة منهم، وهم سبع طوائف، سموا به لخروجهم على -وفي نسخة- عن الناس، أو عن الدين، أو عن الحق، أو عن علي كرم الله وجهه بعد صفين، أقوال»([99]).
ما استفاضت السُّنة النبوية في ذكْرِ أوصاف أحد قط كما استفاضت في ذكر أوصاف الخوارج -وهي شاهدة على مدى العصور على صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم- هذه الأوصاف التي نجِدُها حسيَّة ومعنويَّة.
إلا أن الصفة اللازمة حتى يتحقق كون الشخص «خارجيًّا» هو تكفيره لعوام المسلمين، وليس الخروج على الإمام كما بيَّنا وكما هو شائع؛ ذلك لأن الخروج على الإمام ما هو إلا أمر تابع لتكفيره عوام المسلمين، وكذلك جميع الصفات التي وسم بها الخوارج على مرِّ التاريخ الإسلامي، إنما هي نابعة من صميم الرأي الأول في تكفير أهل القبلة، وقد شمل تكفيرهم أمير المؤمنين عليًّا وكلَّ من رضي بالتحكيم أو شارك فيه، وقد كان التحكيم هو ذروة ظهور أمرهم، وإن كان له من المقدمات التي سبقت ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذُهَيْبة، فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب، فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا! قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتقِ الله يا محمد، فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟» فسأله رجل قتله -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعه، فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذا -أو في عقب هذا- قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»([100]).
قال الحافظ بن حجر: «أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين، وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم؛ كذا قال، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار؛ فإنه لا نزاعَ عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان، بل كانوا ينكرون عليه أشياءَ ويتبرؤون منه، وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم، ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك، فلما قُتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه، واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليًّا فلقيا عائشة وكانت حجَّت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك، فبلغ عليًّا فخرج إليهم، فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة، فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق، ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان عليٌّ أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام، فاعتل بأن عثمان قُتل مظلومًا وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، ويلتمس من علي أن يمكنه منهم، ثم يبايع له بعد ذلك، وعلي يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إليَّ أحكم فيهم بالحق، فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبًا قتال أهل الشام، فخرج معاوية في أهل الشام قاصدًا إلى قتاله، فالتقيا بصفين، فدامت الحرب بينهما أشهرًا، وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى، وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية، فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصًا القراء القتال بسبب ذلك تدينًا، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ [آل عمران: 23] الآية، فراسلوا أهل الشام في ذلك، فقالوا: ابعثوا حكمًا منكم وحكمًا منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال، فمن رأوا الحق معه أطاعوه، فأجاب علي ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين عليٌّ معاوية، فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه، فأجاب علي إلى ذلك، فأنكره عليه الخوارج أيضًا. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق، ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم، فرجع معاوية إلى الشام، ورجع علي إلى الكوفة، ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف، وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف، وقيل: ستة آلاف، ونزلوا مكانًا يقال له حروراء -بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة- ومن ثَم قيل لهم الحرورية، وكان كبيرهم عبد الله ابن الكواء -بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد- اليشكري، وشبث -بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة- التميمي، فأرسل إليهم عليٌّ ابنَ عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم عليٌّ، فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران، ثم أشاعوا أن عليًّا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك عليًّا فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله، فقال: كلمة حق يراد بها باطل، فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجد، ولا من رِزْقكم من الفيء، ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فسادًا. وخرجوا بشيء بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب، ثم راسلهم أيضًا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله، وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومرَّ بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان واليًا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريَّته عن ولد، فبلغ عليًّا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام. فأوقع بهم بالنهروان، ولم ينْجُ منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة، فهذا ملخص أول أمرهم، ثم انضم إلى من بقي منهم مَن مال إلى رأيهم، فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل عليًّا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح»([101]).
وكل ما قام به الخوارج في هذا إنما هو قائم على تكفير الإمام والمسلمين، حتى فيمن عرَّفهم بالخروج على الإمام علي رضي الله عنه، فإنما خرجوا عليه لاعتقادهم كفره وكفر أهل التحكيم، ومن ثمَّ فقد جعل العلماء صفة الخوارج الأولى ظهور التكفير منهم، وعلى ذلك جاءت تعاريفهم، وما يذكر بعد ذلك من صفاتهم إنما ذكر تبعًا لهذه الصفة الأصيلة، نورد في ذلك كلام بعض العلماء على سبيل الاختصار:
قال الكمال بن الهمام من الحنفية في ذكر طوائفِ الخارجين عن طاعة الإمام:
«والثالث قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية يوجب قتاله بتأويلهم، وهؤلاء يسمون بالخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»([102]).
وهذا الوصف الأخير ما هو إلا لبيان الواقع من هؤلاء الذين خرجوا على الإمام علي؛ وذلك لأن الصحابة -في رأي الخوارج- تابعوا الإمام عليًّا في التحكيم، وهو كبيرة عندهم فكفَر وكفروا، وهذا قد يتغير، وهذا حاصل، فإن الخوارج اختلفت مقالاتهم في الأقوام وإن كانت الأدلة واحدة، وقد ذكر الحصكفي عبارة قريبة من عبارة الكمال حيث قال:
«ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة: قطاع طريق وعُلِمَ حُكمهم، وبغاة ويجيء حكمهم، وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم، ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا، ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم»([103]).
قال ابن عابدين صاحب الحاشية:
«قوله: ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه»([104]).
وقال الإمام النووي في روضة الطالبين: «الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمُعَات والجماعات»([105]).
وقال الخطيب الشربيني: «الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات»([106]).
وكما ذكرنا فإن أي صفة أخرى للخوارج إنما هي مترتبة على التكفير كترك الجماعات، قال الرملي في نهاية المحتاج: «لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يُصلوا خلفهم»([107]).
وقال الزيادي من الشافعية: «وهم صنف من المبتدعة قائلون: بأن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار، وأن دار الإسلام بظهور الكبائر فيها تصير دار كفر وإباحة»([108]).
وبما سبق يعلم أن الخوارج والتكفير وجهان لعملة واحدة، فالخارجي أصل أمره هو تكفيره للمسلمين، وكل ما يظهر تباعًا منه من استحلال الدماء والأموال وانتهاك الأعراض إنَّما هو قائم على فكرة التكفير للمسلم.
وبناءً على ما سبق نقول: كل من تحقق فيه تكفير المسلمين فقد تحقق فيه وصف الخوارج، خرج على حاكم أم لم يخرج، فارق الجماعة أم لم يفارق؛ لأن المفارقة هي إظهار لاعتقاد الخوارج بالفعل، والتكفير إظهار لاعتقاد الخوارج بالقوة كما قاله القليوبي من الشافعية([109]).
وبهذا العرض تبيَّن أننا عندما نتكلَّم عن التكفير فإنما نتكلَّم عن رأي مِن آراء الخوارج بالدرجة الأولى، فكان الانطلاق واجبًا من هذه النقطة، وأنه اعتقادهم، والرد عليهم إنما هو من كلام المولى سبحانه وتعالى، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، والعلماء أهل السنة والجماعة بما كان من حجج ساطعة البرهان، قائمة على المعقول والمنقول.
وكما أشرنا سابقًا فإنَّ التحكيم الذي جرى بين الإمام علي وبين معاوية قد أفضى إلى خروج طائفة على الإمام علي مكفرة له ولمن رضي بالتحكيم، وقد جرى من المناقشات بين الإمام علي وبين الخوارج حول تكفيرهم الكثير كما سبق، واتضح أن بذرة الخوارج الخبيثة من حيث الفكرة قد وجدت في صورة ذي الخويصرة الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمه بالجور في القسمة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لهذا المرء أصحابًا سوف يظهرون يحقر المسلم عبادته إلى جانب عبادتهم واجتهاده في الطاعات، وأخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولكن الظهور الفعلي لهم على أرض الواقع كان في عهد الإمام علي بن أبي طالب وقت خلافته، وهذه هي بداية أمر الخوارج وظهور أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكهم ومنهجهم، ثم بعد ذلك تفرَّعت من هذه الجماعة جماعات كثيرة، وظهرت أفكار أخرى عبر السنين في تاريخ الأمة وصولًا إلى العصر الحديث، وسنعرض أقوال أهل التاريخ والسير من علماء المسلمين عن مبدأ أمرهم وظهور فتنتهم بعد القتال الذي وقع بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه وبين معاوية بن أبي سفيان ومن معه من أهل الشام.
نقل الإمام الطَّبري عن الزُّهريِّ أنه قال: «فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم -أي: حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم- ودعوا إلى ما فيها، فهاب أهل العراق، فعند ذلك حكَّموا الحكمين، فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري، واختار أهل الشام عمرو بن العاص، فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان، فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ويخفضا ما خفض القرآن، وأن يختارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهما يجتمعان بدومة الجندل، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح، فلما انصرف علي خالفت الحرورية (الخوارج) وخرجت، وكان ذلك أول ما ظهرت، فآذنوه بالحرب، وقالوا: لا حكم إلا لله»([110]).
فكان ذلك مبدأ أمرهم وخروجهم على علي بن أبي طالب بعد أن وافق على التحكيم، واعتبروا قبوله التحكيم كفرًا، مع أنهم هم وغيرهم الذين أكرهوا سيدنا عليًّا على قبول التحكيم عندما رفع أهل الشام أصحاب معاوية المصاحف؛ روى الطبري بسنده إلى عون بن أبي جحيفة أنه قال: «إن عليًّا لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج: زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي، فدخلا عليه فقال له حرقوص: لا حكم إلا لله، فقال علي: لا حكم إلا لله، فقال له حرقوص: تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، فقال لهم علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني، وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابًا، وشرطنا شروطًا، وأعطينا عليها عهودنا ومواثيقنا، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ﴾ [النَّحل: 91].
فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه.
فقال علي: ما هو ذنب، ولكنه عجز من الرأي، وضعف من الفعل، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه.
فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عزَّ وجلَّ قاتلتك؛ أطلب بذلك وجه الله ورضوانه.
فقال له علي: بؤسًا لك ما أشقاك! كأني بك قتيلًا تسفى عليك الريح.
قال: وددت أن قد كان ذلك.
فقال له علي: لو كنت محقًّا كان في الموت على الحق تعزية من الدنيا، إن الشيطان قد استهواكم فاتقوا الله عز وجل، إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها»([111]).
ولما رأى رؤوس الخوارج عزم الإمام علي على إنفاذ الحكومة والرضا بالتحكيم وبعثه أبا موسى الأشعري قرروا الانفصال عنه وتعيين أمير لهم.
-يقول الإمام الطَّبري: «قال أبو مخنف عن عبد الملك بن أبي حرة: إن عليًّا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة لقيت الخوارج بعضها بعضًا، فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها والركون إليها والإيثار إياها عناء وتبار، آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة. فقال له حرقوص بن زهير: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدْعوَنَّكُم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنَّكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ﴾ [النحل: 128]»([112]).
واجتمع أمر الخوارج وتولى أمر رئاستهم أناس منهم، وظلوا يجتمعون وتتزايد أعدادهم ويتفقون على ضلالهم ومخالفتهم لجماعة المسلمين حتى كانت واقعة النهروان ولقاء الإمام علي بالخوارج وانتصاره عليهم، وفيه قتل المخدج من الخوارج الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك آية لعلي وأصحابه أن الحق معهم، ولم ينجُ من الخوارج إلا قليل منهم في هذه المعركة، ولم يقتل من أصحاب سيدنا علي إلا القليل.
روى الإمام أحمد بسنده عن طارق بن زياد قال: سار علي إلى النهروان فقتل الخوارج، فقال: اطلبوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق، لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم أو فيهم رجل أسود، مخدج اليد في يده شعرات سود، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. قال: قال: ثم إنا وجدنا المخدج قال: فخررنا سجودًا وخرَّ عليٌّ ساجدًا معنا» ([113]).
وقضي الأمر بتفرق الخوارج في المدن والمناطق بعد واقعة النهروان؛ والتي كانت سنة سبع وثلاثين من الهجرة.
وقد تمَّ قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنة أربعين من الهجرة على يد عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم الذي شجعه على قتله رغبته في الزواج من امرأة جميلة قتل أبوها وأخوها وكانوا من الخوارج، فأرادت الثأر من أمير المؤمنين، فحرضت على قتله، وقام ابن ملجم بقتله وهو خارج لصلاة الفجر لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان.
فهذا هو مبدأ أمر الخوارج، طائفة باغية خرجت على الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وانشقت عنه بفهم مغلوط، ثم بنوا على فهمهم السقيم مبادئ وأفكارًا ما أنزل الله بها من سلطان، فانعزلوا عن عامة المسلمين، وأطلقوا لقب الجماعة المؤمنة على أنفسهم، وشتموا وكفروا أئمة الأمة وعلماءها ممن تربى وتخرج بمدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم أنزلوا آيات الكفار على المسلمين، وكفروا العصاة والمذنبين واستحلوا الأموال والدماء، فكانوا يقتلون أهل الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون أهل الكفر، وصار كل من لا يحمل منهجهم حلال الدم والمال حتى يؤمن بأفكارهم ومعتقدهم، وزعموا أنهم يريدون بكل ذلك وجه الله والخير لأمة المسلمين، ولم يكن الأمر كذلك حتى وإن ظهرت النوايا الحسنة عند بعضهم، فالذي قتل الإمام عليًّا قتله رغبة في الزواج من امرأة جميلة(1). وقد أجمع الصحابة الذين كانوا موجودين في تلك الفترة على ضلال تلك الطائفة ولعنهم ووصفهم بأنهم كلاب النار.
وقد انتهت هذه الفترة باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبذلك انتهت مرحلة تكوين وظهور هذه الفئة المبتدعة الضالة، وكانوا هم البذرة الأولى في مبدأ الحاكمية الذي سار عليه الخوارج من بعدهم حتى عصرنا هذا، فهم سنوها سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وقد تطور أمر هذه الفرقة على مرِّ التاريخ الإسلامي فظهرت من رحم هؤلاء الخوارج طوائفُ تخرج بالسيف على الأئمة وعلى عامة المسلمين، وكان خروجهم يحمل سمة الخوارج من الانسلاخ عن مجتمع المسلمين، والاعتقاد بخروج الناس من الدين وكفرهم، وأن المسلمين يعيشون في الجاهلية، وما يترتب على هذا من تكفير عامة المسلمين واستحلال الدماء والأعراض والأموال، أو في أحسن الأحوال القول بالتوقف في الحكم لهم بالإسلام حتى يتبين أمرهم، وهذه الطوائف التي التزمت هذا الفكر أضافت عليه معتقداتٍ ومناهجَ بحسب كل عصر وهم دائمًا يحاولون أن يؤصلوا لمذهبهم هذا من الشريعة مخالفين بذلك مذهب أهل السنة والجماعة، ولقد كانت قوتهم في كل العصور موجهة للمسلمين في المقام الأول، ولم يكن لهم في جهاد أعداء الدين نصيب، وسبحان الله لو أنك اطلعت على تاريخهم فستجدهم دائمًا منقسمين متفرقين متنازعين، وليس هذا إلا من شؤم الضلال الذي ركبوه ونسبوه للإسلام.
والكلام عن بداية ظهور الخوارج يقتضي التعرُّض للمناظرة التي دارت بينهم وبين ابن عباس؛ فقد نقلت كتب السنة لقاء ومناظرة للصحابي الجليل عبدالله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطائفة الخوارج الذين اعتزلوا جماعة المسلمين وأعلنوا كفر الإمام علي، والخروج عليه والاستعداد لحربه، وقد وردت هذه المناظرة في العديد من كتب السنة، نذكر منها ما أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى بسندهما إلى ابن عباس أنه قال: «لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف، أتيت عليًّا فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أخاف عليك، قلت: كلا.
قال ابن عباس: فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن -قال أبو زميل: كان ابن عباس جميلًا جهيرًا- قال ابن عباس: فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون عليَّ! لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾ [الأعراف: 32]. قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا، فإن الله يقول: ﴿بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: 58].
قال ابن عباس: وأتيت قومًا لم أَرَ قومًا أشد اجتهادًا منهم، مسهمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر، فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: 57] وما للرجال وما للحكم؟! فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارًا لقد حلَّ سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا اسمه من أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.
فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم.
فقلت: أما قولكم: حكَّم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞ﴾ إلى قوله: ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [المائدة: 95]، فنشدتكم بالله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء حكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾ [النِّساء: 35] فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.
قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم: ليست أمنا لقد كفرتم، فإن الله يقول: ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ﴾ [الأحزاب: 6] فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة، فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.
قال: وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم، قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين: «اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنك تعلم إني رسول الله، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله» فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محا اسمه.
قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان، وقتل سائرهم على ضلالة»([114]).
وإن الناظر في هذه المناظرة ليجد من سطحية الفكر ما يعجب له اللبيب، هذه السطحية التي جرتهم إلى قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن الملقن: « خرج إليهم عبد الله بن خباب رسولًا من عند علي جعل يعظهم، فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فوضعها في فيه، فقال له بعض أصحابه: تمرة معاهد استحللتها؟ قال لهم عبد الله بن خباب: أنا أدلكم على ما هو أعظم منها حرمةً، رجل مسلم، يعني: نفسه، فقتلوه، فأرسل إليهم علي أن أقيدونا به، قالوا: وكيف نقيدك به وكلنا قتله؟ فقاتلهم، فقتل أكثرهم»([115]).
وقد استمرَّ الخوارج على ضلالتهم، وانقسموا فرقًا وكان لهم وجود في بلاد المسلمين، مفرعين على أفكارهم وبدعتهم ما الله به عليم، وهذا ما سيأتي قريبًا.
ولما سقطت الخلافة الإسلامية في عشرينيات القرن العشرين، فكانت طامَّة على بلاد المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باعتزال الفتنة، وعدم الخوض فيها، فخالف في ذلك جماعة قدموا أنفسهم على أنهم حملة الإسلام الحقيقي الذي يجب على كافة المسلمين أن يتبعوهم فيه، وكانت التقييدات الدائمة لأنفسهم كأشخاص أو جماعات بأوصاف كـ «المسلمون»، «الإسلامية»، دالة على ذلك دلالة واضحة، لكن الإشكال جاء أن هذه الجماعات قليلة العلم، أو منعدمة العلم، لكن أهلها تزيوا بزي العلماء، فكان إفسادهم أكبر من إصلاحهم، وجاءوا بالأفكار التي كانت على سنن الخوارج الأول، مناهج إصلاحية في الظاهر لكنها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، يعلم ذلك أهل العلم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من نور البصيرة، وكان من أول من نشر هذا الأمر في بلاد المسلمين جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا، وقد حذره مشايخ العصر من إنشاء مثل تلك الجماعة، وقد تحققت محاذيرهم فكانت الجماعة امتدادًا للخوارج في العصور الأولى بموضوع الحاكمية، ثم بعد ذلك انضم سيد قطب إلى الجماعة وأقام لهذه الفكرة لوازم «جاهلية المجتمع» فرمى المجتمع الإسلامي كله بالردة، ثم خرج من تحت تلك العباءة أغلب فرق الجماعات المتشددة وهم خوارج العصر. وذلك كسيد قطب وجماعة التكفير والهجرة وكانت من أبرز الطَّوائف التي تمثِّل الفِكر التَّكفيري، وقد أطلقت على نفسِها جماعة المسلمين، وأطلق عليها أهل العِلْم جماعة التَّكفيرِ والهجرةِ، وهو اسمٌ ينمُّ عن صفتين من سمات هذه الجماعة: هو تكفير المجتمع والأفراد، والعُزلة عن المجتمع ومفارقته بالهجرة عنه.
ويُعد العنصر البارز والأكثر تأثيرًا في هذه الجماعة وأفكارِها هو شكري مصطفى، وكان متزوجًا من شقيقة أحدِ المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ويُدعى محمَّد صبحي مصطفى، وكان من المتعاطفين مع فِكر الإخوان المسلمين في فترة الستينيَّات، وتمَّ القبض عليه عام 1965م، وأفرج عنه عام 1971م، وكانت كتابات سيِّد قطب عن المفاصلة والعُزلة وجاهلية المجتمعات الإسلاميةِ تُمثِّلُ النَّصيبَ الأوفرَ في مرجعيَّته الفِكرية، وفي فترة سجنه هذه تبلورت أفكارُ شكري مصطفى التي عُرف بها، وكان منها:
– يعد الحكم بالتكفير عنصرًا أساسيًّا في معتقدات هذه الجماعة، فهم يكفِّرون نظام الحكم وقتئذ ممثَّلًا في رئيس الدولة وجميع من يعمل معه، وكل من رضي عن نظامه، وتكفير جميع المجتمع بأفراده؛ لأنهم موالون للحكام، وبالتالي لا ينفعهم صوم ولا صلاة ولا أي ممارسة لشعائر الإسلام!
– الانعزال والانفراد بأفراد جماعته عن المجتمع الجاهلي، والعزلة عندهم نوعان: عزلة مكانية، وعزلة شعورية، بحيث عندما تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية، تعيش فيها الجماعة منفصلة عن الكفار؛ لأنهم اعتبروا أن كل من هو خارج عن هذه الجماعة سواء المجتمعات أو الأفراد من الكفار، وإذا ترك العضو جماعته اعتبر كذلك من الكفار ويجب تصفيته جسديًّا.
– وقوع الأمة الإسلامية في الجاهليَّة والكفر من بعد القرن الرابع الهجري؛ لتقديسهم التقليد في الأحكام، فعندهم يجب أن يعرف المسلم الأحكام بأدلتها، ولا يجوز له التقليد في أي أمر من أمور الدين، وأن من يسمون بعلماء الدين في القديم والحديث لا قيمة لهم، وإنما المعتبر الكتاب والسنة.
– قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد لأن المساجد كلها مساجد ضرار، وأئمتها كفار إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، ومسجد قباء، والمسجد الأقصى، وهم لا يصلون فيها أيضًا إلا إذا كان الإمام منهم.
– يحرمون الانتساب إلى المدارس والمعاهد والكليات إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنها مؤسسات للحكومات الكافرة، ويحرمون العمل في المؤسسات الحكومية حتى لو كان العمل في ذاته مباحًا؛ لأن في ذلك دعمًا للمجتمع الكافر!
وقد تورطت هذه الجماعة في اغتيال وزير الأوقاف المصري الشيخ محمد حسين الذهبي عام 1978م بسبب انتقاد الشيخ الذهبي لمنهج الجماعة الضال، وانته الأمر بالقبض عليهم ومحاكمتهم والقضاء بإعدام شكري مصطفى وآخرين.
ومن أبرز ما اتسمت به جماعة التكفير والهجرة ما قاله شكري مصطفى أمام هيئة محكمة أمن الدولة العليا (القضية رقم 6 لسنة 1977م) والتي نشرت في الصحف المصرية يوم (21/ 10/1979م) جاء فيها: إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعًا، وبيان ذلك أنهم تركوا التحاكم لشرع الله واستبدلوه بقوانين وضعية، ولقد قال الله: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: 44] بيد أن الأفراد أنفسهم لا نستطيع الحكم عليهم بالكفر لعدم التبين من ذلك، لذا فهم فقط جاهليون ينتمون لمجتمع جاهلي يجب التوقف في الحكم عليهم حتى يتبين إسلامهم من كفرهم، إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والإجماع وسائر ما تسميه الأصنام كالقياس، وبيان ذلك: أن المسلم ملتزم فقط بما ذكر في القرآن الكريم والسنة المطهرة، سواء كان أمرًا أو نهيًا، وما يزيد عن ذلك عن طريق الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة فهو بدعة في دين الله، إن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساس كي يكون المسلم مسلمًا، ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد وما رخصوا لأنفسهم فيه، وقد أسلموا أمرهم إلى الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله، واعتبروا كل من ينطق بالشهادتين مسلمًا.
إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين، ولكنه إقرار وعمل، ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافرًا، الإسلام الحق هو الذي تتبناه جماعة المسلمين، وهو ما كان عليه الرسول وصحابته وعهد الخلافة الراشدة فقط، وبعد هذا لم يكن ثمة إسلام صحيح على وجه الأرض، حتى الآن حياة الأسرة داخل الجماعة مترابطة ببعضها بحكم عدم الاختلاط بالعالم الخارجي.
– ومن جوانب الفكر التكفيري عند هذه الجماعة قولهم بتكفير كل خارج عن جماعتهم؛ لأنهم جعلوا من جماعتهم جماعة المسلمين، وهذه صورة لحوار دار بين عبد الرحمن أبي الخير ورجل آخر من جماعة مصطفى شكري:
أبو الخير: لماذا لا نصلي على الشيخ صالح سرية، وكارم الأناضولي([116])؟
الآخر: لأنَّا بلغناهم الحقَّ فرفضوا.
أبو الخير: علامَ اتَّفقتم؟ وعلامَ اختلفتم؟
الآخر: اتَّفقنا في مسألة أقوال الصحابة، وأقوال الفقهاء فهم يأخذون بهذه الأقوالِ ونحن لا نقول بها.
أبو الخير: ولكني قرأت محاكمة (صالح)، وسمعت مرافعة (كارم) عن نفسه، فتبينت وضوح المصطلحات: «الطاغوت، والكفر، والإيمان، والجاهلية، والإسلام». فضلًا عن إدراك كارم لطبيعة المعركة ضد الحركة الإسلامية عبر السنين.
الآخر: ولكنهما رفضا أن يبايعا الجماعة ونحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم.
أبو الخير: ألا يجوز أن نعترف بالأمر الواقع وتعدد الجماعات القائمة على التصور الصحيح؟
الآخر: لا يجوز أن تتعدَّد الجماعة المسلمة اهـ([117]).
– فهذه الجماعة بمعتقدها ومنهجها تعدُّ فاتحة انتشار الآراء التكفيرية في البلاد الإسلامية في العصر الحديث؛ لأنه وإن كانت هذه الجماعة قد قضي على وجودها ككيان مادي، إلا أن كثيرًا من أفكارها ظلَّت موجودة وتأثرت بها جماعات أخرى ظهرت بعد ذلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تلى ذلك الجماعات الجهادية ونقصد بالجماعات الجهادية جميع المجموعات التي اتَّخذت من القوة بكافة صورها ودرجاتها منهجًا لتحقيق أهدافها، وتحقيق ما ترى أنه يمثل عندها صحيح الدين ومنهج أهل السنة والجماعة ومراد الله من المسلمين في هذه الأرض، متخذة لها عدَّة شعارات منها: عودة الخلافة الإسلامية أو إقامة الدولة الإسلامية.
وهذه الجماعات قد بلغت من الكثرة حدًّا يصعب معه حصرها وضبط منهج وطريقة كل منها، ولكن الثابت في حقِّ كل هذه الجماعات هو استمداد أصول مناهجها وخطوات تحقيق أهدافها من مذهب الخوارج الأوائل، ويظهر ذلك جليًّا واضحًا في استحلالهم تكفير المسلمين، وتجهيل المجتمعات، والخروج على ولاة الأمور، وإشاعة الفوضى، متخذين من ادعاء الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين ستارًا لتبرير أعمالهم، آخذين بمبدأ الانتقاء من الآيات القرآنية والنصوص الشرعية والأحكام الفقهية ما يوافق أهواءهم، ويغضون الطرف عن ضوابط التعامل مع هذه النصوص وفهمها ووجه الدلالة فيها، وفيم نزلت أو لأي مناسبة قيلت فيها، أو هل ما يأخذون به من أحكام فقهية يتخذونها مبررًا لأعمالهم متوافق من جميع نواحيه ومتطابق مع الحالة والوقت والظروف التي يعيشها المسلمون الآن؟!
ودرجة ظهور الفكر التكفيري في هذه الجماعات ليست واحدة، فقد تظهر درجة التكفير ساطعة واضحة في منهج جماعة وسلوكها، وتعلن بالقول الصريح تبنيها للتكفير وتوزيع أحكام الردة والخروج من ملة الإسلام، وأن هذا هو الدين، بل وتنفذ من الأعمال على أرض الواقع ما يؤكد ذلك.
وقد يختفي هذا الفكر التكفيري في منهج جماعة أخرى تحت ستار من العلم والفقه والعمل الدعوي ونشر عقيدة التوحيد، لكنه يظهر من خلال والكلام عن تطبيق الشريعة الإسلامية وتناولهم لقضية الحاكمية التي تعد المدخل الواسع لظهور فكر التكفير، إلى جانب الكلام عن جهاد الكفار والمرتدين، وباب الولاء والبراء، وأبواب إنكار المنكر والعمل على تغييره، فتظهر حقيقة مذهبهم التكفيري أثناء تناولهم مثل هذه المسائل.
وهناك من الجماعات من تنكر تبنيها لفكر التكفير، بل وتتبرأ منه، ولكن بالنظر إلى طبيعة موقفهم من أفعال وأقوال جماعات العنف تجد صمتًا وعدم إنكار منها لأي فعل من هذه الأفعال، وإن اضطرت تحت ضغط الواقع والظروف إلى تبني موقف محدَّد تجاه مثل هذه الأمور فيتم استدعاء مذهب التقية والأخذ به، وإظهار إنكار زائف مخالف لما في النفس من تقبل وتفهم لفكر التكفير وما ينتج عنه من أعمال، وذلك كجماعة الجهاد التي تأسست عام 1964م على يد علوي مصطفى، وإسماعيل طنطاوي، وأيمن الظواهري، ونبيل البرعي، ومن أبرز أسماء المنتمين وقتئذ رفاعي سرور، وكان هدفهم العمل على إقامة الدولة الإسلامية، واقتلاع النظام الكافر المعادي للإسلام في مصر وذلك عن طريق تبني مبدأ الانقلاب العسكري عن طريق محاولة التغلغل واختراق صفوف الجيش، وذلك من خلال الدفع بالأشخاص المنتمين لهذا التنظيم في دخول الكليات العسكرية مما يؤهلهم بعد ذلك من التمكن من إحداث التغيير المطلوب بالقوة المسلحة، وقد اعتمدت هذه الجماعة على كتابات سيد قطب – خاصة كتابي: «في ظلال القرآن، ومعالم في الطريق»- في مرجعيتهم الفكرية وإصباغ الشرعية على فكرهم التكفيري وجاهلية المجتمع.
ومن مظاهر وجود فكر التكفير في هذه الجماعة وجود خلاف بين أعضاء هذا التنظيم أثناء خوض مصر حربَ تحرير أرضها مع إسرائيل عام 1973م وما حققته من انتصارات، وكان خلافهم بشأن مدى إسلام ضباط الجيش من أعضاء التنظيم الذين شاركوا في الحرب، خاصة من مات منهم، فتزعم بعضهم القول بأنهم غير شهداء؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الطاغوت وتحقيق أهدافه.
الذي ظهر على أرض الواقع على يد المهندس محمد عبد السلام فرج عام 1980م، والذي ضم كلًّا من عبود الزمر وطارق الزمر وأحمد سلامة، وهو التنظيم الذي تم على يديه اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات رحمه الله خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر عام 1981م، ومحمد عبد السلام فرج هو مؤلف كتاب: «الفريضة الغائبة» الذي يعد دستور ومرجعية هذا التنظيم، بل إن محمد عبد السلام فرج يعد المنظر له والراسم لخطواته وأفكاره التي تتمثل في كفر الأنظمة الحاكمة لبلاد المسلمين ووجوب الجهاد ضدهم، حيث يقول:
«وهناك قول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة، والحقيقة أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المسلم بأنه: «كيس فطن»([118]). أي أنه يعرف ما ينفع وما يغير، ويقدم الحلول الحازمة الجذرية، وهذه نقطة تستلزم توضيح الآتي:
أولًا: أن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد.
ثانيًا: أن دماء المسلمين ستنزف حتى وإن تحقق النصر! فالسؤال الآن: هل هذا النصر لصالح الدولة الإسلامية القائمة، أم أن هذا النصر لصالح الحكم الكافر وهو تثبيت لأركان الدولة الخارجة عن شرع الله؟ وهؤلاء الحكام إنما ينتهزون فرصة أفكار هؤلاء المسلمين الوطنية في تحقيق أغراضهم غير الإسلامية وإن كان ظاهرها الإسلام، فالقتال يجب أن يكون تحت راية مسلمة وقيادة، ولا خلاف في ذلك.
ثالثًا: أن أساس وجود الاستعمار في بلاد الإسلام هم هؤلاء الحكام، فالبدء بالقضاء على الاستعمار هو عمل غير مجدٍ وغير مفيد وما هو إلا مضيعة للوقت، فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية، وهي إقامة شرع الله أولًا في بلادنا، وجعل كلمة الله هي العليا، فلا شك أن ميدان الجهاد هو اقتلاع تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامي الكامل، ومن هنا تكون الانطلاقة»([119]).
إن هذه المجموعات التي تستظل بمظلة الجهاد تطفح مناهجها بمظاهر الفكر التكفيري واستحلال دماء المسلمين، بدليل أفعالها التي تنبئ عن ذلك، مثاله:
1- محاولات استهداف واغتيال العديد من ضباط الشرطة المصريَّة، خاصةً في فترة التسعينيات من القرن العشرين.
2- الهجوم على مديرية أمن أسيوط في عام 1981م بعد اغتيال الرئيس السادات، والاشتباك مع ضباط وجنود الشرطة مما أدَّى إلى مصرع كثير من الأبرياء الذين تقع على عاتقهم مهمَّةُ حفظ الأمنِ في الشَّارع المصري.
3- محاولة اغتيال وزير الدَّاخلية الأسبق اللواء حسن الألفي عبرَ تفجير أحدِ أعضاء التنظيم نفسه في موكب الوزير أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد قُتل عضو التَّنظيم، في حين أُصيب الوزيرُ وعددٌ من حُرَّاسه بجروحٍ بالغةٍ، وذلك في صيف سنة 1993م.
4- محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي بتفجير موكبه بسيارةٍ ملغومةٍ تم تفجيرُها عن بُعد بأحد شوارع حي مصر الجديدة بالقاهرة، ولم يُصب رئيس الوزراء بأذًى، ولكن أُصيب بعضُ المارة بإصاباتٍ مختلفةٍ عام 1993م.
وتُعد الجماعاتُ السَّلفية الجهاديَّة في السَّنوات القلائل الأخيرةِ في مصر قد خرجت من تحت عباءة جماعة الجهاد حيث نجد التَّشابه الواضحَ في الأفكار والمنهجِ، مما يمكن معه القول: إنَّ جماعات السَّلفية الجهاديَّة ما هي إلا تنظيم الجهاد المصريِّ القديم في ثوبه الجديدِ، فنجد التَّشابه والتطابق بين هذه الجماعات وبين تنظيم الجهاد من حيث كُفر الحكَّام، وحتميَّة الجهاد، وعودة الخلافة الإسلامية، واستحلال قتل أفرادِ الجيشِ والشُّرطة، وتتميَّز الخطابات الجهادية بطابع الحديث عن كفر الطَّواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين، ووجوب جهادهم والخروج عليهم، والحديث عن الولاء والبراء في الشَّريعة الإسلامية، وجعله بابًا كبيرًا من أبواب التَّكفير للمسلمين.
داعش هي آخر الثمار المرة التي نتجت من شجرة التكفير، وهي عبارة عن تنظيم مسلح يتبنى الفكر السلفي الجهادي التكفيري لكن بصورة أكثر وضوحًا ودموية، وأصبح يسمي نفسه الآن الدولة الإسلامية، والهدف من هذا التنظيم- فيما يزعمون- إعادة الخلافة الإسلامية، وهو منتشر في بعض البلدان مثل سوريا والعراق وبعض أماكن المغرب العربي، وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي.
ففي (29/ 4/ 2013م) تم إعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام مع كلمة صوتية بثتها قناة الجزيرة، ثم بعد ذلك أعلنت (داعش) بتاريخ (29 يونيو 2014م) الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي بكر البغدادي خليفة للمسلمين، وقال الناطق الرسمي باسم الدولة أبو محمد العدناني: إنه تم إلغاء اسمي العراق والشام من مسمى الدولة، وأن مقاتليها أزالوا الحدود التي وصفها بالصنم، وأن الاسم الحالي سيلغى ليحل بدلًا منه اسم الدولة الإسلامية فقط([120]).
ولو نظرنا إلى طبيعة ما تقومُ به هذه الجماعة المعروفة بداعش على أرض الواقع لأدركنا تطابق ما جاء من الأحاديث النبوية الشريفة المحذرة من طائفة الخوارج وحالهم على هذه الجماعة الضالة.
وأيضًا لو نظرنا على أرض الواقع إلى ما تقوم به من أعمال عنف وسفك دماء وتخريب لبلاد المسلمين لوجدنا الصلة الوثيقة بين الخوارج الأوائل المؤسسين والأحفاد الداعشيين، تجد ذلك في أصول الاعتقاد من حيث إنهم يرون كفر من لم يكن على طريقهم ومنهجهم، ويعتبرون أنفسهم جماعة المسلمين، والمتأمل في حالهم يجد أنهم أصبحوا أداة من أدوات تفتيت شمل أمة الإسلام وعاملًا من عوامل إضعاف كيانها، بل الواقع ينبئ عن عمالتهم للدول الأجنبية التي تعمل على تخريب بلاد المسلمين والنيل منها دون أن تراق لهذه الدول قطرة دم واحدة، وَلِمَ لا وقد وجدوا في بعض المغفلين من المنتسبين للإسلام من يقوم بذلك نيابةً عنهم، فخرجت هذه الطائفة الضالة علينا بمسمى دولة الخلافة بزعامة أبي بكر البغدادي سائرة على درب أسلافهم الخوارج، فذهبوا يكفرون من لم يسمع لهم ويأخذ برأيهم، ويستحلون دمه، ويرون المسلمين إما كفارًا أو مرتدين، وعليهم إن أرادوا أن يعصموا أنفسهم ودماءهم وأعراض نسائهم أن يسلموا من جديد، ثم يبايعوا الخليفة البغدادي المزعوم الذي تولَّى أمر قيادة الأمة المحمدية، وهكذا شاهدنا على شاشات الفضائيات كثيرًا من الناس تحت التهديد والخوف في مدينتي الرقة والموصل وفي القرى التي استولى عليها هؤلاء الفجرة يقفون الساعات الطوال في المساجد لإعلان إسلامهم من جديد ودخولهم تحت إمرة داعش ومبايعة الأمير الذي أوكل إليه الخليفة البغدادي المزعوم أخذ البيعة من رعاياه المخلصين، هذا وإلا فمصيرهم معروف محتوم وهو القتل.
والمتابع لنشأة هذا التنظيم سيتوقف قليلًا وهو ينظر إلى المستوى الثقافي والفقهي لقادة هذه الفئة الضالة وتلك السطحية التي يتميزون بها في الفهم والمعرفة، ويحاولون التغطية عليها بغطاء التشدد والعنف اللفظي والجسدي تحت مسمى الجهاد، فالتوقف أمام هؤلاء القادة والتمعُّن في حالهم يكشف لنا أننا إزاء جهلة بالدين والسياسة معًا، فكيف بالأتباع؟!
وما فعلته داعش موثق بالصوت والصورة في شتى أنحاء العالم، بل على المواقع الخاصة بهم على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وتتلخص أفعالهم فيما يلي:
1- تشويه صورة ديننا الحنيف واستغلاله لتحقيق الأهداف الشخصية والأطماع الطائفية، فلا هم نصروا دينًا ولا أقاموا دنيا، بل أساؤوا إلى الإسلام بأفعالهم الخبيثة.
2- قيامهم بذبح المخالف لهم بأبشع الطرق بدون رحمة أو شفقة تحت مسمى أنهم بذلك يطبقون الحدود.
3- القيام بسبي نساء المسلمين وغير المسلمين تحت ستار الدين والجهاد، وفتح أسواق النخاسة، محققين بذلك أغراضهم الدنيئة، وتوزيع النساء كغنائم بعضهم على بعض.
4- دعوتهم لهجرة المسلمين إليهم من ديار الكفر إلى دولة خلافتهم المزعومة، بل قد وصل الأمر بأنهم يدعون المهاجر إليهم بأن يقتل ذويه إن لم يكونوا على نفس منهجه، بحسب ما ذكره مرصد دار الإفتاء المصرية لفتاوى التكفير.
5- دعوتهم الفتيات عبر مواقعهم الخاصة إلى ما يسمى بزواج الفيديو كونفرانس؛ تمهيدًا لسفرهم بعد ذلك إلى مناطق هذا التنظيم الإرهابي، للعمل على استقطاب منتمين جدد للتنظيم من خلال زعم توفير زوجة للمنتمي لهم.
6- العمل على تجنيد الأطفال بغرس مبادئ تنظيمهم الضال داخلهم عن طريق نشرهم لدليل إرشادي يشرح للأمهات المنتميات لهذه الفئة كيفية تنشئة أطفالهن؛ طبقًا لمبادئ وتعليمات التنظيم، لضمان استمرار وجود جيل يؤمن بشرعية تنظيمهم، وأنه هو التمثيل الحقيقي للإسلام.
7- استحلال حرق من يقع في أيديهم من المخالفين والأسرى متذرِّعين في ذلك بفتاوى ضالة من أئمتهم، مستندين فيها إلى الأخبار الواهية بشرعية ذلك في دين الإسلام، متناسين أن الإسلام قد أمر بالإحسان إلى أسرى الحروب.
8- تصديرهم أقوالهم وبيانتهم بـ: قد جئناكم بالذبح. بل قد أصدر هذا التنظيم الضال فتوى بعنوان: «الذبح فريضة إسلامية غائبة» فقد زعمت هذه الفئة الفاجرة أن نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه قد جعل من القتل والذبح شعارًا لهذا الدين الكريم.
تلك كانت صورة من أفعالهم المخزية المشينة، وهي أفعال كشفت فساد وخبث منهجهم أمام الجميع، وقد تكون في ذاتها حصنًا ودرعًا لأي مسلم عاقل يعلم ولو أقل القليل عن دينه أن هؤلاء القوم هم أهل ضلال، وأن دين الرحمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دين الإفساد في الأرض ودين سفك الدماء.
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله عز وجل ﴿وأما عاد…﴾ (3344)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (1064).
([2]) انظر: المصباح المنير (ج ه د) الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
([3]) المفردات في غريب القرآن (1/ 198) للراغب الأصفهاني، دار القلم، دمشق.
([4]) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (373) من حديث جابر رضي الله عنه. قال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف.
([5]) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 121) دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ – 1992م.
([6]) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.
([7]) انظر: نهاية المطلب (17/ 389) لأبي المعالي الجويني، أ. د عبد العظيم الديب، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1428هـ – 2007م.
([8]) جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي تأليف الدكتور خالد رمزي البزايعة ص26 ط: دار النفائس الأردن، آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، ص 35 ط:دار الفكر سوريا.
([9]) جرائم الحرب للدكتور خالد رمزي البزايعة (ص30، 31) ط: دار النفائس الأردن.
([10]) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 204) للإمام النووي، تحقيق: زهير شاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ – 1991م.
([11]) انظر: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه (ص 19) للبوطي، دار الفكر، سورية، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1993م.
([13]) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 123).
([14]) تفسير الطبري (18/ 645) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للدراسات والبحوث الإسلامية.
([16]) عمدة القاري (1/ 178) للبدر العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
([17]) السيرة الحلبية (2/ 245) للحلبي، دار المعرفة، بيروت.
([18]) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (1/ 217) للعلائي، تحقيق ودراسة د. محمد عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م.
([19]) انظر: حاشية البيجوري (ص 766) تحقيق: د. علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1422هـ – 2002م.
([20]) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 120).
([21]) انظر: بدائع الصنائع (7/ 237) للإمام علاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1986م.
([22]) انظر: تاج العروس (ح ر ب) المرتضى الزبيدي، وزارة الإعلام، الكويت.
([23])انظر: فتح القدير (5/ 452) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر.
([24]) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ (10)، وابن أبي شيبة في مصنفه (19522)، والبيهقي في الكبرى (18125) مرسلًا من حديث أبي بكر.
([25]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب (3015)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (1744) من حديث عبدالله بن عمر.
([26]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس (4323)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى… (2498).
([27]) انظر: بدائع الصنائع (7/ 101).
([28]) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 311)، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، مكتبة القاهرة، 1388هـ – 1968م.
([29]) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (2/ 176) دار الفكر.
([30]) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية (ص81) تأليف عبد الوهاب خلاف، دار القلم، 1998م.
([31]) انظر: تفسير الطبري (3/ 290).
([32]) انظر: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه (ص 95).
([33]) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (2842)، وابن حبان في صحيحه (4791) من حديث حنظلة الكاتب.
([37]) السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية (ص81).
([38]) السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية(ص81).
([41]) السياسة الشرعية في أمور الولاة والرعية لابن تيمية (1/ 100) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1418هـ.
([42]) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 124).
([43]) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر (9/ 213) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1357هـ- 1983م.
([44])انظر: نهاية المحتاج للرملي (8/ 46) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1404هـ- 1984م.
([45]) كنز الراغبين بحاشية القليوبي وعميرة (4/ 215) أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، 1415هـ- 1995م.
([46]) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع (335) دار الطباعة ببولاق- مصر، 1285هـ .
([47]) السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية (ص81).
([48]) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2341)، والطبراني في المعجم الكبير (11/228، 11576)، وأحمد في مسنده (2865)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير. انظر: فيض القدير (6/431) زين الدين المناوي، المكتبة التجارية الكبري، مصر، الطبعة الأولى، 1356هـ.
([49]) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (1/7) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1990م.
([50]) أخرجه الطبراني في الأوسط (4775).
([51]) العلاقات الدولية في الإسلام (98) الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، 1415هـ- 1995م.
([52]) السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية (ص81).
([53]) انظر: مغني المحتاج (6/ 9) شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م.
([54]) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 173).
([55]) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 347) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412هـ- 1992م.
([56]) المرجع السابق (3/ 349).
([57]) المرجع السابق (2/ 173).
([58]) الموافقات (3/ 184) للإمام الشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1997م.
([59]) الفروق (1/ 177) للإمام شهاب الدين القرافي، دار عالم الكتب.
([60]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 106) للإمام عز الدين بن عبد السلام، تحقيق: محمود بن التلاميذ الشنقيطي، دار المعارف، بيروت.
([61]) القواعد الصغرى (ص 44) للإمام عز الدين بن عبد السلام، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر- دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1416هـ.
([67]) انظر: إعلام الموقعين (3/ 11) لابن القيم، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1991م.
([68]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 62).
([69]) المدخل للفقه الإسلامي (ص 265 وما بعدها) لمحمد سلام مدكور- دار الكتاب الحديث، الطبعة الثانية، 1996م.
([70]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 101).
([71]) أخرجه أحمد في مسنده (19/ 375) من حديث أنس.
([72]) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 50) من حديث ابن عمر.
([73]) متفق عليه: أخرجه البخاري (34)، ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو.
([74]) أخرجه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف.
([75]) أخرجه أبو داود (2759) من حديث عمرو بن عبسة.
([76]) أخرجه البخاري في كتاب، باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (6922) من حديث ابن عباس.
([77]) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في ذكر الخوارج (172) من حديث جابر.
([78]) أخرجه أحمد في مسنده (20017) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
([79]) أخرجه أحمد في مسنده (4148) من حديث ابن مسعود.
([80]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن(4905)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (2584) من حديث جابر.
([81]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب من بايع ثم استقال البيعة (7211)، ومسلم في كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها (1383)
([82]) أخرجه البيهقي في الكبرى (16971).
([84]) انظر: البيان لما يشغل الأذهان.
([85]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (1399) ومسلم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (20).
([86]) وسبب غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقافلة لقريش قادمة من الشام يقودها أبو سفيان فيها أموال عظيمة، فانتدب الناس إليها كتعويض لهم عن أموالهم التي أخذتها قريش بعدما هاجروا من مكة، ولكن أبا سفيان علم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى قريش لينقذوا أموالهم، فتجهزت قريش للقتال وخرجوا للحرب، وفي أثناء ذلك استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة وأرسل لقريش بذلك إلا أنهم أصروا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضوا عليه مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بالحرب. انظر: سيرة ابن هشام (3/ 152).
([87]) انظر: السنن الكبير للبيهقي (17/ 71).
([88]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/283) تحقيق: عبد الله بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب- دار الفكر.
([89]) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.
([90]) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 88) للبدر العيني، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
([91]) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/113) تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، 1404هـ.
([92]) انظر: فتح الباري (12/ 285، 286) لابن حجر.
([93]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب علامات النبوة (6930) ومسلم في كتاب الزكاة، باب التحريض على قتال الخوارج (1066) من حديث علي بن أبي طالب.
([94]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتال الخوارج والملحدين (6931) ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري.
([95]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله عز وجل ﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية﴾ (3344)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري.
([96]) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 398) لأبي بكر بن العربي، تحقيق: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007م.
([97]) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (31/563) للإمام ابن الملقن، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة الأولى، 1429هـ- 2008م.
([98]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/164) للإمام النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.
([99]) تاج العروس لمرتضى الزبيدي (5/517) دار الهداية.
([101]) انظر: فتح الباري (12/283) لابن حجر العسقلاني.
([102]) فتح القدير للكمال بن الهمام (6/100) دار الفكر، بيروت.
([103]) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/262) لعلاء الدين الحصكفي، دار الفكر، بيروت، 1386هـ.
([104]) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/262) للإمام ابن عابدين، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ-1992م.
([105]) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/51 ) للإمام النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ- 1999م.
([106]) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (4/124) دار الفكر- بيروت.
([107]) نهاية المحتاج (7 /403 ) للإمام الرملي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1404هـ-1984م.
([108]) حاشية البجيرمي على الإقناع (4/230) للإمام البجيرمي، دار الفكر، 1415هـ- 1995م.
([109]) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي للمنهاج (4/ 171) للإمامين: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، 1415هـ- 1995م.
([110]) انظر: تاريخ الرسل والملوك (5/57) للإمام محمَّد بن جرير الطَّبري- تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم- دار المعارف، مصر، الطَّبعة الثَّانية.
([111]) انظر: تاريخ الرسل والملوك (5/72).
([112]) انظر: تاريخ الرسل والملوك (5/74 ).
([113]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/147).
([114]) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/150) والبيهقي في السُّنن الكبرى (8/179) قال الحاكِم: «صحيحٌ على شرطِ مسلِم ولم يخرِّجاه». ووافقَه الذَّهبي.
([115]) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (19/ 230).
([116]) صالح سرية وكارم الأناضولي شخصان من قيادة جماعة مخالفة لجماعة شكري مصطفى، وهي الجماعة المعروفة بجماعة: «الفنية العسكرية».
([117]) انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة (ص304) لعبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الأولى، 1992م.
([118]) ورد ذلك في حديث؛ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 107)، والديلمي في مسند الفردوس (4/175) من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن كيِّسٌ فطنٌ حذر». وضعفه العجلوني في كشف الخفاء (2/293)وسليمان بن عمرو النخغي: كذاب. انظر: لسان الميزان (4/163).
([119]) من كتاب الجهاد الفريضة الغائبة: لمحمَّد عبد السلام فرج، والذي كتبه عام 1981م، وهو من الكتب المعتمدة عند جماعة الجهاد.
([120]) موقع الـ BBC العربي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).