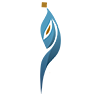الشبهات في باب الإلهيات
هذه المسألة بالطَّبع هي لبُّ الأطروحة الإلحاديَّة أو غايتها، تصلُ في النِّهاية إليها بطريق أو بآخر، ويرجع إليها كلُّ أنواع الإلحاد السَّالف ذكرها.
هذا والَّذين لا يؤمنون بوجود خالق للكون يدورُ كلامهم حول عدَّة فروض، من ضمنها ما تقدَّم ذكرُه من الادعاءات السُّوفسطائية، وإنكار الحقائق الكونيَّة، لكن كل ما تقدم ذكره من تفاصيل شبهات النظرية المعرفية يرجع إلى ذلك في أغلبِه بالعرض لا بالذَّات، أمَّا إنكار وجود الله تعالى بالذَّات فإنه يرجع إلى ادعاء إلحادي قديمٍ جديدٍ ألا وهو وجود العالم دون خالق، إذ لا يخلو الأمر بعد إنكار الملحد لوجود الله إلا أن يقول بأزلية الكون والطبيعة والقوانين الفيزيائية، أو أن يقول بالعوالم المتعددة اللامتناهية، أو أن يقول بالوجود الاتفاقي للعالم، أي أن العالم وجد صدفةً.
إذ أصول عقائد الملاحدة من الماديين تدور على أن جوهر العالم وحقيقة الوجود أو العالم هي المادة أو الوجود المشاهد مادية كانت أصوله أم غير مادية، فالمادة هي الأصل الأول الذي يشكل وجود الكون، ولا يوجد فيه روح ولا أي شيء إلا المادة، والمادة هي منبع الوعي والعقل، وتنكر الإله والنفس والنبوة، واليوم الآخر، فلا حياة حقيقية إلا الحياة الدنيا المشاهدة، وعلى ذلك تراهم يعارضون دائما الأدلة العقلية القائمة على وجود الإله مثل الدليل الكوني، ودليل الحدوث، والدليل الغائي، والدليل الوجودي([1]).
وقبل الولوج إلى الشبهة، نطرح أولًا الأدلة على وجود الله تعالى.
إنَّ الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة متنوعة، تختلف حتى بين نظر المتقدمين العقلي المحض، وبين المتأخرين.
أما المتقدمين فيقول الإمام الرازي رحمه الله: إن الطريق إلى إثبات الصانع تعالى ليس إلا احتياج أجسام هذه الموجودات المحسوسة إلى موجود آخر غير محسوس، ومنشأ تلك الحاجة على قول بعضهم هو الإمكان، وعلى قول آخرين هو الحدوث، وعلى قول ثالث هو مجموع الإمكان والحدوث، ثم هذه الأمور الثلاثة إما أن تعتبر في الذوات، أو في الصفات، أو في مجموعها، أو بالعكس، فالمجموع طرق ستة([2]).
وقد اعتمد الإمام الرازي أربع طرق؛ حاصل ضرب الحدوث أو الإمكان، في الذوات أو في الصفات قال:
اعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصانع بالإمكان، أو بالحدوث وعلى كلا التقديرين، فإما في الذوات، وإما في الصفات، فهذه طرق أربعة([3]).
فالطريق الأول: الاستدلال على وجود واجب الوجود بإمكان الذوات.
والطريق الثاني: الاستدلال على واجب الوجود لذاته بإمكان الصفات.
الطريق الثالث: في إثبات العلم بالصانع تعالى: الاستدلال عليه بحدوث الجواهر والأجسام.
الطريق الرابع: في إثبات الصانع: الاستدلال عليه بحدوث الصفات:
والعلماء حصروا ذلك في نوعين: دلائل الأنفس، ودلائل الآفاق([4]).
وترجع هذه الطرق إلى ثلاث: طريق الإمكان، وهو يعتمد العلة والمعلول، وطريق الحدوث، ليرجع إلى المحدث القائم بنفسه، وطريق الإتقان أن وجود العالم المتقن الصنع دال على وجود خالق وصانع متقن، فالإمكان ينظر فيه من حيث دلالته على الحاجة إلى الموجد للذوات أو المخصص للصفات، والحدوث يدل كذلك على الحاجة في الذوات والصفات، ويضاف إلى ذلك الدلالة من حيث العناية وإتقان الصنعة، فهذه كما يبدو أصول الطرق.
وأما الفيلسوف ابن ملكا أبو البركات صاحب المعتبر في الحكمة فقد حاول حصر الطرق التي تؤدي إلى العلم بالله تعالى، وذلك بعدما أبطل طريق الحركة الذي اتبعه أرسطو وتبعه فيه كثيرون منهم توما الأكويني وانتشر الاحتجاج بدليل الحركة في الفلسفة الغربية في القرون الوسطى، بل في القرون المعاصرة، فهي ما تزال محلَّ نظر وتأمل، وخلص ابن ملكا إلى أن الطرق إلى معرفة المبدأ الأول على حد تعبيره هي كما يلي:
الطريق الأول: طريق العلة والمعلول، قال ابن ملكا: وإنما الطرق التي سلك فيها من جهة المعلولات إلى عللها والمبتدئات إلى مبادئها هي الطريق التي أوجبت عند عقول النظار وجود علة أولى لا علة لها، وهدتهم إلى مبدأ أول لا مبدأ له.
الطريق الثاني: طريق الوجود الواجب والممكن، قال ابن ملكا: وهو أيضًا من جملة النظر في العلة والمعلول، يخالفه في العبارة، وإشباع النظر من جهة الإمكان والوجوب.
الطريق الثالث: قال ابن ملكا: طريق العلم وتعليمه وتعلمه ينتهي فيه النظر كما انتهى في الوجود المعلول إلى غير المعلول، كذلك ينتهي في النظر العلمي من عالم يتعلم من غيره ينتهي إلى العالم بذاته الذي علمه لذاته بذاته، والطريق فيه بعينه هو طريق العلة والمعلول في العلم من العلم، حتى يكون العلم الأول الذي هو علم الأول، علة لكل علم بعده وهو غير معلول لعلم قبله، قال بذلك الأنبياء والعلماء ومحجته واضحة في حدود العلة والمعلول.
الطريق الرابع: من جهة الحكمة العملية، قال ابن ملكا: وطريق آخر من جهة الحكمة العملية، فإن الذي رأيناه من خلق المخلوقات من السماوات والكائنات والجمادات والحيوانات والنبات من النظام، في الشخص الواحد والأشخاص الكثيرة والأنواع المختلفة، دل على أن الأفعال فيها ترجع إلى حكيم، يسوق المبادي إلى غاياتها والأوائل إلى نهاياتها.
ويلاحظ أن الطرق الأربع التي ذكرها ابن ملكا ترجع إلى المذكورة عند الإمام الرازي.
ولو نظرنا في كتب توما الأكويني الشهير في الفكر المسيحي لوجدناه يذكر في الخلاصة اللاهوتية أن الطريق إلى إثبات وجود الله لا يتم إلا بالبرهان الإني لا اللمي، وقرر ذلك بقوله على من زعم أنه لا يمكن البرهان على الله تعالى.
الجواب: أن يقال إن البرهان قسمان، أحدهما ما يكون بالعلة، ويقال له لمي، وهذا يكون بما هو متقدم مطلقا، والثاني ما يكون بالمعلول ويقال له إني، وهذا يكون بما هو متقدم بالنسبة إلينا؛ لأنه متى كان معلول أوضح لنا من علته، فإننا نتأدى بالمعلول إلى معرفة العلة، وكل معلول يمكن أن يبرهن منه على وجود علته الخاصة إذا كانت معلولاتها أبين منها لنا، لأنه لما كانت المعلولات متوقفة على العلة فوجود المعلول يستلزم بالضرورة تقدم وجود العلة فيه، فإذا لما كان وجود الله ليس بينا في نفسه لنا، كان متبرهنا بآثاره البينة لنا.
ثم شرع في بيان المناهج الخمسة التي يرتئيها للبرهان على وجود الله، وهي مسالك مشهورة بين الدارسين للفلسفة والإلهيات وفلسفة الدين، ومن المفيد ذكرها هنا بصورة مجملة.
فالمنهج الأول: اعتمد فيه على دليل الحركة والمحرك، ووجوب انتهاء المتحرك إلى محرك لا يتحرك، والثاني: اعتمد فيه على أن العلل المترتبة لا بد من انتهائها إلى علة لا علة لها، لاستحالة التسلسل والدور، والثالث: دليل الممكن والواجب المشهور، ففي الأشياء ما يمكن عدمه ووجوده، ولو لم يكن غيره، لم يكن شيء في الوجود الآن، وهذا باطل، فوجب وجود شيء لا يطرأ الفساد عليه ولا العدم، والرابع: من جهة التفاوت في المراتب من حيث الحقية والخيرية في الأشياء الموجودة، ووجوب انتهائها إلى الخير المحض، وهو غاية الوجود وفاعله، والخامس هو دليل النظام والغاية.
وأما موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي والشارح الشهير للتوراة، فقد تكلم في كتابه الشهير دلائل الحائرين على خمس وعشرين مقدمة وزاد عليها واحدة أخرى هي أن الزمان والحركة سرمديان، ذكرها أرسطو وسلمها له موسى بن ميمون تسليما حتى يبين غرضه منها، وجعلها من مبادئ إثبات وجود الله تعالى واجب الوجود.
ثم شرع في عد الطرق على إثبات الواجب وهذه الطرق هي:
الطريق الأول: طريق الحركة ووجوب انتهاء المتحرك إلى محرك غير متحرك.
الطريق الثاني: تعتمد على أنه إذا وجدت أشياء متحركة ومحركة، وأشياء متحركة لا تحرك أصلا، وجب أن يوجد محرك لا يتحرك، وهو المحرك الأول.
وهذا الذي ذكره هنا هو صورة من برهان التضايف المذكور عند المتكلمين… الطريق الثالث: وهو الطريق الثالث المذكور عند توما الأكويني وقد أحاله ابن ميمون إلى كلام ذكره أرسطو وإن جاء به لغرض آخر.
الطريق الرابع: إذا وجدت أشياء تكون بالقوة أحيانًا وبالفعل أحيانا أخرى، فلا بد من استنادها إلى موجود لا يكون إلا بالفعل دائما ولا قوة فيه أصلا، وهو الواجب الموجود([5]).
ثم إننا نرى -بعد تقرير هذه الأدلة- بعض الفلاسفة ينزع إلى طرق أخرى في الاستدلال، فنرى الدليل الأنطولوجي الوجودي، المشتهر في القرون الوسطى إلى عصرنا الحاضر، ونرى أدلة تتسم بالعملية كالدليل الأخلاقي، ورهان باسكال، والأدلة النفعية الذرائعية.
أما الدليل الأنطولوجي فهو دليل نستطيع أن نطلق عليه دليلا ذاتيًّا، أي أن الله سبحانه وتعالى هو دليل نفسه، إذ في الدليل الأنطولوجي يتم الانتقال من مجرد تصور مفهوم الإله، إلى دعوى أن المفهوم يكفي عن طريق التحليل المنطقي للدلالة على الوجود الخارجي لله تعالى.
يقول ميل ثومبسون في بيان مفهوم الدليل الوجودي: إن الدليل الوجودي لا ينبني على ملاحظة العالم، أو أي شاهد خارجي، بل ببساطة على تعريف كلمة الإله، يدعي أنه من تعريفها تشير كلمة الإله إلى شيء ضروري الوجود.
ويقول جراهام أوبي: «إن الدليل الوجودي الناجح ينبغي أن يبين أن هناك جدوى للنظر المنطقي -تثبت قبليا باستعمال آليات منطقية قريبة- في أن الله يوجد». وأضاف: «إن الحجة الوجودية لا تستعمل أكثر من أساليب منطقية محضة معتمدة على حقائق معروفة قبليا، بأي أدوات معقولة مقربة للبرهان على المطلوب، فينبغي أن تكون الحجة الوجودية معتمدة على تعقل منطقي بحت لتأسيس صحة وجود الإله».
وهذا الدليل كما أشرنا له تقريرات، وهو دليل تكاثرت عليه المناقشات، واهتم كثير من فلاسفة الغرب محاولة منهم لمنع الاعتراضات الكثيرة عليه، ومن المعاصرين ألفن بلانتنجا والرياضي الشهير كيرت جودل الذي تكلمنا عنه مُسبقًا.
لكننا نقتصر في كلامنا هنا على تقرير الحجة من كلام أنسلم وكان تقريره على النحو التالي:
إنه من الأعظم للشيء أن يوجد في الذهن وفي الواقع أيضا، من أن يوجد في الذهن فقط.
الإله يعني «ما لا يمكن فرض شيء أعظم منه».
افرض أن الإله يوجد ذهنًا لا واقعيًّا.
إذن يمكن فرض ما هو أعظم من الإله. (وهو ما له جميع صفات الإله المفروضة ذهنًا، ولكنه موجود واقعيًّا أيضًا).
ولكن هذا محال (لأن الإله ما لا يمكن فرض شيء أعظم منه).
ينتج: الله موجود ذهنًا وواقعيًّا([6]).
وللدليل تقريرات أخرى آخرها ما عرضه كيرت جودل في هذا الدليل لكنه مكتوب بصورة منطقية رياضية تحتاج إلى تعمق في فهم المنطق الرمزي، والمنطق الموجه، وهذه صورته التي كتبها عليها الرياضي جودل:
فهذا الدليل يتألف من AX أي مسلمات، تنطلق لتكوين النظرية Th (تقع في مقابلة القطعية) ثم تتوالى النظريات حتى نصل إلى النتيجة الأخيرة التي تنسب الوجود الإلهي إلى الوجوب العقلي، ومعناه في المنطق الرياضي أنه في كل العوالم الممكنة وجود الله سبحانه وتعالى واجب فيها جميعا([7]).
على أية حال فإن هذا الدليل يذكرنا بكلام السادة الصوفية في الاستدلال، وهو أشبه بهم، كما قال ابن عطاء الله السكندري: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟
يقول شيخ الإسلام الشرقاوي: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده أي ثبوته وتحققه خارجًا مفتقر إليك، وهو المكونات، فإنها في ذاتها عدم محض كما مرَّ.
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟! فإن الدليل يكون أظهر من المدلول حتى يستدل به عليه، فأصحاب النظر والاستدلال حالهم قبيح بالنسبة إلى أصحاب الشهود والعيان، ويقال لهم عوام بالنسبة لهم.
قال الشيخ: ثم ترقى في نفي الاستدلال بقوله: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار أي المكونات هي التي توصل إليك؟! أي إلى معرفتك، ولذا قال مريد لشيخه: يا أستاذ أين الله؟ فقال ويحك: وهل يطلب مع العين أين؟! اهـ([8]).
وهو الدَّليل الذي يعتمد على ملاحظة الإمكان في هذا العالم بالتأمل فيه من جهات معينة كالحركة أو التركيب أو غيرهما، ليتم الانتقال بعد ذلك بإثبات حاجة هذا الممكن إلى وجود علة واجبة توجب وجوده، فإن الممكن يستحيل وجوده بنفسه عقلا.
وتم دراسة المقدمات التي يعتمد عليها الدليل، والإشارة إلى وجوه النقد الموجهة عليه مع مناقشتها، لتفحص مدى سلامتها، وهذا الدليل هو الدليل الأقدم والأكثر شهرة عند الفلاسفة، ولكن المتكلمين مع موافقتهم للفلاسفة على كثير من المقدمات والشروط، إلا أنهم زادوا عليهم وضبطوا وجه دلالة الدليل؛ لكي يصبح موافقًا لمقصودهم، وانتقدوا بعض الجهات التي قيد بها الفلاسفة الدليل.
والحاصل أن الدليل المعتمد على الإمكان والوجوب دليل سليم، ولكنه لا يكفي لإثبات الصانع المختار على طريقة الفلاسفة؛ بل لا بد من إضافة بعض المقدمات التي ذكرها المتكلمون للوصول إلى ذلك([9]).
يقول ابن سينا في تقرير هذا الدليل منتقلا من ملاحظة وجود ما حاصل وثابت في الخارج إلى إثبات ضرورة ثبوت وجود واجب لذاته:
لا شك أن هنا وجودًا، وكل وجود فإما واجب وإما ممكن.
فإن كان واجبًا فقد صح وجود الواجب، وهو المطلوب.
وإن كان ممكنا فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود([10]).
يقول الأبهري: فصل في إثبات الواجب لذاته، وهو الذي إذا اعتبر من حيث هو هو، لا يكون قابلًا للعدم وبرهانه أن نقول:
إن لم يمكن في الوجود موجود واجب لذاته يلزم منه المحال؛ لأن الموجودات بأسرها حينئذ تكون جملة مركبة من آحاد، وكل واحد منها ممكن لذاته، فتحتاج إلى عِلةٍ موجدة خارجة، والعلم به بديهي، والموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته، فيلزم وجود واجب الوجود، وعلى تقدير عدمه وهو محال، فوجوده واجب([11]).
وعبارة العضد الإيجي مع عبارة السيد الشريف: المسلك الثاني للحكماء وهو إن كان في الواقع موجودًا مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات وأحوالها، وهذه مقدمة تشهد بها كل فطرة، فإن كان ذلك الموجود واجبًا؛ فذاك هو المطلوب، وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى الواجب، وإلا يلزم الدور أو التسلسل وفي هذا المسلك طرح لمؤنات كثيرة([12]).
وهو الدليل الذي يتم فيه الانتقال من إثبات حدوث العالم، بطرق عدة إلى البرهان على أن هذا العالم المحدث له محدث صانع، ويمكن أن يقال إنه الدليل الأكثر أهمية المعتمد بين أكثر المتكلمين، وكان ينظر إليه باستهانة من قبل كثير من الفلاسفة عبر العصور، إلا أنه نتيجة لاكتسابه جهات قوة من بعض البحوث الفيزيائية والكونية في العقود المتأخرة، تبين أن هذا الدليل ربما يكون من أقوى الأدلة التي يجب الاعتماد عليها، لموافقة مبادئه ومقدماته كثيرًا من نتائج العلوم الفيزيائية، ولذلك فقد اكتسب الدليل أنصارًا في الغرب لم يكن يتوقع من قبل أن يرجحوه، ولا أن يصرحوا بمكانة المتكلمين؛ لأنهم الذين انتصروا للدليل رغم تعصب الفلاسفة بمختلف اتجاهاتهم ضده، وتصريحهم بأنه لا يصمد أمام النقد الفلسفي.
وقد ظهر دليل الحدوث عند المتكلمين الأوائل، ثم نقحه من جاء بعدهم وعدلوا عليه، وقد بين الإمام الأشعري الطرق الكلية بإجمال فقال في رسالة «استحسان الخوض في علم الكلام» في صدد بيان مشروعية علم الكلام والبحث في مسائله:
أما الحركة والسكون والكلام فيهما فأصلهما موجود في القرآن، وهما يدلان على التوحيد وكذلك الاجتماع والافتراق، قال الله تعالى مخبرًا عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه في قصة أفول الكوكب والشمس والقمر، وتحريكهما من مكان إلى مكان، ما دل على أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك وإن جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله([13]).
هو الدليل المعروف في الأدبيات الخاصة بعلوم العقائد كعلم الكلام الإسلامي أو اللاهوت اليهودي والنصراني بدليل العناية، أو الدليل الغائي، أو دليل النظم، وقد اتخذ في أواخر القرن العشرين اسمًا مُعاصرًا بإيحاءات علمية أكثر منها فلسفية، وهو دليل التصميم الذكي.
وقد اعتمد توما الأكويني هذا البرهان خامس أدلته التي طرحها على وجود الله تعالى في كتابه الخلاصة اللاهوتية، وفي سنة 1802م نشر اللاهوتي الإنجليزي ويليام بيلي كتابه المشهور اللاهوت الطبيعي ويقصد باللاهوت الطبيعي دراسة خطة الله في الخلق عبر دراسة وتأمل عالم الخليقة، وضرب له مثلا قدر له أن يصيب حظًّا كبيرًا من الشهرة والذيوع، إنه مثال الساعة التي يكفي تأمل أجزائها في دقتها وترتيبها وتآزرها في أداء عملها في الدلالة على استحالة أن تكون تكونت بطريق الصدفة المحضة، وأنه لا مناص من وقوف صانع ذكي وراء صنعها وتركيبها، وقد ظل رجال الدين -من المنافحين عن قضية الإيمان- إلى يومنا هذا يرددون التمثيل بهذا المثال، وانضم إليهم مؤخرًا المدافعون عن برهان التصميم الذكي.
الشكل المنطقي لبرهان النظم:
إن هذا البرهان من النَّاحية الشَّكليَّةِ هو استدلال قياسي بمقدمتين صغرى وكبرى وثالثة وسطى ونتيجة.
فأما مقدمته الصغرى فحسية؛ أي يتكفل الحس بتزويدنا بها، حتى إن ديفيد هيوم سقط سقوطًا مدويا في كتابه (محاورات في الدين الطبيعي) حين ظن أن هذا الدليل من أدلة الحس التي يسند إلى العلم الطبيعي معالجتها، والبرهان الحسي هو الذي تكون جميع مقدماته مستمدة من الحس؛ أي مما يدرك بإحدى الحواس، والحال أن مقدمة هذا البرهان الصغرى وحدها هي المستمدة من الحس على نحو يسمح للعلم بالتدخل عبر تزويدنا بأمثلة ونماذج هي قوام مقدمتنا هذه.
والمقدمة الكبرى مقدمة عقلية فلسفية ليست حِسيَّة أو تَجريبيَّة أو استقرائية أو تمثيلية، نتتمثل في الاعتقاد بأن كلَّ نظام لا بد له من منظم.
والمقدمة الوسطى فهي المشترك بين المقدمتين الكبرى والصغرى وهي لفظة النظام.
وهكذا تكون كل المقدمات جاهزة لاستخلاص النتيجة، وهي أنه لا بد من منظم لما نرى من نظام في العالم الطبيعي([14]).
وهو يعتمد على ملاحظة خصائص أخلاقية في الجنس البشري، لا يعقل أن تحدث صدفة ولا بمجرد التطور، كما يقول المعارضون والمحتجون بالدليل ينتقلون من إثبات ذلك، إلى القول بأنه لا بد من وجود مسبب ومحدث لهذه الأخلاق في نفس الإنسان، ولا يمكن أن يكون الإنسان هو عينه الذي أوجدها، ولذلك فهي دليل صارخ على وجود الخالق المتقن الذي أودعها في نفوس الخلق.
فالدليل الأخلاقي يمكن الاعتماد عليه، ولكن يبدو أنه لا يتعدى أن يكون وجهًا من وجوده دليل النظام، أو الحدوث وذلك بحسب وجهة النظر التي يعالج بها([15]).
طريقة رهان باسكال المبنية على مبدأ الاحتياط، وذرائعية وليام جيمس المنبنية على مرجعية المنفعة الدنيوية وكذلك أخلاقية كانط الذين لا يصح الاعتماد عليها لإثبات وجود الله، فهي لا تفيد الدلالة على وجود الله، غايتها أن تبعث النفس على الاطمئنان إلى الاعتقاد الحق غير المتلبس بالشك والريب، فإن كان الاعتقاد حقًّا؛ فيمكن بعد ذلك أن يقال: والمؤمن لا يخسر كثيرًا في دنياه، بل أرباحه أكثر بكثير من مكاسبه، وبخصوص الدليل الأخلاقي يمكن أن يقال: إن استقامة النظم الاجتماعية لا تتم على أبلغ وجه إلا على الأنظمة الدينية؛ ولذلك فقد وجدنا نصوصًا كثيرة عند علماء المسلمين تعارض الاعتماد على الاحتياط والتلبس بالشك في العقيدة([16]).
شبهات الملحدين في إنكار الوجود الإلهي
ادعاء أن للكون بداية، لكن دون احتياجه لوجود خالق:
وهذا الفرض قائم على نفي مبدأ السببية، فبناء على هذا الفرض ليس كل موجود له بداية لا بد له من موجد ومصدر سابق عليه.
وسوف نقف وقفة مع هذا الفرض؛ لأنَّه فرض قائم على نقض أحد المبادئ العقلية التي اتفق العقلاء عليها، بخلاف الفرض الأول الذي أثبت العلم بطلانه، وبخلاف الفرض الثاني الذي عند تأمله يظهر أنه ليس سوى محض خيال لا يمكن إقامة الأدلة عليه، كما أنه وقوع في مغالطة التسلسل الباطل، أمّا هذا الفرض فيكثر الكلام حوله، حتى إننا نجد علماء الكلام المسلمين قد صاغوا مقولات تناقشه فيها حجج قوية وأدلة كافية ووافية وشافية.
والذي يهمنا الآن أن نوضح النقطة الثالثة، وهي أن كل موجود قد ظهر وانتقل من العدم لحيز الوجود لا بد أن يكون له مسبب ضرورةً، واستحالة أن تُوجِدَ الصُّدْفَة شيئًا موجودًا له خصائص وسمات واضحة، وأن وجود الحق سبحانه لا يحتاج لموجد ليس فيه تناقض.
ضرورية مبدأ السببية، واستحالة الترجيح بدون مرجح:
إن العقلاء قد أجمعوا ببرهان العقل أن كل حادث متحقق فلا بد أن يكون لوجوده سبب، وأن هذا المبدأ (السببية) ليس مختصًّا بحالة دون أخرى ولكنه مطرد في جميع الأسباب والمسببات؛ لأنها ضرورة عقليَّة وليست برهانًا مبنيًّا على المشاهدة والتجربة.
ولذا عبّر أرسطو منذ آلاف السنوات عن المبادئ العقلية الضرورية بأنها التي يدركها العقل ضرورة، وإليها تُردُّ أغلب قوانين المنطق والاستدلال وهي المبادئ الأربعة: مبدأ الهوية، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ السببية.
ومعنى هذا: إدراك أن لكل شيء حادث سببًا أمر ضروري في النفس، وسنذكر برهانًا عقليًّا على صحته واطِّراده بلا تخصيص.
الأحكام العقلية الثَّلاثة وأهمية دلالتها على قضية السببية:
لكن قبل أن ندلل عليه نقول في البداية: إن جميع الأمور والمفاهيم والأشكال المفروضة في الذهن لا تعدو بأن تتصف بأحد أوصاف ثلاثة، وهي: الوجوب والإمكان والاستحالة، وهي المعروفة بالأحكام العقلية الثلاثة.
فالواجب: هو الذي يقطع العقل باستحالة عدمه أو انتفائه.
والمستحيل: عكسه أي ما يقطع العقل باستحالة وجوده أو ثبوت تحققه.
والممكن: أو الجائز ما يقضي العقل بثبوته أو بانتفائه.
وهذا العالم بكل مكوناته وأجزائه لما حكمنا عليه بالحدوث واستحالة كونه أزليًّا كان يقع ضمن المفهوم الثالث وهو الممكن؛ لأننا لما أدركنا حدوثه وعلمنا أن لوجوده بداية علمنا أنه ليس ضروري الوجود دائما وأبدًا أي ليس واجبًا، وكذلك فإنه ليس مستحيلًا؛ لأنه لا يترتب على فرض وجوده محال، لأنه موجود ومتحقِّق بالفعل.
الأدلة على ضرورية قانون السببية العقلية:
بناء على مفهوم الممكن، وهو الذي يستوي طرفا الثبوت والانتفاء في حقه، نفهم أن ترجيح جانب الوجود على العدم يحتاج إلى مرجح، ويبعد ويستحيل أن يكون هذا الترجيح من تلقاء نفسه؛ لأن ماهية الممكن أي (هويته) تقضي بأنه يستوي جانبا الوجود والعدم فيه لذاته، ومن ثم فإننا نناقض مبدأ الهوية -أول المبادئ العقلية- إذا قلنا بـأن (الممكن) أوجد نفسه دون حَاجةٍ إلى مؤثر خارج عن ماهيته، ومختلف في حقيقة (الإمكان) الذي قد ثبت له.
وقد عَبَّر المتكلمون المسلمون عن المعنى السابق بعبارات عديدة وساقوا هذا الدليل مرارًا بوضوح في التدليل على وجوب احتياج المـمكن إلى المؤثر،
فـلا شك أن الممكن هو الذي تكون نسبة الوجود إليه كنسبة العدم إليه، وما دام يبقى هذا الاستواء، فإنه يمتنع حصول الرجحان، فثبت أن دخوله في الوجود موقوف على حصول الرجحان وهذا الرجحان لما حصل بعد أن لم يكن، كان أمرًا وجوديًّا ثبوتيًّا، والصفة الوجوديَّة الثابتة لا بد لها من موصوف موجود، ويمتنع أن يكون الموصوف بهذه الصفة الوجودية هو وجود ذلك الشيء؛ لأنا بينا أن حصول هذا الرجحان سابق على وجود الممكن، فثبت أنه ليس محل هذا الرجحان هو ذلك الممكن الذي هو الأثر، فلا بد من شيء آخر يغايره([17]).
فلو كان رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر غنيًّا عن المؤثر والمرجح لامتنع توقف هذا الرجحان في موضع من المواضع على حصول المؤثر والمرجح، وهذا الثاني باطل، فذلك المقدم أيضًا باطل.
أما بيان الملازمة: فهو أنه لما كان ذلك الرجحان غنيًّا عن المؤثر امتنع افتقاره إلى المؤثر في شيء من المواضع أصلًا؛ لأن مقتضيات الحقائق والماهيات لا تتغير ألبتة، فإذا كان رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر غنيًّا عن المؤثر من حيث هو هو، كان هذا الاستغناء حاصلًا في جميع الصور، والغني لذاته عن الشيء يمتنع أن يكون محتاجًا إليه؛ وأمَّا بيان أن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر قد يتوقف على حصول المؤثر؛ فلأن العلم البديهي حاصل بأن حصول الكتابة في هذا الكاغد -الورقة- تتوقف على حصول الكاتب، وعلى حصول كل ما لا بد منه في كونه كاتبًا، وكذا القول في القطع والضرب والكسر وأمثالها من الأفعال.
فهذه العبارات والبراهين كلها تُرد لأصل المبادئ العقلية القبلية وهي مبدأ الهُوية واستحالة التناقض، وتوضح أن مبدأ السببية حتم لازم لها، وأن وجوبه ضرورة عَقليَّة وليس مُبنيًّا على المشاهدة والتجربة.
ولمزيد إيضاح يقول الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: «لاريب أنه قد أتى حين من الدهر لم يكن هذا الكون شيئا مذكورًا، إذ كان العدم المطلق هو المنبسط في مكان الوجود اليوم، ومعنى ذلك أن كفة العدم كانت إذ ذاك هي الراجحة، وكان الأمر مستمرًّا على ذلك.
ثم إن الأمر انعكس بعدئذ فترجحت كفة الوجود على كفة العدم المطلق؛ فإن قلت إن العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد، فمعنى ذلك أن تقول برجحان كفة الوجود على كفة العدم وانعكاس الأمر الذي كان مستمرًّا دون وجود أي عامل لهذا الرجحان أو الانعكاس الطارئ، وهذا أمرٌ يَعرِفُ الإنسانُ محض بطلانه بمحض الفطرة»([18]). اهـ.
فبناء على ذلك لا يمكن لإنسان أن يتصوّر أن يمسك بيده ميزانًا ويترك الكفتين فيه بوزن واحد دون وجود أي ثُقْلٍ إضافي في إحداهما؛ وبينما الكفتان متساويتان إذا واحدة منهما ترجح والأخرى تطيش دون أي مؤثر خارجي يتصوره الذهن، فالمادَّة الأوَّلية التي وُجد منها الكون لا يمكن أن تكون أتت من العدم إلى الوجود أو رجَّحَتْ نفسها بنفسها؛ لأنَّ العلم يقول باستحالة تغير المادة أو الطاقة الموجودة في نظام مغلق Closed System واستحالة استحداثها من العدم، ما لم يوجد مؤثر خارجي من خارج هذا النظام يكون سببًا في التغيير أي لا بد أن يكون النظام مفتوحًا Open system.
يَرِدُ على ما سبق اعتراضان سنوردهما مع مناقشتهما والرد عليهما فيما يلي:
الاعتراض الأول: قد يقول قائل إن القائلين من المؤمنين والموحدين بحدوث العالم وإسناد خلقه إلى الله وهو الفاعل الأول يؤمنون أنه قد صار فاعلًا للعالم بعد أن لم يكن فاعلا له، وهذه الفاعلية أو الخلق ليست لسبب يرجحها عن وقت آخر كان يمكن فيه إيجاد العالم، فهم اتفقوا على حصول معنى الحدوث والخلق لا لسبب، وذلك يرجع بالتناقض على قولكم بإثبات وجود افتقار العالم لسبب وعلة.
الاعتراض الثاني: أنكم قلتم إن الممكن هو الذي يستوي فيه جانب الوجود والعدم لذاته ولا يترجح أحدهما على الآخر، وهذا معارض بالعدم إذ هو سابق على الوجود وراجح عليه بلا سبب.
مناقشة الاعتراض الأول والجواب عنه: إن دعوى أن هذه الفاعلية أو الخلق قد ترجحت دون سبب يخصص ذلك الوقت بإيجاد العالم دون غيره غير صحيح؛ لأنا نقول إن المخصص هاهنا هو الإرادة الإلهية القديمة، فهي التي خصصت إيجاد العالم وخلقه بتلك الفاعلية من حيز القوة والجواز إلى حيز الفعل والوقوع.
ثم قد يقول السائل: فلنكرر السؤال وهو أن الإرادة قد تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى تلك الإرادة، فإنكم إن تخلصتم عن خصوص الوقت بإسناده إلى الإرادة فكيف تتخلصوا من خصوص الصفات، أي لماذا خصصت الإرادة هذا الوقت بخصوصه دون ما عداه، فإن كان بإرادة أخرى لزم التسلسل وهو محال، وإذا لم يكن بإرادة أخرى عاد بالنقض عليكم في تخصيص هذه الفاعلية بتلك الإرادة.
والجواب: أن هذه الشبهة قد ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) وردها على أحسن ما يكون، فقال:
وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها، وقول القائل إنه لم تعلقت بها وأضدادها مثلها في الإمكان، هذا سؤال خطأ فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء على مثله.
فقول القائل لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله، كقول القائل لم أوجب العلم انكشاف المعلوم، فيقال: لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم، فقول القائل لم أوجب الانكشاف كقوله لم كان العلم علمًا، ولم كان الممكن ممكنًا، والواجب واجبًا، وهذا محال؛ لأن العلم علم لذاته، وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات، فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله.
فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله؟ كقوله: لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، وهو محال، وكل فريق مضطر إلى اثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة، فكان أقوم الفرق قيلًا وأهداهم سبيلًا من أثبت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة، بل قال: هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال([19]). اهـ.
هل سَبْقُ العدم على وجود العالم يناقض قانون السببية؟
مناقشة الاعتراض الثاني والجواب عنه: وهو قول القائل أن العدم ترجح جانبه في الزمان الأول على جانب الوجود بلا سبب أو مؤثر، فنقول: إن هذه مغالطة؛ لأن السبب والمؤثر الذي نوجب استناد الممكن إليه هو الذي له أثر، والعدم نفي محض فيمتنع استناده إلى المؤثر، وهذا ليس تناقضًا أو تخصيصًا في الأحكام العقلية كما لا يخفى، والله أعلم.
وقد أشار الإمام التفتازاني إلى هذا الاعتراض، فقال: لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج إليه في عدمه لتساويهما، واللازم باطل؛ لأن العدم نفي محض لا يصلح أثرًا.
والجواب: أن العدم إن لم يصلح أثرًا منعنا الملازمة لجواز أن يتساوى الوجود والعدم بالنظر إلى ذات الممكن لكن لا يحتاج العدم إلى المؤثر لعدم صلوحه لذلك بخلاف الوجود؛ فإن المقتضى فيه سالم عن المانع، وإن صلح أثرًا منعنا بطلان اللازم وهو ظاهر.
وتحقيقه أنه وإن كان نفيًا صرفًا؛ بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود العيني لكن ليس نفيًا صرفًا بمعنى ألا يضاف إلى ما يتصف بالوجود، بل هو عدم مضاف إلى الممكن الوجود فيستند إلى عدم علة وجوده بمعنى احتياجه إليه عند العقل حيث يُحكم بأنه إنما بقي على عدمه الأصلي أو اتصف بعدمه الطارئ بناءً على عدم علة وجوده مستمرًّا أو طارئًا([20]). اهـ.
ضرورة استناد خلق العالم إلى سبب وفاعل مختار:
إن نظرية الانفجار العظيم The Big Bang Theory هي أكثر النظريات قبولا لتفسير نشأة الكون؛ حيث تؤكد أن الكون قد نشأ نتيجة لانفجار هائل في نقطة مفردة Singularity، وثبت علميًّا أن الكون له بداية ترجع إلى 13.7 مليار سنة، كما أن العلم قد طرح مفهومًا شديد الوضوح والدلالة: وهو أن الكون نشأ من عدم؛ فالفيزيائي إدوارد تريون Edward Tryon أستاذ الفيزياء في جامعة هنتر في مانهاتن: أكَّد أن طاقة الكون عند بدايته كانت صفرا، لأن قوة الجاذبيَّة الممسكة بالكون تمثل بالسالب في المعادلات الفيزيائية؛ إذ أنها تعمل في اتجاه معاكس للقوى الأخرى كالقوة الطاردة المركزية التي تدفع بالإلكترونات بعيدًا عن النواة، وتدفع بالكواكب بعيدًا عن شموسها، كذلك إذا عادلنا الشحنات الموجبة بالشحنات السالبة لذرات الكون أصبحت طاقة الكون صفرًا([21]).
والسؤال المطروح وسيظل مطروحًا دائما: كيف تعطي طاقة مقدارها صفر، كل ما في الوجود حولنا من بناء وطاقة وإبهار وجمال؟
فالمتدينون يعتقدون جَزمًا أن الله هو الذي أنشأ الكون كله من لا شيء بقدرة تامة وإرادة، تبعًا لما قدمناه من وجوب افتقار الممكن والحادث إلى فاعل واجب، وسبب أول قديم.
يقول الفيلسوف واللاهوتي المسيحي الأمريكي ويليام لان كريج في كتابهThe Cosmological Argument: «إذا كان الشيء فعلًا يدخل في الوجود بلا سبب، فإنه يصبح من المتعذر بيان كيف أن أي شيء وكل شيء لم يدخل في الوجود بلا سبب، أي: لِمَاذا وُجِدَ هذا العالم بالذات دون غيره من الممكنات؟». اهـ.
وقال أيضًا: «حينما نقول كل حادث له سبب:
Whatever begins to exist has a cause
فهذه المقدمة تبدو بوضوح صحيحة أكثر من نقيضها، فإنه من المتأصل في الحسِّ الفلسفي أن الحادث لا يدخل في الوجود بلا سبب، فإن مثل هذه الدعوى ترجع إلى ادعاء نوع من السحر!». اهـ.
فالذي لا يؤمن بوجود خالق، مضطر إلى قبول هذه المقدمة خاصة إن كان مشتغلًا في العلوم الطبيعية.
اعتراضات الفيلسوف (ديفيد هيوم) والجواب عليها:
والذين لا يُسلمون أن السببية مبدأ أولي، يدَّعون أنه لا يتوقف فهم الأثر على فهم السبب، وأشهر من انتصر للقول بنفي السببية الفيلسوف الشهير (ديفيد هيوم)؛ حيث نفى أن يكون مبدأ السببية قائم على أساس الضرورة العَقليَّة، وأن السببية ليست إلا انتظامًا معينًا لتسلسل ما من الملاحظات، أما الانتقال إلى حَتميَّة هذا الارتباط فيما سيكون لا ينبغي أن يكون مَبنيًّا على أسباب واقعية أو ماضية، فهو يقول مثلًا: لو سلمنا السببية فيما شاهدنا من أجزاء العالم، فلا يمكن تطبيقه على العالم كله لأنه لم يقع تحت إدراكنا.
والجواب: أننا قدمنا أن مفهوم الارتباط السببي بين الأثر والمؤثر هو ضرورة عقلية يلزم عن نفيها نفي الهوية، وما دام كذلك فإنه يصح لنا أن نطبقه على كل ما ثبت حدوثه وإمكانه كالعالم.
كما أننا نقول: إن العَقلَ يجرد المحسوس من خصوصياته، فالعقل يتناول قضايا كلية تكون أعم من المحسوس بحيث تصدق عليه وعلى غيره، ويجعلها مقدمات لقياساته الصادقة على الشاهد والغائب.
فحينما نقول: إن كلَّ جسمين لا بد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر، فهذه قضية كلية تلاحظ من تجريد المعنى الحسي المشاهد للجسم، ولا يلزم لصدق هذا الحكم مشاهدة كل ما يصدق عليه وصف الجسمية، فكذلك نقول: إن قانون السَّببية لازم لماهية الممكن دون النظر ومشاهدة كل جزء من أجزاء العالم بخصوصه.
دعوى مغالطة إعطاء الكل حكم الجزء (مغالطة التركيب) والرد عليها:
وهذا الاعتراض قد وجهه هيوم وكثير من القائلين بنفي السببية، وادعوا أن فيه مغالطة التركيب، وهي إعطاء المجموع حكم الأجزاء؛ لأننا إن حكمنا مثلًا على مادة كالكربون بأنها مادة غير ضارة، والأكسجين غاز غير ضار، فلا يلزم أن ثاني أكسيد الكربون وهو المركب المتكون منهما أن يكون غير ضار؛ لأن الحكم الذي تأخذه الأجزاء وهي مركبة ليس بالضرورة أن يكون نفس الحكم الثابت لأجزائها مفردة.
والجواب عن هذا الاعتراض: أن الشرط في مغالطة التركيب وهي إعطاء المجموع حكم الأجزاء أن تكون الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمجموع المركب مختلفة ومتباينة عن حقيقة الجزء أو الفرد، كما لو قيل إن الواحد فرد والثلاثة فرد فيلزم أن يكون المجموع المكون منهما فَردًا وهو الأربعة، فهذا هو وجه الغلط؛ لأن الهيئة الاجتماعية المتركبة من مجموع الأفراد مختلفة عن أجزائه، لكن أن يقال: إن كلَّ مجموع لا يأخذ حكم الأجزاء أو الأفراد المكونة له مُطلقًا فغير صحيح ولا يلزم؛ إذ قد يأخذ المجموع حكم الأجزاء إن تساويا في الماهيَّةِ أو الهيئة الاجتماعية: كأن نقول مثلا، كل جزء من أجزاء العالم حادث ومخلوق فيلزم أن يكون العالم بأسره مخلوق؛ لأن إمكان الماهية قد ثبت للعالم كله بإقامة الدليل على استحالة القِدم والتسلسل.
وقد تقرر أن علة المجموع هي علة لكل واحد من أجزائه؛ لأن المؤثر إذا كان مؤثرًا في مجموع الآحاد مع الهيئة الاجتماعية فقد أثر في كل جزء من أجزائه، ولو لم يؤثر في كل جزء من أجزائه جاز انتفاء ذلك الجزء، وعليه جاز انتفاء المجموع وهو وباطل.
فكرة السفر عبر الزمن وهل تبطل السببية؟
أما من يرددون بأن السَّفر عبر الزمن ينقض السَّببية إذ يمكننا السفر للماضي أو المستقبل، وعليه فيجوز وجود السبب قبل المسبب.
فنقول: إن فَرضيَّة السفر عبر الزمنTime Travel حسب النظرية النسبية العامة لأينشتاين مبنية على اعتبار الزمان ذا وجود نسبي، فالزمن يسري في الموجودات بسرعات ونسب متفاوتة؛ وذلك حسب اختلاف حقول الجاذبية، وفي الحقل الأعمق يتباطأ الزمان.
ونحن نعتقد أن الزمن ليس له وجود نسبي، بل هو مفهوم اعتباري يلاحظ من اشتقاق التغير والحدوث في أجسام العالم، أي هو دالة حسابية بين متغيرين، وعليه فالانتقال عبر الزمن مستحيلٌ عقلًا، ومعظم العلماء لا يعتقدون بجوازه، ولا توجد تجربة واحدة تدلل عليه.
يقول الدكتور جواد بشارة في كتاب: (الكون المرئي بين الفيزياء والميتافيزيقا):
أضافت النسبية الزمن كبُعْدٍ رابع بالإضافة إلى الأبعاد المكانية الثلاثة، تقول إن الزمان والمكان مرتبطان معًا ولا يمكن أن يوجد أحدهما بَمعزلٍ عن الآخر، إننا نستطيع أن نتحرك في الأبعاد المكانية بكل حرية، ويمكننا ركوب آلات مثل الطائرة أو الصاروخ التي تنقلنا في البعد المكاني الثالث (الارتفاع) ومن هذه الفكرة البسيطة عن الأبعاد يمكن أن ننتقل عبر الزمن بهذه الصورة، لكن النظر إلى ما سبق يعد مفهومًا كلاسيكيًّا فحسب؛ حيث يفترض أن الزمن مقياس مطلق لسرعة حركة هذه الأجسام، وقد توصلت باحثة ألمانية معاصرة إلى إثبات عدم إمكانية السفر عبر الزمان إلى الماضي، وذلك من خلال دراستها لنظرية أينشتاين بواسطة أي وسيلة تقنية سواء كانت خيالية أو افتراضية تسمى آلة الزمان([22]). اهـ.
اعتراض للفيزيائي الأشهر ستيفن هوكنج والرد عليه:
كذلك من المفاهيم التي يقدمها ستيفن هوكينج، للتدليل على جواز أن ينشأ العالم من العدم دون احتياج إلى الخالق أو الفاعل، مفهوم (الزمن التخيلي) Imaginary Time، وهو تطبيق لمفهوم الرقم التخيلي، ومعناه أننا إذا بحثنا عن الجذر التربيعي لرقم مثل (-4) فلن نجد رقما حقيقيا إذ أن ( -2 × -2 = 4) لذلك قام هوكنج بوضع رمز X يشير به إلى هذا الرقم الذي لا وجود له، ووضع X في معادلاته الخاصة بحساب الزمن، فنتج زمن تخيلي، عندما استخدمه هوكنج في حساباته أزال الحاجة إلى موجد أول.
وهذه مغالطة واضحة لأن مفهوم الأرقام التخيلية إذا كان صحيحًا من الناحية الرياضية، فلا اعتبار له من الناحية التطبيقية، وهذا أشبه بمفهوم -الما لانهاية ∞ في الرياضيات، فإنه وإن كان مستخدمًا رياضيًّا، لكن تطبيق الما لانهاية تطبيقيًّا على الموجودات يستحيل عمليًّا وفيزيائيًّا كما برهن العلماء.
يقول سير هيربرت دنجل Sir Herbert Dingle رئيس الجمعية الفلكية الملكية بإنجلترا: «أنه إذا كان مفهوم الأرقام التخيلية صحيحا من الناحية الرياضية، فلا اعتبار له من الناحية التطبيقية، ويستدل على ذلك بمثال يعرفه كل التلاميذ الدارسين للرياضيات: وهو إذا كان عدد الرجال المطلوبين لوظيفة ما هو (x)، وكانت x في بعض المعادلات: موجبة أو سالبة، عددًا صحيحًا أو كسرًا، عددًا تخيليًّا أو مركبًا أو صفرًا أو حتى لا نهاية، أو أي شكل من الأشكال التي ولدتها عقول الرياضيين، فإننا بالتأكيد سنعتبر x (عدد الموظفين المطلوبين) رقما صحيحًا موجبًا، ونرفض باقي الاحتمالات.
فالرياضيات لا تستطيع وحدها الاختيار بين البدائل في المثال السابق، وسنعتمد على المنطق العقلي والخبرة والتجربة. اهـ.
ومن ثمّ نقول: إن الزمن التخيلي الذي نشأ عن وضع الأرقام التخيلية في معادلات هوكينج لا اعتبار له، وسينقلب إلى زمن حقيقي إذا استبدل الرقم التخيلي برقم حقيقي، عندها ستظهر الحاجة إلى (المسبب الأول).
هل الفيزياء الكمية تثبت نقض السببية وتُجَوِّزُ وجود موجود من لا شيء؟
وأما ما يتعلق بنظرية تذبذب الفراغ الكمومي quantum vacuum fluctuations، وظهور الجسيمات الافتراضية في المستوى تحت الذري بلا سبب، وأنه ينافي السببية:
فالمقصود بهذا الكلام هو محاولة تفسير من بعض الفيزيائيين الملحدين بجواز وجود شيء لا من شيء أو بدون سبب ومؤثر، وحقيقة الأمر أن فيزياء الكم هي تصف العلاقات ما دون الذرية التي لا تستطيع ميكانيكا نيوتن وصفها؛ لأن للجسيمات دون الذرية خصائص ومواصفات مناقضة ومختلفة عن خصائص الجسم العادي.
وهؤلاء يقولون إن الجسيمات الافتراضيةVirtual Particles تنشأ من مكان فارغ؛ إذ الشيء يمكن أن يوجد الشيء من العدم وبلا سبب.
والجسيمات الافتراضية هي جسيمات تنشأ خلال فترة قليلة جدًّا من الزمن في موقع ما، ثم تختفي لتظهر في مكانٍ آخر وهي في الحقيقة تنحل من إشعاعات كهرومغناطيسية عند انخفاض الضغط عند التفريغ.
وينبغي التوضيح أنه ليس هناك مشكلة في القول بأن الأجسام الافتراضية بأنواعها الكثيرة المتعددة قد وجدت من الطاقة سواء كانت هذه الطاقة موجبة او سالبة.
فيبقى السؤال هل كان في هذا الفراغ طاقة أم كان فارغًا حقًّا وكان عدمًا محضًا؟
وفقًا لمبدأ عدم الدقة لهايزنبرج؛ فإن قيمة مجال معين ومعدل تغيره يلعبان نفس الدور مثل الموضع والسرعة لجسم معين؛ حيث كلما كان أحدهما أكثر دقة في التحديد كان الآخرُ أقل دقة في التحديد، ونستفيد من هذا فائدة مهمة وهي أنه لا يوجد شيء اسمه فضاء فارغ؛ وذلك بسبب أن الفضاء الخاوي يعني أن كلا من قيمة المجال ومعدل تغيره يساويان صفرًا بالضبط (إذا كان معدل تغير المجال ليس صفرًا بالضبط الفضاء لن يبقى فارغًا)، ومبدأ عدم الدقة لا يسمح لقيمة كلا من المجال ومعدل تغيره أن يكونا محددين معًا؛ ولذلك فإن الفضاء لن يكون فارغًا أبدًا ولكنه سيبقى في الحالة الدنيا من الطاقة التي تسمى فراغ.
وبناءً على الطريقة التقليدية غير الحتمية: فإن الجسيمات لا تأتي إلى الوجود من غير شيء كما يقولون، بل إنها تظهر كتذبذب لحظي للطاقة الكامنة في الفراغ الكمي Quantum vacuum، مما يشكل سَببًا غير محدَّد لنشأتها.
ولذلك فلا حجة لمن يقول: إنَّ الفيزياء الكمية أثبتت أنَّ الأشياء تظهر في الوجود بلا سببٍ، فضلًا عن القول بأن العالم كله ظهر فجأة إلى حيز الكون (الوجود) من لا شيء حرفيًّا!
ونحن إن فرضنا حالة حدثت وعلمنا أنه ليس لها سبب فيزيائي، وبالضرورة المنطقية لها سبب، إذن: لها سبب غير فيزيائي، وهذا الذي نثبته نحن (المؤمنين) انتهاء؛ لأنَّ عدم معرفة سبب الوجود لا ينفي الوجود.
فالسببية تعني افتقار المخلوقات لأسباب تحقق ماصادقاتها؛ أي وجودها الخارجي. وهذا مبدأ ضروري عقلي فطري، وتعني أن لكل مخلوق خصائص وصفات معينة ناشئة عن أسباب موجدة لها غير مرتبطة بزمان أو مكان، وهو مفتقر ومحتاج لهذه الخصائص والصفات؛ لأنها تمثل وتشكل وجوده وبدونها يصبح عدمًا، والإنسان العاقل يبحث عن مصدر هذه الصفات والخصائص فيجد أنها محكومة بقوانين وشرائط أي أسباب إذا تخلفت تتلاشى معها المخلوقات.
وإذا نظرنا إلى علم الفيزياء نجده معني بالبحث عن القوانين والشرائط التي تحدد خصائص، وصفات الظواهر المختلفة في الكون التي تلازمها تلازما خارجيًّا مطردًا لا يتخلف عادة، وبدون هذه القوانين والشرائط لا وجود لهذه الظواهر؛ لأن وجودها تابع لتوافر الشروط والقوانين والعكس صحيح.
ومن هنا نعلم أنه لم ولن يوجد موجود يتصف بصفات دون أن يكون لها قانون يحكمها، وإلا لما استقر نظام، ولا قانون، ولا امتازت الأشياء بعضها عن بعض بالخصائص المميزة لكل منها، ولانهدمت القوانين الفيزيائية التي هي قوام العلوم التجريبية، لكن هناك من يشغب على هذا المبدأ الفطري العقلي، مستندا إلى أدلة يظن أن قانون السببية ينهدم عندها. منها، ميكانيكا الكم؛ وهي قوانين جديدة تسري على الأجزاء الصغيرة في الكون، مثل الذرة والإلكترون والبروتون. وأصبحت القوانين التي تحكم الظواهر فائقة الصغر وفائقة السرعة يطلق عليها ميكانيكا الكم (quantum mechanics) بخلاف ما كان سائدًا قبل ذلك من أن قوانين نيوتن، أو الفيزياء القديمة المعروفة تحكم أجزاء الكون كله؛ سواء أكان مجرة أم ذرة، وعلى الرغم من أن لميكانيكا الكم استخدامات في مجالات علمية عديدة مثل الليزر، وأجهزة MRI، والترانزستور، وغيرها من مجالات الحساب الكمومي (Quantum computing)، مثل نظرية التشابك الكمومي Quantum entanglement، ونظرية النفق الكمومي quantum tunnel وغيرها من المجالات العلمية الهامة. إلا أن لها ظواهر غريبة إلى الآن لا يوجد تفسير لها، ومنها، الطبيعة المزدوجة للإلكترونات والفوتونات حيث ادعى البعض أن هذا يلغي مبدأ السببية.
وبيان ذلك أن ميكانيكا الكم أثبتت أن للإلكترونات والفوتونات طبيعة موجية وجسمية في نفس الوقت فيما يعرف بمثنوية الموجة والجسيم (wave-particle duality)، وهذا يعدُّ تناقضًا؛ لأن الجسم يكون محددًا ومتحيزًا في مكان والموجة منتشرة غير محددة وغير متحيزة في مكان.
وذلك من خلال تجربة الشق المزدوجdouble slits experiment)) وهي إحدى أهم التجارب الفيزيائية التي أسهمت في البحث في طبيعة الضوء وإثبات طبيعته الموجية، حيث أثبتت أن للإلكترونات خصائص مزدوجة من خصائص الجسيمات والموجات، وهذه التجربة كما جاء في كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم (ص 71) وما بعدها تكون بإحضار لوحة بها فتحتان ووضعت خلفه حائلا أو خلفية واضحة ثم وضعت أمام اللوح مصدر ضوئيًّا، فإن كان الضوء موجة فسوف يقسمها اللوح إلى موجتين منفصلتين ثم تلتحمان مباشرة بعد مرورهما من الفتحتين، لكن هذا الالتحام لن يجعلهما موجة واحدة مرة أخرى، وإنما سيجعلهما موجتين متداخلتين فيما يعرف بتداخل الموجات أو حيود الموجات Interference pattern مما يجعل الضوء على الخلفية في النهاية يقوى في بعض المواضع التي تقوي فيها الموجتان بعضهما بعضًا، ويضعف الضوء في المواضع الأخرى التي تضعف فيها الموجتان بعضهما بعضًا، وسوف يغطي هذا التداخل الخلفية أو جزءًا كبيرًا منها، ولن يكون حجمه متطابقًا مع حجم الفتحتين على اللوح.
وهذا ثابت ومتوقع في حق الضوء فعلا ولكن هناك ما يثبت أن الضوء يتصرف كجسيمات منفصلة أيضًا، وهي ظاهرة التأثير الكهروضوئی Photoelectric effect))، لكن لو استبدلنا بالمصدر الضوئي في تجربة الشقين مصدر يطلق الإلكترونات بدلا من الأشعة الضوئية المتوقع هو أن نرى على الخلفية خطين متطابقين مع حجم الفتحتين على اللوح.
وليس من المتوقع أبدًا أن تكون النتيجة على الخلفية هي تداخل الإلكترونات أو حيودها كما تفعل الموجات؛ لأن المفترض بالإلكترونات أنها جسيمات تتكون منها المواد من حولنا، وأنها ليست موجات تنتشر في الفضاء. لكن الصدمة الكبيرة هي أن النتيجة ستكون على الخَلفيَّةِ مطابقة السلوك الموجات؛ حيث ستغطي الخلفية تمامًا بشكل الحيود أو التداخل الموجي، فتكون أقسامًا من المناطق الداكنة التي تتركز فيها الإلكترونات والمناطق الفاتحة التي تخف فيها الإلكترونات؛ تمامًا كأنها موجات ضوئية.
وهذا يثبت أن الإلكترونات لها خصائص موجيَّة وجسميَّة كما للفوتونات خصائص موجية وجسمية، وهذه عجيبة من العجائب الكبرى، لكن إليك ما هو أكبر من ذلك، إذا أغلقت إحدى الفتحتين مما يجعلنا نعلم ونحدد المكان الذي سيمر منه الإلكترون؛ فسيختفي الحيود وستحصل على الأسلوب الجسيمي مرة أخرى، وسيتكون بالإلكترونات شكل مطابق لفتحة اللوح!! والأمر نفسه سيحدث لو فتحت الفتحتين لكن وضعت كاشفا على إحداهما يحدد مكان مرور الإلكترونات، فسيتكون شكلان مطابقان للفتحتين من الإلكترونات على الخلفية، وهذه الظاهرة العجيبة تعرف بمشكلة القياس Measurement problem وهي أحد الألغاز التي لم تحل إلى الآن في فيزياء الكم، وهي تعني أن القياس هو الذي يعطي للعالم الكمي وجوده المحدد الذي نتعامل معه كنتائج، وهنا تختفي الطبيعة الاحتمالية التي يعيشها العالم الكمي، أي أن الإلكترون انتهت ازدواجيته كموجة وجسيم بسبب قياسه وتحديد مكانه. أي أن الإلكترون يتصرف مثل الموجات لكن عند محاولة قياسه ورصده نجده يتصرف مثل الجسيمات في نفس الوقت، وتوقف العلم عن السبب الموجود في القياس الذي يجعل الإلكترون يغير سلوكه الموجي إلى الجسيمي عند رصده وقياسه.
وقد اختلف تفسير علماء العلوم التجريبية تجاه هذه الطبيعة المزدوجة ما بين قائل بالحتمية، وهي أن كل شيء في الكون خاضع لتسلسل منطقي سببي سواء علمناه أو أن هناك ثمة متغيرات خفية Hidden variables يمكن الوصول إليها في يوم من الأيام لاستكمال هذه الصورة الضبابية، أمثال شرودينجر، ديبرولي، أينشتاين ولطالما أن الحتمية مرتبطة ارتباطًا شديدًا بالزمن والتحديد كانت على النقيض من ميكانيكا الكم. وبين فريق آخر يتبنى الاحتمالية وعدم التحديد مثل هيزنبيرج الذي وضع قانون عدم الدقة وهو قانون رياضي مفاده أنه يستحيل قياس الكميات المقترنة وطبق هذه الحقيقة الرياضية المنطقية على الطبيعة المزدوجة للإلكترونات والفوتونات، أي أن سبب عدم دقة تحديد طبيعة الإلكترونات والفوتونات هي الطبيعة المزدوجة. أي أن هذا الفرع من ميكانيكا الكم ألغى الحتمية (Determinism)عند البعض ولم يلغ السببية (Causality)؛ أي أن القانون لا ينص على أن الإلكترون ليس لحركته سبب وإنما ينص على أنه من الصعب التنبؤ ومعرفة سرعته عند تحديد مكانه؛ لأنه يغير حركته وقتها إلى حركة الجسيم؛ لأن السببية ليس لها علاقة بطبيعة القوانين التي تحكم الظواهر فهي داخلة في الفيزياء الكلاسيكية والحديثة وميكانيكا الكم.
والفرق بين الحتمية والسببية يشرحه لنا العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء ماكس بورن أحد مؤسسي ميكانيكا الكم في كتابه: الفلسفة الطبيعية للسبب والصدفة (Natural Philosophy Of Cause And Chance)، فقد عقد فصلًا في أول الكتاب بعنوان السببية والحتمية( Causality and Determinism): يفرق فيه بين معنى الحتمية التي هدمتها ميكانيكا الكم، وبين معنى السببية يقول “القول بأن الفيزياء قد تخلت عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة، صحيح أن الفيزياء الحديثة قد تخلت عن بعض الأفكار التقليدية وعدلت فيها، لكن لو توقفت الفيزياء عن البحث عن أسباب الظواهر فلن تصبح حينها علمًا”.
ثم يضع تعريفًا للحتمية وآخر للسببية فيقول:
الحتمية تفترض أن الأحداث التي وقعت في أزمنة مختلفة، مرتبطة بواسطة القوانين وبالتالي فيمكن عمل تنبؤات في الماضي والمستقبل بمعرفة الحاضر، وفقًا لهذه الصياغة، فإن الحتمية تضاد فكرة القدر الدينية لأنه إذا كان يمكننا الكشف التام عن الماضي والمستقبل فكتاب القدر سيصبح معلومًا لنا، ولن يكون الله وحده المختص بهذا العلم.
السببية تفترض أنه وفقًا للقوانين يكون حدوث الكيان «ب» الذي ينتمي إلى فئة معينة، معتمدًا على حدوث الكيان «أ» الذي ينتمي إلى فئة أخرى. بحيث يكون المقصود بكلمة «كيان» هو أي شيء فيزيائي أو ظاهرة أو وضع أو حدث، ويسمى حينها «أ» بالسبب و«ب» بالنتيجة، ويضرب أمثلة تبين الفرق بين السببية والحتمية، فيبدأ بالسببية ويجعلها علاقة حاكمة بين الأشياء تُظهر قيام النتيجة بالسبب بصرف النظر عن تحديد الزمان والمكان لهذه العلاقات، فالسببية علاقة قائمة بشكل مطلق بصرف النظر عن التعيين في الزمن.
وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها على مبدأ السببية: الزيادة السكانية هي سبب فقر الهند، استقرار السياسة البريطانية كان بسبب المؤسسة الملكية.
الظروف الاقتصادية تتسبب في الحروب. لا توجد حياة على سطح القمر بسبب أن الغلاف الجوي هناك لا يحتوي على الأكسجين. التفاعلات الكيميائية تحدث بسبب انجذاب الجزيئات.
القاسم المشترك في هذه العبارات هو أن كلًّا منها تنص على علاقة غير زمنية؛ فهي جميعًا تخبرنا أن الشيء أو الحالة «أ» تتسبب في «ب»، مما يعني أن وجود «ب» معتمد على وجود «أ»، وأنه لو تغيرت أو غابت «أ» فسوف تتغير أو تغيب «ب» أيضا.
ثم ذكر عبارات مقاربة لكنها محددة في الزمن ولذلك فهي تعبر عن الحتمية وليس عن السببية:
المجاعة الهندية في عام 1946 كان سببها موسم حصاد سيئًا. سقوط هتلر كان بسبب هزيمة جيوشه. حرب الانفصال الأمريكية كانت بسبب الوضع الاقتصادي للعبيد. تدمير هيروشيما كان بسبب انفجار قنبلة نووية.
في هذه العبارات يعتبر الحدث المعين «أ» سببًا للحدث «ب» وكل منهما محدد في الزمان والمكان.
وأخيرًا يوضح أن مبدأ السببية ما زال مرتبطا بميكانيكا الكم فيقول “هل يمكن أن نرضى بقبول المصادفة وليس السبب كقانون أعلى للعالم الفيزيائي؟ للإجابة على هذا السؤال أقول، إنه ليست السببية المفهومة بشكل صحيح هي التي سقطت، وإنما الذي سقط فقط هو الفهم التقليدي لها المتمثل في تحديد هويتها بأنها هي نفسها الحتمية. لقد سعيت جاهدًا لأوضح أن هذين المفهومين غير متطابقين، السببية في تعريفي هي الفرضية القائلة بأن الحالة الفيزيائية المعينة تعتمد على الأخرى، والبحث السببي يعني الكشف عن هذا الاعتماد. وهذا ما زال صحيحًا حتى في فيزياء الكم”.
نشأة الحياة في الكون وضرورة وجود خالق ومصمم متقن:
وكذلك من ينظر في نشأة الحياة في هذا الكون ويدعي أنها جاءت اتفاقًا وصدفة، فإن هذا القول يكاد يكون مستحيل عمليًّا وأكثر غرابة ولا مَنطقيَّة من القول بنشأة أجسام الكون، فلو كان كل هذا بالصدفة والاتفاق، فكم من الزمان استغرق تكوينه بناء على قانون الصدفة الرياضي؟
إن الأجسام الحية تتركب من (خلايا حية) وهذه (الخلية) مركب صغير جدًّا ومعقد غاية التعقيد، وهى تدرس تحت علم خاص يسمى (علم الخلايا)Cytology. ومن الأجزاء التي تحتوي عليها هذه الخلايا: البروتين وهو مركب كيماوي مكون من خمسة عناصر هي الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، ويشمل الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر!
وفي الكون أكثر من مائة عنصر كيماوي كلها منتشرة في أرجائه، فأية نسبة في تركيب هذه العناصر يمكن أن تكون في صالح قانون (الصدفة)؟ وهل يمكن أن تتركب خمسة عناصر-من هذا العدد الكبير- لإيجاد (الجزيء البروتيني) بصدفة واتفاق محض؟
إننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الرياضي ذلك القدر الهائل من (المادة) الذي سنحتاجه لنحدث فيه الحركة اللازمة على الدوام؛ كما نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة السحيقة التي سوف تستغرقها هذه العملية.
لقد حاول رياضي سويسري شهير هو الأستاذ (تشارلز يوجين جواي) أن يستخرج هذه المدة عن طريق الرياضة، فانتهى في أبحاثه إلى أن (الإمكان المحض) في وقوع الحادث الاتفاقي-الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق كون، إذا ما توفرت المادة، هو واحد على 60/10 (أي 10×10 مائة وستين مرة)، وبعبارة أخرى: نضيف مائة وستين صفرا إلى جانب عشرة! وهو عدد هائل وصفه في اللغة.
إن جزيء البروتين يتكون من (سلاسل) طويلة من الأحماض الأمينية Amino-Acids وأخطر ما في هذه العملية هو الطريقة التي تختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض، فإنها لو اجتمعت في صورة غير صحيحة تصبح سمًّا قاتلًا بدلا من أن تصبح موجدة للحياة.
لقد توصل البروفيسور ج. ب. ليتزG. B. Leathes إلى أنه لا يمكن تجميع هذه السلاسل فيما يقرب من 48/10 صورة وطريقة.
وهو يقول: إنه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه السلاسل-بمحض الصدفة- في صورة مخصوصة من هذه الصور التي لا حصر لها، حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي يحتوي أربعين ألفًا من أجزاء العناصر الخمسة التي سبق ذكرها.
ولا بد أن يكون واضحًا أن القول بالإمكان في قانون الصدفة الرياضي لا يعني أنه لا بد من وقوع الحادث الذي ننتظره بعد تمام العمليات السابق ذكرها في تلك المدة السحيقة؛ وإنما معناه أن حدوثه في تلك المدة محتمل لا بالضرورة، فمن الممكن على الجانب الآخر من المسألة ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل العملية إلى الأبد!
وهذا الجزيء البروتيني ذو وجود (كيماوي) لا يتمتع بالحياة إلا عندما يصبح جزءًا من الخلية فهنا تبدأ الحياة، وهذا الواقع يطرح سؤالًا مُهمًّا: من أين تأتي الحرارة عندما يندمج الجزيء بالخلية؟ ولا جواب عن هذا السؤال عند غير المؤمنين.
إله سدّ الثغرات God of the gaps.
يفترض من لا يؤمن بوجود إله أنَّ مفهوم الإله ما نشأ لدى المؤمنين به إلا لوجود فجوة عِلميَّة وثغرة معرفية؛ لأنهم لم يستطيعوا تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية، والتقدم العلمي الذي حققته العلوم التجريبية كالفيزياء والأحياء وغيرها قد أغنانا عن القول بحَاجةِ هذا الكون إلى إله أو خالق، فتلك العلوم قد أحالتنا على أسباب الظواهر الطبيعية والكونية عن طريق القوانين التي استقرت وثبت صحتها، والتي لم نكن نعلم أسبابها في الماضي.
وللتوضيح لا بدّ أن نقرر مجال العلوم التجريبية، ومنها علم الفيزياء وغيره هو تفسير الظواهر الكونية والطبيعية التي تحدث شيئا فشيئا في هذا الكون، فمثلا عندما ينص إسحاق نيوتن على أنه:
لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه
فهذا القانون إنما يفسر ظاهرة حقيقية موجودة بالفعل، وتتكرر باستمرار، ومع كثرة المشاهدة ووفرة التجربة ودقة الملاحظة يستطيع العالم الفيزيائي أن يضع القاعدة أو القانون الذي يفسر حدوث تلك الظاهرة المتكررة.
وكذلك حينما يقول علماء الديناميكا الحرارية:
إن الحرارة تنتقل من الأجسام الأعلى حرارة إلى الأجسام الأقل حرارة في نظام معزول، وليس العكس، بدون شغل خارجي. فهذا القانون يفسر ظاهرة انتقال الحرارة من الأجسام الساخنة للأجسام الباردة حتى يحصل الاتزان الحراري بينهما، وهو أمر مشاهد ومتكرر، وتلك القوانين تفسر هذه الظواهر أي تعطي سببًا في سريانها على هذا النحو المشاهد باستمرار.
وعندما ينص ألبرت آينشتاين في معادلته المشهورة:
الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء
فهذا القانون يفسر ويرصد لنا أن كتلة الأجسام، ونواة العناصر المتكونة منها تحتوي على طاقة هائلة تساوي حاصل ضرب هذه الكتلة في سرعة عالية جدًّا وهي مربع سرعة الضوء، فهذه القوانين وأمثالها ترصد بعض الظواهر الطبيعية أي إنها كاشفة عن وجه النظام والترتيب بين أجزاء هذا الكون.
فبالتالي هناك فرق واضح بين الكاشف والمنشئ، فالكاشف عن الشيء هو الموضح والمفسر للعلاقات بين السبب والمسبب الموجودين بالفعل، وأغلب قوانين العلوم التجريبية من هذا الباب، أما المنشئ فهو المؤثر في الوجود وفي حصول الشيء من عدم.
وكذلك من المهم التفرقة بين السبب الضروري أي العلة العقلية والسبب العادي، فالسبب الضروري هو العلة الحتمية للوجود، أي التي لا يجوز تخلفها عقلا؛ كقولنا كل حادث له سبب، فهذا مبدأ من المبادئ العقلية الثابتة في التفكير البشري، فهذا يسمى سببا ضروريًّا أو علة، وأما السبب العادي فهو التلازم الموجود بين أمرين في الخارج في الظواهر الطبيعية والكونية وملاحظة تكرر الاقتران بينهما كقولنا مثلًا: إن الطعام سبب لحصول الشبع، وأن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، فهاهنا نقول: إن الطعام سبب عادي في حصول الشبع أي بينهما علاقة اقترانية ما؛ لكن يجوز أن يتخلف هذا الاقتران لمانعٍ ما، ونقول أيضا أن الحرارة سبب عادي في تمدد الجسم، فهذه الأسباب تدرك بالمشاهدة والتكرار، وكذلك القوانين المفسرة لها إنما توضع بعد الملاحظة والتجربة لهذه الأسباب، ثم صياغتها في شكل نظريات أو معادلات.
ولذلك قال العلماء: إن الضرورة والعلية صياغة منطقية، بينما الأسباب الطبيعية العادية صياغة للأحداث، أي انطباع ينشأ في الذهن نتيجة اطراد العلاقة بين النتائج والأسباب التجريبية.
فعلاقة كل هذا بوجود خالق مُنشئ للكون من عدم، هو كونه مُنشئا، فالملازمة والاقتران الشرطي والعقلي بين الكشف عن العلاقات الفيزيائية في الظواهر الطبيعية والكونية والبيولوجية، وبين نفي وجود خالق لهذا الكون، وفاعل للحوادث التي تجري فيه مغالطة واضحة.
مغالطة التلازم ونفي وجود الخالق
ولكي نوضح المغالطة في ادعاء وجود ملازمة بين اكتشاف القوانين المفسرة للظواهر الكونية والعلمية وبين نفي الخالق من الضروري أن نقدم بمقدمتين:
إننا من قبل قد أثبتنا أن هذا الكون مخلوق وناشئ من عدم، وأشهر النظريات العلمية حتى الآن التي تفسر نشأة الكون هي نظرية الانفجار العظيم تقول إن للكون بداية، وأنه يستحيل أن يكون الكون قد وُجد بنفسه أو من تلقاء نفسه، فالفيزياء والعلوم الكونية والمشاهدة والتجربة هي التي دلتنا على بداية الكون وأنه ليس أزليًّا، وكما يقول ستيفن هوكينج: إن العلم لا علاقة له بما قبل الانفجار العظيم أي ليس من اختصاصه، والسؤال الموجه إلى الفيزيائيين والماديين على اختلافهم: هل يمكن أن يوجد شيء من لا شيء؟ إنهم يقولون: لا؛ بناء على قانون حفظ الطاقة/ الكتلة الذي ينص على أن الكتلة/ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ومن ثم نسأل: هل يمكن للشيء أن يدخل في الوجود بلا سبب؟ فإن قالوا نعم فقد أبطلوا قوانين الفيزياء التي يدعون أنها مفسرة لكل الظواهر، وإن قالوا لا؛ لكننا لا نعرف ما هو السبب. فنقول لهم إن عدم العلم بالسبب الفيزيائي دليل على وجود سبب غير مادي ولا فيزيائي وهو (الله) جلَّ جلالُه.
فنظرية الانفجار العظيم تتصدى للإجابة عن الحدث الأول First Event لكنها لا تتعامل مع السبب الأول First Cause، ولا شك أن هناك فرق بينهما، وهذا السبب الغير فيزيائي الذي أثبتناه هو الذي يسميه المؤمنون
-المؤلهة- الله، لا بد أن يتصف بعدة صفات وهي:
1- واجب الوجود Necessary Being إذ إن تصور عدم وجوده يستتبع ألا يكون للكون ولوجودنا سبب.
2- وجوده لا يحتاج لسبب Uncaused؛ لأنه واجب الوجود، ولأنه يستحيل أن نتدرج في مصادر الموجودات إلى ما لانهاية.
3- أنه أزلي Eternal لأن الزمن وجد مع بداية الانفجار العظيم فذلك يستلزم أن يكون خالقه وسببه سابق على الزمان وغير مقارن له.
مطلق القدرة Omnipotent لأن المُوجد والخالق من عدم يستطيع إيجاد أي شيء.
مطلق المعرفة Omniscint لأن نشأة الكون وما استتبعه من هذا النظام المذهل في الكون بين أقسام العناصر المكونة له يستلزم معرفة تامة بموجوداته وما يحدث فيه.
إن مجرد مشاهدة التلازم بين أمرين، وحصول الثاني منهما عقب حصول الأول، لا يدل دلالة عقلية أو حتمية أن الأول سبب في وجود الثاني أو نشأته، وهذا الاطراد كما قلنا من قبل صياغة للحدث وليس ضرورة منطقية، والقوانين الفيزيائية مفسرة لحقائق موجودة بالفعل، فالقول بأنها مُوجدة للظواهر الكونية هو كالقفز على دليل بلا مقدمات؛ لأن العقل لا يحيل أن يكون المتسبب في هذه الظواهر هو خالق تام القدرة والمعرفة بلا واسطة أو بواسطة خصائص وقوى مودعة في الأجسام ومواد العالم، وما نلاحظه من التلازم بين الأسباب ومسبباتها لا يخرج أن يكون من الأحكام العادية التي تكتسب بالتجربة والتكرار.
يقول الأستاذ عباس محمود العقاد:
إن أسلوب لابلاس في التفكير الحتمي بالاستغناء عن العناية الإلهية -لأن قوانين الحركة تفسر حركة الأفلاك- يناقض أساليب الذهن الذي يراقب دورة الفلك، ويعلم أن العقل لا يستلزم حصولها على هذا الوجه دون غيره، إنه
ولا بد إذن من البحث عن الإرادة التي اختارت لها هذا الوجه من الحركة فانتظمت عليه([23]).
ومن راجع الأعمدة الرئيسة التي قام عليها دليل خلق العالم وجد أننا نجزم بمقدماتها وأدلتها، ولا نجهل شيئا منها، فمثلا إذا سألنا هل يمكن أن يكتشف العلم في المستقبل:
1- أن الكون أزلي ولا بداية له؟ الإجابة: قطعًا: لا.
2- أن الكون الذي له بداية يمكن أن ينشأ من عدم محض؟ الإجابة قطعًا: لا.
3- أن السبب الأول لوجود الكون يمكن أن يكون سببًا ماديًّا لا موجد له؟ الإجابة قطعًا: لا.
فالفيصل الحقيقي في إثبات وجود الخالق أو نفيه هو إقامة الأدلة على استحالة قدم العالم وأزليته، وأن له بداية وأن مُوجِده يتصف بصفات الكمال كالقدرة التامة والإرادة والعلم.
وعليه فالقول بأن خالق الكون هو مجرد اعتقاد لسد الثغرات المعرفية أو حل مؤقت لعجزنا عن تفسير بعض الأمور خطأ محض؛ لأنه ليس مبنيًّا على نقص في المعرفة العلمية، بل لأنه مبني على المعرفة العلمية اليقينيَّة والبراهين القطعية والتي أثبتها العلم والعقل والفيزياء، فدعوى الملحدين أننا نقول بوجود الخالق نتيجة لعدم اكتشافنا بعض الأسباب والنظريات المفسرة لبعض الظواهر ليس صحيحًا؛ لأننا ببساطة لا نتحدث عن (آلية) أو (حدث أول) يمكن أن يفسره العلم، لكننا نتحدث بوضوح عن (السبب الأول) وراء كل الأحداث والأسباب والمسببات المشاهدة في الكون، فالقول بوجود الله ليس تفسيرا لما لم يفسره العلم، بل هو تفسير لما أثبته العلم.
تدخّل الله في العلم ونظرية الخلق المستمر:
يرد على الذهن بين الحين والآخر بعض الاستشكالات حول ماهيّة تصوّر قدرة الإله، وهل هو يتدخّل في كلِّ شيء في الكون؟ وهل يعلم بالجزئيات علمه بالكليّات؟ كل هذه أسئلة الإجابة عنها ناشئة عن التصّور الذهني عن الإله ومدى علمه وقدرته وإرادته، وفي هذه النقطة حيرت العقول قديمًا وحديثًا، وبناءً على التصوّر بشأنها نشأت فلسفة كلّ فريق في حدود تدخّل هذا الإله.
فخصص أرسطو كتابه (ما بعد الطبيعة) للبحث في فكرة الإله، وإن كانت الميتافيزيقيا في نظره لها معنيان أحدهما خاص والآخر عام.
فالمعنى الخاص يقتصر موضوعه على الجواهر المفارقة، وهو ما يدعوه بالإلهيات خاصة، والمعنى العام يبحث في خصائص الوجود بما هو موجود، وهو ما يسميه علم الوجود؛ فتصوّر الإله عند أرسطو ليس معناه الخالق فقط، بل هو المحرّك، ومعنى المحرّك هو الذي يُخرج ما هو بالقوّة من القوّة إلى الفعل.
وفي الحقيقة أنَّ هذا التصوّر متماشٍ مع نظرة أرسطو للكون والحياة، فأرسطو كان يرى أنّ العالم عبارة عن طبقات فيها الأدنى والأعلى، والأدنى موجود لصالح ما هو أعلى، وما هو أعلى إنّما يكون كذلك لسبب ما فيه من مبدأ عقلي كما عبّر هو عن ذلك بنفسه.
ولأن الكون عنده مرتب بـ”الهيراركية” أي: التصاعدية، فالجماد ثمّ النبات ثمّ الحيوان ثمّ الإنسان، ثمّ الأجرام السماوية، ثمّ الإله أو المحرّك أو العقل المحض، أو…؛ فالإله عنده هو المحرّك لكلّ شيء؛ لأن كلّ شيء لا بد أن يرجع في النهاية إلى مبدأ أوّل يُحرّك ولا يتحرّك، يؤثّر في غيره ولا يتأثّر بشيء. يسميه (العقل المحض، أو العاقل، أو المبدأ الأول، أو المحرّك)؛ أسماء تفيد أنه مالك للإرادة المطلقة، وهو مرتبط بترتيب الأسباب، فیُعَرِّفُ الفلاسفة القدماء السبب بأنه: ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيّته، أو في وجوده.
لقد جعل أرسطو الإله المبدأ الأول للوجود، وهو لا يتحرك، بل سبب كل حركة، وهو متصف بالكمال لكنّه خال من القوة، ولا يدرك إلا أفضل الموجودات وهي ذاته فقط.
هذه الصفات التي ألزمها أرسطو للإله تستلزم منه أن لا يعلم العالم، بحجة أنّ العالم شيء ناقص وفاسد بالنسبة إليه، وأنّ الأشياء توجد وتنعدم، دون أن يريد الإله لها ذلك أو يعلم من أمرها شيئًا، إذًا فالإله عند أرسطو منطوٍ على نفسه، جاهل لما يقع في الكون، ولا مريد لما يجري فيه من أحداث، كما أنّه لا يحرك في الكون ساكنًا، فهو ليس علة فاعلة في الكون، بل علة غائية، يتحرك الكون شوقًا إليه، فعلاقة الإله بالعالم تنحصر في أن يثير اشتهاء العالم، وباستثناء ذلك فإنّ نشاط الإله يتجه بالكلية إلى داخله هو أي ذاته.
والحقيقة أن المؤمنين لم يقعوا في هذه الإشكالية عن الإله لثبوت ما يُعرف بقانون السببية، فتصوّر هذا القانون يحل كل هذه الاستشكالات.
قانون السببية معناه: أن يترتب السبب على مسببه، وألا يتخلّف عنه بحال من الأحوال؛ لأن السبب لغةً: اسم لما يتوصل به إلى المقصود، فكلّ شيء يُتوصّل به إلى غيره يسمّى سببا سواء كان هذا الشيء حسيًّا أو معنويًّا.
وفي اصطلاح المتكلمين: هو ما يحصل عنده الشيء لا به. هذا تعريف الأشاعرة؛ لأنّ السبب عندهم غير مؤثر بذاته بل هو علامة وأمارة عن التأثير الحاصل.
فمثلا: الحبل، وسيلة وسبب لإخراج الماء من البئر، وليس هو المؤثّر في الإخراج، وإنَّما المؤثِّر حركة المستقي للماء.
والمعتزلة قالوا: السبب يوجب المسبب متى كان المحلّ محتملا له، ووجد على الوجه الذي من حقه أن يولّده، فالسبب يوجب المسبب إذا احتمله المحلّ، فالأسباب تؤثر في مسبباتها.
وقد وقع الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في علاقة الأسباب بمسبباتها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الله هو الذي يخلق الحوادث والمسببات عند حصول الأسباب، أي عند وجودها واقترانها بها، فالله هو الذي يخلق الشعور بالشبع عند تناول الطعام، وهو الذي يخلق الإحراق عند وجود النار، وكذلك يخلق التمدد عند وجود الحرارة، فكل هذه الحوادث إنما هي بتأثير خلق الله وقدرته دون وجود أي مدخلية للأسباب المصاحبة لها إلا التلازم والاقتران المشاهد بينهما.
القول الثاني: أن الله يخلق هذه الحوادث والظواهر عن طريق قوة أودعها في الأسباب المقارنة لها، فهو خلق السبب والمسبب وخلق في السبب قوة مودعة فيه هي التي تُحدث الظاهرة أو توجد الحدث، فهو -أي الخالق- هنا يخلق بواسطة وهي القوى المودعة في الأسباب.
والقولين السابقين هما قولا المسلمين وأغلب أهل الأديان المؤمنين.
القول الثالث: وهو قول كثير من الفلاسفة حيث يقولون بأن هذه الأسباب هي علل للحوادث والظواهر التي تحدث في الكون، فمتى ما وجد السبب فلا بد حتما أن يوجد المسبب إذا انتفى المانع، من دون مدخل لتدخل القدرة الإلهية؛ لأنّ السبب في الفلسفة اليونانية القديمة منقسم إلى أربعة أقسام:
– السبب المادي: والمقصود به ما هو داخل الشيء ومعه بالقوة، كالنحاس بالنسبة للتمثال.
– السبب الصوري: والمقصود به ما هو داخل الشيء ومعه بالفعل، كالشكل النهائي للتمثال.
-السبب الفاعلي: والمقصود المؤثر في وجود الشيء والداخل فيه، كالذي صنع التمثال.
-السبب الغائي: والمقصود به الذي من أجله وُجد التمثال.
فعلى ذلك تكون للسببية ثلاثة معاني تشیر إلى: المقولة التي تختص بالرابطة السببية:
أ- المبدأ، أي: القانون العام للسببية.
ب- والمبحث، أو المذهب الذي يتوجه للبحث عن المبدأ السببي.
ج- الغاية.
وأما نظرية الخلق المستمر أو الخلق المتجدد فقد شغلت حيّزًا كبيرًا من مناقشات علماء الكلام، والحقيقة أنَّ ما أورده الأشاعرة من مباحثات وردود في الدرس العقدي حول هذه النظرية لا زال حاضرًا وبقوّة في وقتنا المعاصر، وإن لم يكن داخل الدرس الفلسفي فإنه يحتل موقعا كبيرًا لا يمكن إنكاره مع النظريات العلمية.
وجوهر فكرة (الخلق المستمر) مبثوث في كتب الأشاعرة وإن لم يُوجد لها مصطلح مخصوص؛ لكنها موجودة في مباحثهم المتعلقة بالفعل والمشيئة الإلهية، والإرادة وما إلى ذلك، وانتقل هذا المفهوم من الدراسات الفلسفية إلى حقل العلم وأصبح نظرية تفسيرية.
فتعدُّ الآن نظرية الخلق المستمر continuous creation theory كأحد النظريات المفسّرة لنشأة الكون؛ ذلك أنَّ مفهومها يكمن في أنه: ليس للكون لحظة ابتداء ولا لحظة انتهاء، وأنَّ المجرَّات التي تتباعد إنما تُخلق محلها المادة على شكل ذرات الهيدروجين؛ لتبقى كثافة اللون ثابته، أي: أنَّ هناك خلقًا دائمًا للمجرَّات والكواكب والنجوم([24]).
كما أنَّ الممكن حال بقائه غير مستغنٍ عن المؤثر، كما أنَّ العَرَضَ لا يبقى زمانين، ومعنى ذلك أن يُخلق في كل زمان زمان، فيستمر في الخلق؛ لأن من صفاته الخلاق، فلم يخلق الخلق ويتركهم سدى وهملا، ومن المقرر أن الاسم المشتق لا يفارق المشتق منه، فـ(الخالق) اسم فاعل مشتق من الخلق، فلا يفارقه أبدًا، كالحي لا يفارق الحياة… وهكذا، ولذلك نقول إنَّ الكون والكائنات لا تقوم بذاتها؛ لأن الله هو القيوم.
ويبقى السؤال الأهم وهو: هل قوانين السببية وجريان العالم على قانون الأسباب المطرد يمنع من وصف الإله بالقدرة أو بالخلق المستمر؟
لقد قررنا سابقًا أنَّ الله يُحدث قدرة في الشيء عن إرادة، فهذه القدرة مصاحبة للفعل متعلقة به، فمثلًا النار لها قدرة على الإحراق مصاحبة لفعل الإحراق وليست هي بذاتها، وليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلًا وإنَّما تتعلق به وتصاحبه فقط([25]).
كما أنَّ للعبد قدرة وإرادة في فعل الشيء أو عدمه تؤثر في الفعل، وحاصل العبد القادر عند أهل السُّنَّة أنه مجبور في قالب مختار، مجبور من حيث أنَّه لا أثر له ألبتة في أثر ما عمومًا، وإنِّما هو ظرف للحوادث والأعراض يخلق الله تعالى فيه ما شاء ويختار، فما اقتصرنا عليه في أصل العقيدة من عدم التأثير للقدرة الحادثة ألبتة هو المعروف المشهور الذي لا يصح عقلًا ولا شرعًا خلافه، وهذه القدرة الحادثة التي يطلق عليها الكسب، والمقصود بالكسب: هو مصاحبة القدرة الحادثة للمقدور وتعلّقها به من غير تأثير لها ألبتة.
وهذه القدرة الحادثة -أيضًا- هي عَرَضٌ من الأعراض يخلق الله بالعناية المستمَّرة لخلقة، ومدى احتياجهم للفعل الذي يقدرون على مباشرته يخلق لها إرادة تسيير في الشيء المقصود وقت القصد للفعل، فالنظرة السديدة تقضي بأنه ليس للعبد فعل حقيقة، وإنما تأثير وتدخل من الله في تطويع الأمر له، مثال ذلك: الحركة والسكون.
فالحركة والسكون عَرَضٌ من الأعراض، فمثلا: حين تمسك بالقلم لتكتب، فحركة القلم في يدك عرض خلقه الله عند إرادتك للتحريك، وكذلك حركة اليد الماسكة بالقلم عَرَضٌ خلقه الله خلقا مستمرًّا عند حاجتك إليه، وليس ليدك تأثيرًا مباشرًا في التحريك لأن العرض لا يتعدى محلّين.
ويمكن أن يسأل سائل سؤالا وهو أنَّ العادة تقضي بأن تحريك اليد كما في المثال السابق يعقبه تحريك القلم فهو علاقة سببية بينهما؟
والجواب: أنَّ هذا التحريك عَرَضٌ والعرض لا يبقى زمانين، ومن المقرر أنَّ القدرة الحادثة للإنسان المقترنة بالفعل الناشئ عنها لا بدَّ أن تقارن الفعل ولا تكون سابقة عليه؛ لأنَّ الأعراض لا تبقى زمانين فيخلق الله هذا العَرَضَ وقت القصد للفعل، “وإذا كانت الاستطاعة عَرَضًا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه؛ لامتناع بقاء الأعراض”([26]).
وفي تفسير قول الله تعالى: (قُلۡنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ) [الأنبياء: 69] يقول الفخر الرازي:
أنَّ الناس اختلفوا في المعنى المراد من كون النار أصبحت بردًا على أقوال كثير، أولاها القول: بأن الله تعالى أزال عنها ما فيها من الحر والإحراق، وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق والله على كل شيء قدير([27]).
وهذه الآية التي غالبًا ما يضرب بها العلماء الكلام للتدليل على أن قانون الأسباب للشيء وقدرته على الاستمرار يمكن أن تتخلفَ بنزع خاصة من خاصياته، فالطبيعي أن يطَّردَ قانون السببية بمجرد أن يُلقى إنسانٌ ما في النار أن تحرقه النار، لكن لبيان المعجزة وتثبيت دعائم التدخل الإلهي، في بيان الحفظ والعناية، جعلها الله بردًا وسلامًا، على قاعدة الخلق المستمر، فإنَّ الله يخلق خلقًا مستمرًّا عند الفعل بل عند إرادته وتهيؤ أسبابه.
وهذا ما يحيلنا إلى الجواب عن: هل يمكن عقلًا أن تتخلف الأسباب؟
والجواب أن نقول: إذا كانت الأسبابُ داخلةٌ في دائرة الإمكان، وكل ما كان في دائرة الممكن يمكن أن يرد عليه الإبدال أو التغيير، فالأسباب كذلك بلا شك، أما إذا لم تكن داخلة في دائرة الإمكان فلا يُتصور تبدُّلها، وبالتجربة والمشاهدة أن تخلف الأسباب وارد، ومع افتراض جريان العالم على قوانين مطردة فإن تلك القوانين لا تمنع من وجود عناية سابقة على تلك القوانين هذه العناية يمكن أن نسميها تدخل، ويمكن أن نسميها حفظ عن الخطأ، ويمكن أن نسميها قدرة من الإله، إلى غير ذلك من المسميات، فلذلك لا يمكننا بحال أن نعتقد أن الله خلق العالم وخلق له قوانين ثم هو يتركها هملًا، ولذلك قال الله في القرآن: {هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤}[الحديد: 4].
وفيما يتعلق بوجهة نظر الفيزياء الكلاسيكية التي قامت على قوانين نيوتن للحركة والجاذبية في الشق الفلسفي المتعلق بتدخل الخالق في الكون -فإنها قد مرت بمرحلتين:
– المرحلة الأولى: احتفظ إسحاق نيوتن فيها للإله بدور في منظومة عمل الكون يقوم على دعامتين؛ الأولى: تقول إن قوانين الطبيعة من خلق الإله، سواء بأن جعلها مكونًا ثابتًا في بنية المادة، أو أنه حدَّد للمادة السلوك الذي ينبغي أن تتبعه وألزمها به؛ والثانية: أن الإله هو المسؤول عن تعديل الخلل الواقع في مسارات الكواكب إذا خرجت عن النسق العام لقوانين الفيزياء.
وهذا التصور المنسوب لنيوتن عن علاقة الخالق بالقوانين الفيزيائية هو ما جعل البابا ألكسندر أن يكتب على قبر نيوتن: كانت قوانين الطبيعة ترقد في ظلام الليل، ثم قال الإله فليكن نيوتن، فأضاء كل شيء. وهو قريب من القول الثاني للموحدين الذين ينسبون المسببات والظواهر للقوة المودعة فيها من الله.
– المرحلة الثانية: التي ذهب فيها الفلكي الشهير لابلاس أن الإله لا دور له في تغيراته؛ لأن الكون مكتف بذاته ومغلق، وكل الظواهر التي فيه حتمية، لذلك شاع الحديث عن (حتمية) لابلاس التي تنفي تدخل القدرة الإلهية في حوادث الكون.
وعندما سأل نابليون بونابرت لابلاس عن مكان العناية الإلهية من حركات الأفلاك، أجابه أنه لا يرى لها مكانًا فيما يعلمه من تلك الحركات، فقوانين الحركة وحدها تفسر تفسيرًا يغني عن النظر لعلة أخرى وراءها.
أما في الفيزياء الحديثة خاصة ما يتعلق بميكانيكا الكم، فإنها قد رفضت مفاهيم الحتمية الموجودة عند لابلاس مع ظهور مفهوم اللاحتمية عند هايزنبرج، فالقوانين المفسرة لسلوك الجسيمات في فيزياء الكم قائم أغلبها على الاحتمالات وعدم وجود قيم محددة يسبق التنبؤ بها.
فمفهوم الارتياب واللاحتمية من المفاهيم الأساسية في فيزياء الكم، فمثلًا إذا سقطت مئات الجسيمات للضوء على مرآة فطبقًا لمبدأ هايزنبرج فإن حوالي 95% منها تنعكس تجاهنا لنرى الصورة، بينما تنفذ حوالي 5% من هذه الجسيمات خلال المرآة، لكن إذا سقط جسيم ضوئي واحد (فوتون) على المرآة فإننا لا نعرف ولا نجزم هل هذا الفوتون سينفذ أم سينعكس، لكن يبقى هناك احتمال بنسبة 95% أن ينعكس إلينا، واحتمال 5 % أن ينفذ خلال المرآة.
والفيزيائي الأشهر في القرن العشرين ألبرت آينشتاين يعارض حتمية لابلاس التي تعتمد أن الكون نظام مغلق كما يرفض مفهوم اللاحتمية في فيزياء الكم، ويرى أن هناك قوانين دقيقة لم ندركها بعد هي التي تحكم سلوك الجسيمات تحت الذرية، ويقول في هذا مقولته المشهورة: «إن الله لا يلعب بالنرد» أي إن كل شيء في هذا الكون يسير وفق نظام دقيق أنشأه الله حتى ولو لم نتعرف عليه بعد.
تقرير القضية قائم في ذهن من يسأل سؤال من خلق الله؟ بناء على تصور القاعدة بأن كل موجود له سبب، فمن الذي خلق الخالق، بناء على ضرورة قانون السببية.
ولتوضيح المعنى المقصود لا بد أن نقدم بعدة مقدمات حتى يتضح التناقض في السؤال، وعدم تناقضه مع ما أثبتناه من ضرورة السببية في العلل والمؤثرات.
ضرورة فهم الأحكام العقلية الثلاثة:
كما قدَّمنا هناك أحكاما ثلاثة اتفق على إثباتها جميع العقلاء لجميع المفاهيم والأحكام والموجودات، وهي الأحكام العقلية الثلاثة: الوجوب والاستحالة والإمكان، ومعرفة هذه الأحكام الثلاثة يزيل الإشكالات عن كثيرٍ من الأسئلة ودعاوى التناقض.
أما الوجوب العقلي: وهو الأمر الذي لا يتصور الانتفاء بالنظر إلى ذاته، أو هو ما لا يتصور في العقل عدمه، ومثاله: تحيز الأجسام، فالجسم حال كونه جسما يستحيل ألا يكون متحيزًا؛ أي يشغل قدرًا من الفراغ الموهوم، وإذا انتفى التحيز انتفت حقيقة الجسم. ومثاله أيضًا إثبات أن الكلَّ أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، فعند تصور معنى الكل والجزء ومعنى الكبر يجزم العقل بوجوب هذا الحكم بالنظر إلى ذاته، ودون النظر إلى أي اعتبارات أخرى .
والمستحيل العقلي: عكس الواجب وهو الأمر الذي لا يتصور الثبوت بالنظر إلى ذاته، أي هو الأمر الذي لا يقبل الثبوت بأي حال ودون النظر لأي اعتبار آخر، ومثاله: اجتماع النقيضين كوصف الشيء الواحد بأنه موجود وغير موجود دون النظر لأي حيثيات أو اعتبارات أخرى، وكذلك وصف الجزء أنه أكبر من الكل، وكذلك الدَّور تَوقُّف وجود الشيء على ما يُتوقف وجوده عليه؛ كتوقف
(أ) على (ب)، وتوقف (ب) على (أ)، كدعوى شخص أن سبب وجوده هو والده، وأن سبب وجود والده هو ولده.
والإمكان: وهو الأمر الذي يقبل الثبوت أو الانتفاء بالنظر إلى ذاته، ودون النظر لأي اعتبارات أو حيثيات أخرى، ومثاله: وجود الإنسان على الصورة التي يوجد عليها من اختلاف الصفات والأحوال، فالعقل لا يوجب أو يحيل وجود الإنسان، وكذلك لا يوجب أن يوجد على حالة واحدة من الطول أو القصر والكبر والصغر وغيرها من الصفات المتقابلة، فالعقل يجوز أن يتصف الإنسان بأضداد هذه الصفات التي يتصف بها، وأكبر دليل على الإمكان هو التغير والتحول من حالة لحالة ومن صفة إلى صفة.
وينبغي أن يُعلمَ أن هذه الأحكام العَقليَّة الثلاثة تنقسم لما هو بديهي وما هو نظري، والبديهي ما يدركه العقل بأدنى ملاحظة من دون تفكير والنظري عكسه، فمثال الواجب البدهي مثلا الحكم بتحيز الجسم، والحكم بأن الواحد نصف الاثنين، لأن العقل بمجرد تصور مفردات هذه القضية وهو معنى التحيز ومعنى الجسم، وكذلك معنى الواحد والاثنين ومعنى النصف يجزم فورًا بوجوب هذه الأحكام واستحالة تخلفها.
وأما النظري من هذه الأحكام فهو الذي يُدَرك بعد مزيد تأمل ونظر وبحث، وهذا النظر لا ينفي عنه قَطعيَّة الحكم إما بالوجوب أو الجواز أو الاستحالة، لكن الفرق بينه وبين الأول وهو البدهي أنه احتاج إلى تقديم عدد من الأدلة والمقدمات للوصول إلى هذه الأحكام الثلاثة.
ومثال الواجب النظري الحكم بوجوب صدق الأنبياء المؤيدين بالمعجزات، ومثال المستحيل النظري الحكم باستحالة التسلسل وهو اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل الممكنة بصورة غير متناهية، مثل أن يتوقف (أ) على (ب)، و(ب) على (ج)، و(ج) على (د)، وهكذا إلى ما لا نهاية.
واستحالة التسلسل: باعتبار أنَّه يؤدي إلى استحالة تحقق أي واحد من المعاليل، وأنَّ فرض تحقق ذلك يستلزم وجود المعلول بلا علة وهو محال.
– وعند فهم هذه المقدمة الأولى، خاصة معنى الواجب والممكن نقول: إن الموجود الواجب والممكن يتصف كل منهما بعدة أمور، فمما يتصف به الممكن:
-1 أنه لا محال في فرض وجوده أو عدمه وإلا فهو واجب لذاته، وتنقلب حقيقته.
2- إن أحد الطرفين الجائزين عليه من الصفات المتقابلة ليس أولى من الآخر.
3-أن إمكانه هو علة احتياجه لغيره.
كذلك نقول إن الواجب له صفات وخواص واجبة له بناء على تصور معناه وهي:
1- أن وجوب وجوده مستمد من ذاته وليس من غيره وإلا لكان ممكنًا.
2- أن عدمه ممتنع.
3- أنه لا يحتاج في وجوده إلى سبب.
وإذا تصورنا ما سبق، فإننا نسأل سؤالا مهما، وهو: إلى أي قسم من الأقسام الثلاثة يوصف به هذا العالم، وأي قسم يوصف به الخالق؟
إن الإجابة الضَّروريَّة أن العالم ينتمي للقسم الثالث وهو الإمكان؛ لأننا قد افترضنا وأثبتنا خلقه أي استحداثه من عدم واستحالة أزليته، وأن العدم سابق عليه وجائز في حقه، وأما الخالق سبحانه وهو الله، فإننا أثبتنا وجوده بناء على بعض المقدمات وهي:
أولًا: أن هذا العالم حادث ومخلوق وممكن.
ثانيًا: أن كل ممكن يحتاج ويفتقر إلى سبب وموجد.
ثالثًا: استحالة تسلسل الأسباب والعلل لا إلى خالق أول قديم.
وقد قدمنا الأدلة القطعية على صحة كل مقدمة من هذه المقدمات الثلاثة، كما أنه لا يخفى أننا لما أثبتنا ضرورة قانون السببية وضحنا أن هذا المبدأ القائل بأن لكل شيء سببًا أساسه هو النظر إلى ماهية الممكن، وهو الذي لا يترجح جانب وجوده على عدمه أو العكس، وذكرنا في أدلة ضرورة استناد كل ممكن إلى سبب، أن ترجيح جانب الوجود على العدم يحتاج إلى مرجح، ويبعد ويستحيل أن يكون هذا الترجيح من تلقاء نفسه؛ لأن ماهية الممكن أي (هويته) تقضي بأنه يستوي جانبا الوجود والعدم فيه لذاته، ومن ثم فإننا نناقض مبدأ الهوية -وهو المبدأ الأول من المبادئ العقلية- إذا قلنا بـأن (الممكن) أوجد نفسه دون حاجة إلى مؤثر خارج عن ماهيته، ومختلف في حقيقة (الإمكان) الذي قد ثبت له.
فبناء على هذا فالله سبحانه واجب الوجود لذاته، أي أن وجوده مستمد من ذاته، ويستحيل عليه العدم؛ لأن ما ثبت وجوبه وقدمه استحال عدمه، وأيضا فإن وجوده ليس مستمدًّا من غيره أو متوقف عليه، وبالتالي يكون التساؤل من خلق الله يحتوي تناقضًا واضحًا، وهو افتراض أن الواجبَ الوجود الذي يستمد وجوده من ذاته ولا يسبقه أو يطرأ عليه العدم، معتمد ومستند في وجوده إلى غيره، وهو خُلفٌ وتناقضٌ واضح في جملة قصيرة.
وعلم أيضا مما سبق أن هذا ليس تخصيصًا في الأحكام العقلية فيما يتعلق بإثبات قانون السببية على العالم، ومنعه على خالق العالم؛ لأنَّا نقول إن السببية متعلقة بإمكان ماهية الموجودات بغض النظر عما تصدق عليه، وهو مما لا يصدق على واجب الوجود الذي نسميه وهو الله سبحانه وتعالى.
– قد أشار القرآن الكريم إلى هذا الفرق في قوله تعالى: (أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُ) [النحل: 17] لبيان الفرق؛ حيث إن ماهية الخالق الواجبة تختلف قطعًا عن ماهية الممكن المفتقرة إلى السبب، كما أنَّ وجود الله سبحانه ليس متعلقًا بالزمان؛ فهو موجود قبل الزمان ومستغنٍ عنه، وأن الزمان قد بدأ بخلق العالم.
فمن المغالطات أيضًا السؤال عن الله بـ متى؟ أو متى كان؟ لأنه يجر أيضا للسؤال بـ (من خلق الله؟)، فهو سبحانه لا يعتمد في وجوده على زمان أو مكان أو سبب.
هل يقدر الله أن يخلق إلها معه؟
ويترتب على ما مرَّ من صفات الممكن وصفات واجب الوجود والتفرقة بينهما أنّ نجد تصوّر مثل هذا السؤال يحتوي على تناقض ومغالطة، وحتى يتضح هذا التناقض وتلك المغالطة فلا بد أن نسأل ما هو الإله؟ وما هي صفة القدرة؟ وهل فرض وجود إله ثاني، أو إله مماثل للخالق القديم واجب أم جائز أو مستحيل بالنظر إلى ذاته؟
والجواب: أنه لما أقمنا الأدلة على وجود الله، استلزم ذلك وصفه ببعض الصفات الواجبة، منها أنه واجب الوجود لذاته، أي يستمد وجوده من نفسه ويستحيل عليه العدم ويستحيل افتقاره أو استناد وجوده من غيره، وكذلك أيضًا أثبتنا له صفة القدرة الكاملة لما رأينا من بديع صنعه إلى إيجاد الممكنات من حيز العدم للوجود، ومن جملة هذه الممكنات هذا العالم بكل ما فيه، أو لما رأينا من آثار هذه القدرة على إعدام هذه الموجودات الممكنة؛ لأنَّ القدرة هي صفة توثر في إيجاد الممكن وإعدامه([28])، ومعنى هذا أن القدرة من صفات التأثير أي هي التي تنقل الممكن من حيز العدم إلى حيز الوجود أو العكس. ويفهم من هذا لماذا لا تتعلق هذه الصفة بالقسمين الآخرين من أقسام الحكم العقلي التي بيناها، وهما الواجب والمستحيل؛ لأن الواجب لا يقبل الانتفاء، والمستحيل لا يقبل الثبوت، ولو تعلقت صفة التأثير وهي القدرة بالواجب أو المستحيل للزم قلب حقيقة كل منهما، وتغير ماهيته وهو محال.
وأما فرض وجود إله ثاني أو إله مماثل للخالق القديم، فهو مستحيل في ذاته؛ لأن الإله هو الواجب المستغني عما سواه، وما دام افتُرِضَ استناد وجود هذا الإله المزعوم إلى إله غيره سابق في الوجود عليه فلا يكون حينئذ إلها؛ لأننا قد جوَّزنا عليه كل صفات الممكن وهو سبق العدم على وجوده وافتقاره إلى غيره، والإله لا يكون إلا واجبا.
واصطلح علماء الكلام على تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى إلى:
أولًا: صفات سلبية أو تنزيهية: وهي تدل على سلب النقص عنه تعالى. مثل صفة القيام بالنفس فمعنى كونه تعالى متصف بها أنه سبحانه وتعالى مستغن عن غيره استغناء تامًّا.
ثانيًا: صفات وجُوديَّة أو ثبوتية: وهي تدل على كمال موجود له سبحانه وتعالى. مثل صفة السمع والبصر في حقه سبحانه وتعالى.
ومن الصفاتِ السَّلبيَّة صفة الوَحدانيَّة:
ومعناها عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال.
ومعنى الوحدانية في الذات أي ليست ذاته مركبة من أجزاء، ولا توجد ذات تشبه ذاته تعالى.
ومعناها في الصفات أي عدم وجود صفتين له تعالى من نوع واحد كعلمين وقدرتين، وعدم وجود صفة لغيره تشبه صفته تعالى.
ومعناها في الأفعال: عدم وجود فعل لأحد غيره يشبه فعله تعالى؛ لذا ذكر العلماء أن الوَحدانيَّةَ الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفي كمومًا خمسة وهي:
الكم المتصل في الذات: وهو تركبها من أجزاء.
والكم المنفصل فيها: وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر، وهذان الكمان منفیان بوحدة الذات.
والكم المتصل في الصفات: وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد كقدرتين فأكثر.
والكم المنفصل في الصفات: وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم بها كقدرته تعالى، أو إرادة تخصيص الشيء بعض الممكنات، أو علم محیط بجميع الأشياء، وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات.
والكم المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد، وإنما ينسب الفعل له على وجه الكسب والاختيار. وهذا الكم منفي بوحدانية الأفعال.
وأما الكم المتصل في الأفعال فإن صورناه بتعدد الأفعال فهو ثابت لا يصح نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك، وإن صورناه بمشاركة غير الله له في فعل من الأفعال فهو منفي أيضا بوحدانية الأفعال.
وقد استدل العلماء على هذه الصفة بأدلة نقلية منها قوله تعالى: (قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ) [الصمد: 1-4].
وقوله تعالى: (مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١) [المؤمنون: 91].
وأدلة عقلية على نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال، ومن الأدلة على نفي التعدد في الذات بمعنى عدم وجود ذات تشبه ذاته، ما يُعرف بـ دليل التمانع: وهو أنه لو فرض وجود إلهين، كل منهما متصف بصفات الألوهية من العلم والإرادة والقدرة …إلخ، فإمَّا أن تنفق إرادتهما، أو تختلقا، وكل من الفرضين محال، فوجود إلهين محال، وبيان ذلك:
أولًا: في حالة الاختلاف بمعنى أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بخلق شيء مثلا، وتعلقت إرادة الآخر بعدم خلقه فالاحتمالات العقلية ثلاثة:
(أ) إما أن ينفذ مرادهما معًا وهو محال؛ لأنه اجتماع للنقيضين (الخلق وعدم الخلق).
(ب) وإما ألا ينفذ مرادهما معا، وهو محال؛ لأنه رفع للنقيضين، ويلزم عجزهما، والعجز على الإله محال.
(ج) وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، وهذا يستلزم عجز من لم تنفذ إرادته، وبما أن الثاني مثله، فهو عاجز أيضا لأن الفرض أنه مثله؛ فما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر
أولا: في حالة الاتفاق بمعنى أن تتفق إرادتهما على فعل شيء واحد مثل إيجاد زيد. فالاحتمالات العقلية أربعة:
(أ) أن يوجداه معًا على سبيل الاستقلال في وقت واحد، وهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد.
(ب) أن يوجداه معًا على سبيل الترتيب، بأن يوجده أحدهما، ثم يوجده الآخر، وهو محال؛ لأنه تحصيل الحاصل.
(ج) أن يوجداه على سبيل المعاونة، فكل منهما يعاون زميله في إيجاده وهو محال؛ لأنه يلزم عجز كل منهما، لاحتياجه إلى الآخر.
(د) أن يوجداه على سبيل التقسيم، بأن يوجد أحدهما بعضه، والآخر بعضه، وهو محال؛ لأنه يلزم عجز كل منهما، فكل منهما لا يقدر على التصرف فيما تصرف فيه الآخر.
وإذا بطلت هذه الاحتمالات سواء في حالة الاتفاق، أو في حالة الاختلاف، انتفى القول بتعدد الذوات، وثبتت الوحدانية لله في الذات بمعنى عدم وجود ذات تشبه ذاته.
وهذا الدليل نجده في قوله سبحانه وتعالى: (مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) [المؤمنون: 91]، وقوله سبحانه وتعالى: (لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ) [الأنبياء: 22]؛ لأننا لو فرضنا وجود إلهين لكل واحد منهما قدرة وإرادة تعلقت بنقيض ما يريده الآخر، كمثل إيجاد زيد أو إعدامه، فلا بد يبعد أن تنفذ قدرتاهما معا أو تنفذ قدرة واحد منهما، والأول مستحيل لما يترتب عليه من اجتماع النقيضين وهو محال عقلا لذاته، والثاني مستحيل لأن الذي لن تنفذ قدرته غير مستحق لوصف الألوهية، فثبت أن وصف الألوهية والوجوب لا يكون إلا لواحد وهو الله سبحانه.
وإذا تقرر ما تقدم ثبتت وحدانيته سبحانه وتعالى واستحال الشريك له، وإذا كان وجود إله مع الله محالا، فنحن لا نقول أن الله يقدر أو لا يقدر أن يوجده، بل نقول إن القدرة لا تتعلق بالمحال، لما بينا أن القدرة صفة تأثير لا تتعلق إلا بالممكنات ولا يلزم على ذلك عجز أو غيره؛ لأن العجز يكون إذا تخلفت القدرة في إيجاد عما تصح أن تتعلق به وهو الممكنات كلها، أما أن تتعلق القدرة بالواجب أو المستحيل فهذا هو المستحيل بعينه لما يترتب عليه قلب الحقائق والماهيات كما بينا.
الثابت الكوني، ودليل وجود الله.
صار هناك اتجاه علموي مادي قائم على فكرة أنَّ الاكتشافات العلمية الحديثة أضحت لديها القدرة التفسيرية الهائلة لكل شيء في الكون، مما يستلزم أنه لا حاجة للدين [الله] بما قدَّمه من إجابات عن أسئلة كبرى تتعلّق بالكون والحياة.
عناية الإله
يُعَنْوِنُ السنوسي في عقيدته: باب: إقامة البرهان القاطع على وجود الله، وبيان احتياج العالم إليه جلّ وعزّ([29]).
وجاء في مقالات الإسلاميين: إنّ المعرفة بالله طريقها الاكتساب، والنظر في آياته، والاستدلال عليه بأفعاله([30]).
داخل إطار النظرية الفلسفية الإسلامية المطروحة في كتب علم الكلام تحدث علماء المسلمين عن دليل من أدلتهم في إثبات وجود الله، هذا الدليل يسمى (دليل العناية) (Guardianship of the Universe) والذي يعني: أنّ العالَمَ بجميع أجزائه موافقٌ في خلقه وتركيبته لوجود الإنسان، وكلُّ ما يوجد موافقًا في جميع أجزائه لفعل واحد، ويكون مسدّدا نحو غاية واحدة؛ فهو أثر لإرادة وحكمة.
وطريقة استدلال علماء الكلام التي تُسمى النظر في آياته بالاصطلاح التراثي تؤدي نفس المُؤدى الذي يتحصّل من ملاحظات التجريبين وما أدّت إليه من نتائج.
وحتى إنَّ القرآن الكريم حين عالج المحاور الكبرى في الاستدلال الكوني أثبت أن الحوادث التي كانت بعد أن لم تكن دالة بخصوصها على المُحدث المتصرّف فيها.
ففي الاستدلال العقلي الذي سلكه النبي إبراهيم -عليه السلام- في إثبات قضيّة الربوبية؛ ليكون من الموقنين، ذكر (الكوكب، والقمر، والشمس) كمثال على أن هناك خط مشترك بينها وهو (التغير) بمعنى: أنها تُوجد/ تظهر بعد أن لم تكن، وتنعدم/ تختفي بعد أن تكون. فلما كان ذلك كذلك فُهم أنّ أوّل صفة ينبغي أن تكون لربّ يُسيّر الكون ألا يكون متصفا بصفة هذه المتغيّرات (الحدوث)، بل ينبغي أن تكون له قدرة غير متناهية فلا يطرأ عليه التغير والحدوث أبدا.
وذِكر القرآن هذه الطريقة من الاستدلال ليس حصرًا للمثال، بمعنى: أن النظر في الكون والملكوت دالّ على وجود الإله، وليس قيد النظر في الكوكب والقمر والشمس فذكرهم على سبيل التمثيل.
وقد يتساءل البعض، لماذا لم يتحدث القرآن -مثلا- عن عمر الكون وعن عدد المجرّات والكواكب وقربها وبعدها عن الأرض وحصول تلك المعلومات لنا ضروري؟
أجاب إمام الحرمين الجويني عن هذا الإشكال بأمر بسيط وهو كما ذكر: “أن دلالة ملك الله تعالى، وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية، وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال، فإذن لا طريق إلى تحصيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا إلى نهاية ولا إلى آخر في المستقبل([31]).
أصبح من المقرر في الفيزياء الحديثة ما يُعرف بالمبدأ الكوسومولوجي Cosmological principle وهو عبارة عن مجموعة من الافتراضات التي تتعلق بتكوين الكون وبنائه، وهذا المبدأ يفترض بأن الكون متجانس ومتماثل المناحي.
تفترض النظرية العلمية الكبرى المعروفة بـ (الانفجار الكبير Big Bang) أنَّ توسع الكون قد بدأ في لحظة معينة من الماضي كان فيها ضغطه وكثافته هائلين. ترجع إلى (13.7) بليون سنة هي عمر الكون، ثمّ حدث تمدد وتوسع للكون، متعادلا في القوى الأربعة المُكوّنة له، وهي: (الجاذبية، والقوة الكهرومغناطيسية، والقوى النووية القوية، والقوى النووية الضعيفة)، بحيث يُنبئ ذلك عن دقّة متناهية في الكون حدث هذا الضبط العظيم بعد الانفجار الكبير بأقل من 1/ مليون من الثانية، مما يُقرر أنّ هناك إرادة عظمى تدخّلت لإحداث ثبات كوني، بحيث لو اختل ذلك لحدث انهيار المنظومة الكونية كلها.
تخيّل الفيزيائي ستفين وينبرغ (الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء 1979م) ما حدث بعد الانفجار الكبير بثلاث دقائق، وألّف كتابه الرائع: “الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون”، وشرح فيه كيف تمدد الكون وتناسق في تناغم شديد منذ اللحظات الأولى وتكوّنه مما يدلّ على أنه لم يكن عشوائيا بل العشوائية هي العكس.
فمثلا:
– لو كانت النسبة بين القوة النووية القويّة والقوّة الكهرومغناطيسية زائدة أو ناقصة -ولو بمقدار شعرة- لما تكوّنت النجوم على الإطلاق.
– لو كانت قوّة الجاذبية أكثر مما هي عليه ولو بمقدار بسيط جدًّا لانكمش الكون وتبعثر، ولما تشكّلت المجرّات والنجوم والكواكب.
يقول عالم الكونيات والفلك البريطاني مارتن ريس: “إنّ سرعة التمدد، والمحتوى المادي للكون، وقدرات القوى الأساسية، يبدو أنها قد كانت متطلَّبا أساسيًّا لظهور هذا الموطن الكوني الكبير الملائم”([32]).
بل إذا أخذنا -مثلا- (كوكب الأرض) الذي نعيش فيه، وكيف تكوّنت صلاحيّته للحياة، وكيف كان يمكن الحال لو لم يكن هناك (عناية) أو (نظام دقيق) مُنح للكون من إرادة عليا متسامية هي التي فطرت/ خلقت/ صنعت/ هذا الكون من عدم، فـ (فطرت الأرض) فكوكب الأرض على ما تُظهره الاكتشافات العلمية يوجد بجواره على نفس المجرّة كوكب أضخم منه بكثير (المُشترى) يقوم باجتذاب النيازك عن أن تقصد الأرض، وإلا كان كوكب الأرض مرمى للنيازك وتدَمّر بشكل كامل.
حجم الأرض لو كان أكبر لزادت الجاذبية مما يعني اجتذاب غاز الأمونيا والميثين السام، ولو كان أصغر لخفّت الجاذبية مما يعني التأثير على كمية المياه الموجودة على سطح الأرض.
قشرة الأرض لو كانت أغلظ مما هي عليه لأثّر ذلك على كميّة الأكسجين في الغلاف الكوني، ولو كانت أخفّ لزادت البراكين والزلازل… وهكذا.
فبحسب الفيزيائي البريطاني الشهير بول دايفيس أن الدراسة المتأنّية لقوانين الفيزياء تُشير إلى أن قوانين الكون متميّزة ومثيرة في: تماسكها وانسجامها وموثوقيّتها على ما فيها من التعقيد.
فالعلم بهذا التناسق العجيب، والتجانس البديع، والدقّة المتناهية، يخبرنا بأن هذا كله لم يكن عن صدفة عمياء، وأنَّ هناك عناية تقف خلف هذا كله، من قِبَل فاعل قاصد مريد.
وكما يقول أنتوني فلو في كتابه هناك إله:
تخيل أنك دخلت إلى غرفة في الفندق الذي تسكن فيه في رحلتك المقبلة، ووجدت أن جهاز التسجيل الموجود بجانب السرير يعزف المعزوفة الموسيقية التي تحبها، ووجدت أن اللوحة المعلقة أعلى السرير تشبه تمامًا اللوحة الموجودة أعلى المدفأة في بيتك، والغرفة ينبعث منها العطر الذي تفضله، فقمت بهز رأسك متعجبًا وألقيت حقائبك على الأرض. بعد ذلك اتجهت إلى الثلاجة الصغيرة الموجودة في الغرفة وفتحت بابها وحدقت في محتوياتها فوجدت مشروبك المفضل وقطعة الحلوى والكعكة التي تحبها، بل وجدت قنينة من نوع المياه الذي تفضله. بعدها، أدرت ظهرك للثلاجة ونظرت إلى المنضدة الموجودة في الغرفة فوجت عليها الكتاب الجديد لمؤلفك المفضل، وعندما ألقيت نظرة في الحمام حيث تصطف على الرف مواد الاعتناء بالبشرة وجدت أن جميعها من النوع الذي تستخدمه في العادة، وعندما قمت بتشغيل التلفزيون وجدت القناة التلفزيونية التي تفضلها.
مع كل شيء تشاهده في الغرفة تجد أنك أقل ميلًا إلى التفكير بأن كل حدث كان من باب الصدفة. أليس الأمر كذلك؟ وقد تتساءل كيف استطاع مدير الفندق أن يعرف كل هذه الأمور التفصيلية عنك. وقد تتعجب من هذا الإعداد الدقيق، حتى إنك تفكر مجددًا كم سيكلفك كل ذلك من مبالغ مالية، ولكنك بالتأكيد سوف تميل إلى الاعتقاد بأن شخصًا ما كان يعرف بقدومك([33]).
تعدد الأديان، وصعوبة الوصول للحق.
تتلخص إحدى أهم الإشكاليات الدينية المعاصرة في نقطة مهمة يتردد حولها الكلام كثيرا، وهي أنه يوجد في العالم حوالي 20 ديانة، كل ديانة منها تنقسم إلى طوائف ومذاهب وأغلب هذه الطوائف والأديان تكفر بعضها بعضًا، ومن أراد معرفة الدين الحق يصعب عليه جدًّا دراسة كل هذه الأديان والمذاهب وتمييز الحق من الباطل منها فيكفي لدخول الجنة ورضا الله مجرد الأخلاق الحسنة، والمعاملات الراقية بين الناس.
والحقيقة أنَّ حلّ هذا الإشكال يتلخص في معرفة أنّ الإنسان في طريقة بحثه عن الخلاص لا بد وأن يتجرّد عن كل العوائق التي تعوقه عن قبول الحقّ، لا سيما إذا كان صادقًا في بحثه.
والإشكالية المطروحة حول صعوبة التعرف على الحق وسط زخم شديد من الأفكار، وتعدد مفرط في الديانات، غالبًا ما يُفضي ذلك إلى سلوك السبيل إذا أقيمت الأدلة والبراهين على الحق لتمييزه عمّا عداه.
والتمييز بين الديانات والأفكار يقوم على إقامة الأدلة على صدق الدعوى التي يدّعيها المدّعي، فمتى ما أقيمت الحجة وجب الاتباع، فكل الديانات جاءت بدعوى أنّ هناك قوة خفية تتحكم في هذا العالم، واختلفت الأنظار في تفسير تلك القوة، فبين مفسر لها على أنّها قوة طبيعية تتحكم فيها الظواهر المختلفة المرتبطة بالتغيرات الفيزيائية في الكون، وبين مفسر لها على أنّها أحد الظواهر المتجلّية للبشر من أعلى، مما يبعث في النفوس إكبارها وإجلالها كالشمس والقمر مثلا، وبين مفسر لها على أنّها أحد الموجودات الحيَّة كالماء والريح والحيوان وهكذا، وبين مفسر لها على أنّها قوة غير مُتصوّرة لا بد من التعرف عليها، ويتوقف على التعرف عليها حتى يُقام له الدليل على صدق ذلك، وعلى كلِّ هذا عبد كل شخص ما رآه من هذه القوة أو عبدها.
القوة التي تُسير هذا الكون هي الطريق الموصل للتعرف على أَيّها هو الحق، هذه القوة جاءت الأديان بإقامة الأدلة على التعرف على كنهها، ونسميها تنزّلا قوة؛ لأنَّ الطباع تميل إلى إجلال ما لا تستطيع أن تضاهيه من القوى والسيطرات.
غالبًا ما يؤول البحث بالإنسان إلى الوصول للحق، والوصول للحق ليس صعبًا حتى مع اختلاف الأديان والمذاهب؛ لأنّ أغلب الأديان سترد إلى الأديان السماوية والمفاضلة بينها سهلة.
يتحدث القرآن عن الله في الأديان فيقول: ﴿۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا﴾ [النساء: 163]، ومعنى الآية أنّ الموحَى به إلى الرسول هو نظير ما أُوحي به إلى جميع الأنبياء السابقين، وما أوحي به إلى الأنبياء السابقين هو توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والمثيل باعتباره خالق هذا الكون ومُنشأه من العدم، والمستحق للعبادة كما سيأتي تقرير ذلك، فيقول: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].
فاتفق جميع الرسل في تبليغ الدعوة إلى توحيد الله بقول (لا إله إلا الله)؛ لأنها أصل كل شيء والباب الذي يفد منه الإنسان للتعرف على الخالق، فالله علم على الذات الواجب الوجود المحدث لجميع حوادث العالم؛ بدليل الحدوث كونها مُحدثة في احتياج إلى مُحدث.
قال تعالى: ﴿۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾ [الشورى: 13].
“فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله ﴿أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾ والمراد: إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه، وبيوم الجزاء، وسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلمًا، ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة. قال الله تعالى: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾”([34]).هـ.
ويترتب على ذلك استشكال آخر، وهو إذا كانت الأديان السماوية مصدرها واحدا لماذا تعددت؟
نقول إن الأديان لم تتعدد بالمعنى المصطلحي الذي يُفهم منه التباين؛ إذ كلها متفقة في أصل الدعوة وهي الدعوة إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وأنه الفاعل والمدبر في هذا الكون بمقتضى فردانيته وصمديته سبحانه، فاتفق جميع الأنبياء على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتنزيهه عن أي شريك أو شبيه أو مثيل، لكن الاختلاف والتعدد وقع في الشرائع بمعنى أن الشرائع مختلفة في بعض الأمور، ومعنى الشرائع هو ما سوى العقائد؛ فإنَّ الدين يتكون من جزأين: العقائد، والشرائع.
فالعقائد التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل متماثلة تمامًا بخلاف الشرائع؛ لأنها متغيرة بتغير العوامل الأربعة في الأحكام (الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال) فما يصلح لبيئة معيّنة قد لا يصلح للأخرى، وما يصلح لأشخاص بعينهم قد لا يصلح لغيرهم من آحاد الناس أو تجمعات البشر؛ فلزم أن تكون الشرائع مختلفة ومتنوعة نوعًا ما؛ لتواكب تطورات البشر، فإن الشرائع مبناها على المصالح، بمعنى أن يُلحظ فيها مصلحة البشر بما يحققها لهم ويدفع عنهم الفساد، لكن هذا لا يعكس فكرة أنّ المؤدَّى واحد.
لقد نالت نظرية داروين وهي نظرية التطور والارتقاء من الشهرة والذيوع في العالم ما لم تنله أية نظرية في العالم، وما لم تنله أية نظرية حديثة حتى اليوم.
وذلك بسبب احتكاك هذه النظرية المباشر بجوانب حساسة من معتقدات الناس وأفكارهم وآرائهم المتمركزة في نفوسهم حول خلق العالم وتكوين الإنسان والروح.
لقد هزت هذه النظرية دنيا العلم، وأشغلت عالم الفكر، وبعثت موجات من الغضب والاستنكار في محيط المتدينين.
كما أن هذه النظرية -في الوقت نفسه- أنعشت روح الإلحاد ووسعت المجال لدعاة التحلل -الإباحية- أن يقولوا أكثر مما كانوا يقولون.
فمنذ ظهور هذه النظرية والصراع حولها مستمر بين العلماء والمفكرين ورجال الدين، وخاصة عندما كانت السلطة الزمنية في يد رجال الكنيسة في أوروبا([35]).
ألقى داروين نظريته التي تلقاها ممن سبقوه إلى وضع أسسها؛ بإصداره كتابه أصل الأنواع الذي أصدره في عام 1859م، وحاول فيه أن يوجد تصورا شاملا مفسرا لنشوء الحياة على الأرض وانتشار الأحياء وتكاثرها وتنوعها، حتى وصلت إلى ما انتهت إليه اليوم من تنوع أجناسها، وكانت محاولته هذه قد آتته حظا في انتشار نظريته وقبولها عند فئة من الناس فور نشرها، وذلك يعود إلى أسباب عدة منها:
بساطة نظريته مع قدرته على عرضها بأسلوب يشد الانتباه، وقد جاءت في وقت سئم فيه الناس-في المحيط الغربي الناهض- تعاليم الدين وأصبحوا يقيسون الإنسان في عقله وتطوره بقدر انسلاخه منه، وقد وقر في نفوسهم أن العلم والدين ضدان لا يلتقيان.
وصادفت نظريته هذه هوى في أفئدة الذين اشتد عداؤهم للدين، وتصوروا أن خلاصهم في الإلحاد الذي يحررهم من تبعات الدين، ويخلصهم من أفكاره التي عدوها تخلفية، فآثروا كل ما يعزز جانب الإلحاد، ولو لم يكن قائما على دليل من العقل ونصيب من الفهم.
وقد قامت نظريته على أسس ثلاثة:
أولها: أن الكائنات لها أصل مشترك، فكلها تنحدر من كائنات حية بسيطة بدأت بها الحياة على وجه الأرض.
ثانيها: أن تغير الظروف الطبيعية والبيئية المحيطة بالكائنات الحية يؤدي إلى ظهور صفات جديدة تفرضها عليها تلك التغيرات.
ثالثها: وهو الأساس لفكره هو الاصطفاء الطبيعي الذي يختار من الكائنات ما تؤدي تغيراته إلى تحسين في نوعه، وإلى قدرة أكبر على البقاء في الظروف المحيطة الجديدة، بحيث تبقى الكائنات التي حظيت على اكتساب صفات تساعدها على العيش في البيئة المتغيرة، وعلى مقاومة الظروف المحيطة، وتتكاثر، وتنقل صفاتها المتميزة الجديدة إلى ذريتها، وذلك إبان انقراض الكائنات الأضعف، أو ذوات الصفات الأدنى، وقد افترض داروين أن الصفات المكتسبة المتميزة يمكن أن تنقل من الكائن الحي إلى ذريته.
وهذا يعني أن التدافع بين الكائنات من أجل البقاء أمر حتمي ينتهي بانتصار الأقوى على الأضعف، وأن الأقوى دائما هو الأصلح، فهو أولى بالبقاء، وعليه فإنه يستمر بقاؤه، وتتنامى قوته، بينما الأضعف يظل في انحسار حتى يتلاشى نهائيًّا، ومعنى هذا أن التطور في الكائنات إنما هو إلى الأحسن والأصلح والأقوى([36]).
إذن فنظرية التطور والارتقاء خلاصتها أن أنصارها يزعمون أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر هذه الأرض بجرثومة أو جراثيم قليلة تطورت من حالٍ إلى حال تحت تأثير فواعل طبيعية حتى وصلت إلى هذه التنوعات التي نراها وعلى رأسها الإنسان.
وعلى هذا فإن الإنسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بجرثومة صغيرة تحولت إلى حيوان صغير ثم تدرج هذا الحيوان إلى حياة حيوانية بدائية فإلى حيوانات أكبر فأكبر ريشية ومجنحة، ثم تحولت إلى ذوات فقرات، ثم ارتقت إلى حيوان أشبه بالإنسان، ثم كانت نهاية هذا التطور إنسانا أول، لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم ثم إنسانا كاملا وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه.
ويقولون إن هذه التحولات والتطورات والترقيات جاءت بعد صراع مرير بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة وتقلباتها وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض عبر آلاف القرون من أجل البقاء.
إذن فالتطور كلمة يقصد بها التحول والانتقال من شيء إلى آخر كما يراد بها الظهور التدريجي لشيء من شيء آخر، وهو عندهم ينقسم قسمين، تطور غير شامل (عضوي) وتطور شامل (عام) فالتطور العضوي يعرف بأنه مفهوم يتضمن الاعتقاد بأن الحيوانات والنباتات تكونت من أشكال سبقتها نتيجة تحول تدريجي مستمر وهو ظاهرة طبعية تعني تغير صورة الكائنات الحية وظهور أنواع وأشكال جديدة منها، أما التطور الشامل (العام) فأشهر القائلين به، هربرت سبنسر، وقد عمم أصحاب هذا الاتجاه تطبيق التطور بهذا المفهوم على الكون كله بما اشتمل عليه من مادة وقوة وبما فيه من كائنات حية وغير حية، وهو يعني: انتقال من البسيط إلى المركب وتغاير تدريجي من الوحدة النوعية إلى الاختلاط والتكاثر النوعي، أو هو ارتقاء من حالة التجانس التركيبي إلى التنافر فيه([37]).
ويمكن تلخيص مذهب التطور النوعي في العناصر الآتية:
1- قابلية الأنواع للتغير ونزوعها إليه، وهذا العنصر يعتبر حجر الزاوية في نظرية داروين.
2- توجد في الطبيعة اختلافات في الأنواع والأفراد.
3- عن طريق النسبة الهندسية لمعدل زيادة الأفراد التي تحدث نتيجة الكوارث فإن عدد أي نوع يجنح نحو الزيادة المطردة، ولكن العدد النهائي في الواقع يبقى ثابتًا بسبب موت العديد من الأفراد، وفي ظل هذه الظروف يحدث:
- تنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة.
- بقاء الأصلح أو الانتخاب الطبعي.
- التكيف مع البيئة.
- وراثة الصفات الملائمة.
- الأصل الحيواني للإنسان.
وهذه العناصر جميعها قد أثيرت قبل داروين وتناولتها الأبحاث العلمية والتأملات الفلسفية النظرية، ولكن داروين هو الذي استطاع أن يقوم بجمعها في صورة رائعة وعمل متكامل في أبحاثه عن أصل الكائنات الحية وتطورها في دقة وصبر وأناة([38]).
أول المؤسسين لنظرية التطور والارتقاء:
مؤسسو نظرية التطور والارتقاء وقطبا رحا هذه النظرية اثنان:
- لامارك وهو مؤسسها.
- داروين وهو مطورها وحامل لوائها وباذل عمره في سبيل تعضيدها ونشرها.
إلا أن القائلين بنظرية التطور والارتقاء مع اتفاقهم على أصول هذه النظرية، فإنهم يختلفون من حيث النتاج الفلسفي للنظرية.
آراء العقيدة الدينية
ففريق منهم قد جعل من هذه النظرية منطلقًا للدعوة إلى الإلحاد وجعلها سندًا له في إنكار العقيدة الدينية، واتخذ منها فلسفة لنفي الخالق سبحانه وتعالى وأعطى المادة صفة القادر على كل شيء، وعلى رأس هذه الفريق الفيلسوف الفرنسي لامارك والعالم الألماني أرنست هيكل والبروفسور الشيوعي أوبارين وغيرهم من ماديين وشيوعيين.
وفريق لم يستند إلى هذه النظرية في إنكار العقيدة الدينية ولم يجعل منها قاعدة للدعوة إلى الإلحاد وإنكار الخالق سبحانه وتعالى، ولم يزعم أنه بها يفسر سر الحياة أو سر الكون، وإنما كان همه الوحيد البحث عن أصل الأنواع الحية وتكوين فكرة عن أصل نشأتها وصلة بعضها ببعض، ومعرفة الأحوال والمؤثرات والتقلبات التي تعرضت لها عبر آلاف القرون، وعلى رأس هذا الفريق العالم الشهير تشارلز داروين([39]).
الإلحاد ونظرية التطور:
يزعم الجناح الإلحادي من أنصار هذه النظرية أن الحياة الأولى جاءت نتيجة تفاعل طبعي بين أجزاء من المادة، هذه المادة التي يزعمون أنها كانت ولم تزل قادرة بطبعها على إعطاء الحياة، ولهذا فهم ينكرون أن تكون الحياة من صنع قوة فوق الطبيعة.
فهذا الجناح الإلحادي عندما يتحدث عن مراحل التطور والارتقاء يخرج من حسابه قوة ما فوق الطبيعة وهي القوة الإلهية؛ لأن حالة المادة بزعمهم لا تحتاج إلى هذه القوة، فالطبيعة الملازمة للمادة بحركتها الدائبة هي التي تخلق وتبدع وتنوعت وتطور وتصطفي وتبيد([40]).
هذا والطبيعة عند لامارك هي القوة العامة الملازمة للمادة المنزهة عن الفساد التي لا تفتر عن التأثير في المواد طرفة عين، غير أنها مجردة عن العقل ومحكومة بقوانين هكذا يقول لامارك.
وإذا كان داروين أعلن عجزه عن معرفة سر الحياة وكيف ومما تكونت؟ فإن لامارك يزعم أنه قد عرف كل ذلك عن الحياة.
فهو يزعم أن الحياة قد تكونت من المادة مباشرة بفعل الطبيعة وعلى سبيل المصادفة، وذلك بعد عملية مزج مواد مخصوصة بعضها ببعض يقول:
إن الطبيعة تولد بعض الكائنات توليدا مباشرا، فتعمد إلى تكوين منسوج خلوي من الكتل الصغيرة للمادة الجلاتينية التي نجدها تحت يدها، ثم تملأ هذا الكتل الخلوية الصغيرة في الأحوال الموافقة بالسوائل المناسبة وتحييها بتحريك هذه السوائل بواسطة سوائل ألطف منها طبيعتها التهييج تأتيها على الاستمرار من البيئات المحيطة.
ويقول عن قوة الحياة: إنها ليست بقوة خاصة وإنما هي نتيجة خاصة لبعض المركبات، وجودها وقتي فيها، وأن الأنواع الحية لم تتكون إلا شيئا فشيئا، ووجودها نسبي وبقاؤها محدد، والطبيعة في تكوينها الحيوانات بدأت من الأدنى فما فوقه حتى انتهت إلى الأعلى، ولا فرق في ذلك بين النباتات والحيوانات إلا في الحس، والحياة عند لامارك عرض طبعي وليست بأصل مستقل([41]).
إن نظرية التطور تحمل عند البعض نزعات إلحادية، وبعض الذين يرون صحتها تذهب بهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى فهم يرون أنها تعتمد في المقام الأول على إنكار الله وأنه ليس ثمة خالق لهذا الكون وأن الكائنات تم خلقها بواسطة الطبيعة وأنها نشأت عن أصل واحد، وأنها تكونت بخلق الطبيعة وبالتولد الذاتي، وأن هذا التنوع والتعدد الذي نراه ما هو إلا نتيجة التطور الذي نشأ نتيجة الصراع بين الكائنات والطبيعة من جهة وبينها وبين بعضها من جهة أخرى، وأن هذا الصراع ولدته حاجة الكائن للبقاء، ولم يبق من الكائنات إلا أقواها وأصحها، وهذا كله أي التوالد وتطور الكائنات جاء من انتخاب طبعي واصطفاء نوعي، وليس ثمة داع لوجود إله خالق لهذه الكائنات، لأن الذي تولى تنظيم هذا كله المادة ليس غير، والتطوريون خلعوا على هذه المادة كل أوصاف الإله وخصائصه([42]).
لكن في الوقت الذي ينادي فيه فلاسفة النزعات الإلحادية بالحتمية وبضرورة الربط بين الأسباب والمسببات، ويرون أن العلاقة بينهما ضرورية ولا انفكاك بينهما، نجد أن هناك تناقضًا واضحًا وصريحًا بين مبادئهم التي أعلنوها وقوانينهم التي قننوها وبين دعائم مذاهبهم وما تقوم عليها من نظريات، وأن هذا يتضح جليًّا في مذهب النشوء والارتقاء الذي يفتقر إلى معرفة السبب الكامن وراء التغيرات، ويكفي أن يكون الجهل بهذا السبب تقويضا لصرح هذه النظرية.
يقول جون كيمني عن نظرية النشوء والارتقاء واحتياجها إلى معرفة السبب الكامن وراء التغيرات:
هناك اتفاق عام بأن هنالك فيضًا من الكائنات الحية يؤدي إلى تنازع البقاء، وبالتالي إلى عملية انتخاب طبيعي، تقوم بالحفاظ على الأفراد الذي تستبين لديهم مميزات بالنسبة لأقرانهم، كما أن هنالك اتفاقا بأن هذه الفروقات متأتية من تغيرات في الصبغيات أو من التحولات الفجائية، غير أن الخلاف هو في السبب الكامن وراء هذه التغيرات([43]).
ومن ناحية أخرى فإن مذهب التطور إذ ينكر وجود إله يدبر أمر هذا الكون فإنه يناقض نفسه حين ينادي بالتطور المنتظم المتقدم نحو غاية عليا، نعم هو تناقض صارخ إذ يستحيل في العقول والتي دائما ما يتمسح فيها أرباب تلك المذاهب في نكرانهم للعقائد الدينية أن يخرج الأعلى من الأدنى فهذا توهم ظاهر.
ونحن بدورنا لا ننكر أن يكون هناك تطور، والأديان في جملتها لا تنكر التطور فهو بمثابة السنة الكونية الطبعية التي لا تتخلف، لكن التطور الذي تقره الأديان ليس بهذا المفهوم الذي تقول به نظرية التطور الذي يعتمد على الصدفة والعشوائية وليس له وجهة أو غاية.
وتلقي الحيرة بظلالها على الإنسان عندما نجد داروين نفسه لا ينكر الإله الخالق فيقول فيما ينقله عنه إسماعيل مظهر من كتابه أصل الأنواع:
هنالك مؤلفون من ذوي الشهرة وبعد الصيت مقتنعون بالرأي القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة، أما عقليتي فأكثر التئامًا مع المضي مع ما نعرف من القوانين والسنن التي بثها الخالق في المادة، والاعتقاد بأن نشوء سكان هذه الأرض وانقراضهم في الحاضر والماضي يرجع إلى نواميس جزئية مثل النواميس التي تحكم في توليد الأفراد وموتهم.
وعند النظر في كتاب داروين (أصل الأنواع) تجد فيه بعض العبارات والجمل التي تستوقفك متسائلا هل كان مؤمنًا بالخلق أم لا؟ وإذا كان مؤمنًا فلم قال بهذه النظرية؟ وإذا لم يكن مؤمنا فلم قال هذه العبارات؟!
من هذه العبارات قوله «فإذا اعتقد معتقد أن هذه الأنواع قد خلق منها مستقلا، فلا يسعني إلا أن أعتقد أن كلا منها خلق وفيه نزعة إلى التحول؛ سواء أكان بتأثير الإيلاف أم بتأثير الطبيعة الخالصة -ثم يعقب على من يقول بالخلق استقلالا- وما هذا الزعم إلا تبديل غير ثابت بثابت، أو على الأقل غير معروف بمعروف، فهم يشوهون صبغة الله وخلقه».
ونراه يختم كتابه بقوله «إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها لأول مرة».
هذه الجمل أثارت تعجب كثير من الباحثين، وأثارت تساؤلهم «هل كان ذلك خطة مداهنة ومصانعة للمؤمنين بالله حتى لا يثوروا عليه، ويرفضوا آراءه جملة وتفصيلا، أو كان من المؤمنين بالله إيمانًا نصرانيًّا، ولا سيما وهو خريج دراسات لاهوتية، إلا أن الملاحدة واليهود قد استغلوا مذهب التطور لتأييد المادية وإنكار وجود الخالق من وجهة نظرهم».
وقد تزول هذه الحيرة أو تزداد عندما نرى كاتبًا بحجم العقاد ينفي عن داروين نزعة الإلحاد وإنكار الإله، وأنه ليس في مذهبه ما يدل على ذلك غاية الأمر عنده الشك في الديانات التقليدية، يقول:
لقد هوجم المذهب كثيرًا باسم الدين، وجعله بعضهم مرادفًا للإلحاد والمادية، ومع هذا لم يكن والاس ولا داروين ملحدين معطلين، وكان والاس شديد الإيمان بالله، خامرته الشكوك في الديانة التقليدية، ولم تخامره في الإيمان بالله وبحكمته، ومن كلامه ما يستدل به على تصديق المعجزات وخلود الإنسان، أما داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي وجود الله، ولم يقل قط إن التطور يفسر خلق الحياة، وغاية ما يذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتية.
وقد استدل العقاد على ما ذهب إليه بإجابة داروين عن سؤال وجهه إليه طالب هولندي عن عقيدته الدينية فقال:
إن استحالة تصور هذا الكون العظيم العجيب وفيه نفوسنا الشاعرة قائما على مجرد المصادفة هي في نظري أقوى البراهين على وجود الله([44]).
يقول يوسف كرم:
وقد أخذ على داروين أن نظريته ماديَّة إلحاديَّة، والواقع أنه لم يشأ أن يستثنى الإنسان من قانون التطور العام، وقد كان مؤمنًا بالله إلى وقت ظهور كتابه أصل الأنواع، وقال في ختامه إن الصور الحية مخلوقة، ثم تطور فكره شيئا فشيئًا حتى أعلن أسفه لاستعماله لفظ الخلق مجاراة للرأي العام، وصرح بأن الحياة لغز من الألغاز وأن ما في العالم من ألم يعدل بنا عن القول بعناية إلهيَّة وأنه هو “لا أدري” لا يقول بالعناية ولا بالصدفة([45]).
ومن هنا فقد برز من يقول بأن التطور لا يتناقض مع الأديان من جهة ومع القرآن من جهة أخرى.
يقول الدكتور باسل الطائي وسوف ننقل كلامه هنا بتمامه:
من الشائع القول بأن فكرة التطور العضوي للإنسان والكائنات الحية تتعارض مع الدين، وسبب ذلك أن التفاسير التي قدمها الناس للنصوص الدينية تقضي بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية من التراب هكذا مرة واحدة، وخلق الإنسان من الطين بعد أن جعله مناسبًا لتشكيل هيئة الإنسان وصورته التي هو عليها، وحتى عهد قريب كان الناس يعتقدون أن الحشرات والديدان والنمل نشأ ذاتيًّا عن المواد غير الحية، وهذا ما كان يعتقده أرسطوطاليس وكثير من حكماء اليونان.
من جانب آخر يقرر القرآن الكريم على وجه الخصوص أن الله تعالى خلق الإنسان من الطين، ويؤكد ذلك ظاهر الآيات القرآنية الآتية:
﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59].
وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ﴾ [الحج: 5].
وقوله: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٞ تَنتَشِرُونَ﴾ [الروم: 20].
وقوله: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ أَزۡوَٰجٗا﴾ [فاطر: 11].
وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا﴾ [غافر: 67].
فهذه الآيات تؤكد أن الخلق كان من التراب وعلى وجه الدقة يشار بذلك إلى خلق آدم نفسه، أما بعد آدم فالخلق يكون من النطف، وهنا نقف على مسألة أساسية في فهم الخلق من التراب في القرآن، فقد جاء هذا المفهوم على مستويين الأول: أن يكون القصد خلق آدم الإنسان الأول، وهذا يقود إلى اعتبار ألف لام التعريف للعهد، والثاني: أن يكون قصد به خلق الإنسان أي جنس الإنسان وذلك من خلال الدورة الغذائية التي أصلها التراب والماء، والذي يصير نباتًا يأكله الناس أو الحيوان، فيكون غذاء ينشأ عنه المني والبيضة التي يكون منها الإنسان.
على أن النظر الدقيق في هذه الآيات يبين أن القرآن الكريم يخفي تعابيره في قضية الخلق على نحو يجعلها قابلة للتفسير بأكثر من وجه، وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله: القرآن حمَّال وجوه.
وهذه هي المتشابهات التي أقرها القرآن في قوله تعالى من الآية السابعة في سورة آل عمران: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾ [آل عمران: 7].
وهذه مسألة يقرها جميع المفسرين فالقرآن يحمل المحكم والمتشابه، أما المحكم فهو في الأوامر والنواهي والحدود، وأما المتشابه فهو ما جاء أغلبه في الأمور الغيبية والعقائدية والأمور التي تخص نشوء العالم والإنسان بمعنى أن للنص القرآني أكثر من معنى يمكن أن يحمل عليه، وهذا أمر معروف وهو ما فتح الباب لطرح أفهام مختلفة لمعاني الآيات القرآنية وهو ما سمي بالتأويل إلا أن من الواجب القول بأن البعضَ يتأول القرآن تأولًا يخرج النص عن القصد حتى لكأنه يحتمل معنى مناقضًا تمامًا لما يتبادر للذهن، والتفسير أو البيان الصحيح للمعنى ينبغي دومًا أن يلتزم بما تقرره اللغة العربية، وما يقرره سياق النص أيضا، والسبب في أن القرآن حمال أوجه يعود لكونه قد احتوى المعرفة المطلقة في وعاء اللغة العربية، فتمت صياغة تلك المعرفة المطلقة بكلمات وجمل عربية جاءت في صياغة تحتوي المعاني الدقيقة على وجهها الحقيقي، فكان لا بد أن تكون تلك الصياغات مموهة؛ لأن معرفة الإنسان في أي عصر من العصور لم ترقى لأي حال من الأحوال إلى معرفة الخالق نفسه. بل هي في تطور مستمر وكلما تقدمت معارف الإنسان تم الكشف عن معانٍ أخرى لآي القرآن، وهكذا يكون القرآن معجزة دائمة على مر الزمان، وعلى الذين يريدون الاستفادة من هذه المعجزة الدائمة تقليب الوجوه كلها وتثويرها، ولكن بالضرورة ضمن ما هو معهود من معانٍ ودلالات تقرها اللغة ويوحي بها السياق.
من المنطقي القول بأنه لم يكن بالإمكان الإفصاح عن المضامين المتعلقة بالخلق وغيره من المسائل التي هي على قدرٍ كبيرٍ من التطور في الفهم، والكشف لأهل عصور لا تفهم تلك المضامين ولا تتقبلها، فلو أن القرآن أفصح القول في تلك المسائل فتطلب الأمر كثيرًا من الشرح والتقديم لعلوم كثيرة ومعارف جديدة ولعجز الناس عن تقبله وفهمه؛ لذلك تبدو الآيات التي تتعرض إلى هذه المواضع مبهمة، فنحن نعرف المعاني غالبًا على وجه الإجمال، ولا نستطيع القطع بالتفصيل، ومثال ذلك أيضًا ذكر السماوات السبع وخلقها ومصيرها فقد عرضت آي القرآن في هذه المسائل نصوصًا محيرة، ولتفسيراتها وجوه كثيرة، ونحن لا نستطيع القطع بأي منها بل يبقى أمامنا أن نقبل بعضها على أنه ممكن فحسب.
وقد قمت ببحث هذه المسألة تفصيلا، بالمشاركة مع زميل لي متخصص في اللغة العربية وآدابها وقد تم نشر البحث في مجلة أكاديمية محكمة، وقد وجدنا من خلال النظر المتفحص أن متشابه القرآن جاء في أمور لا يمكن الحديث فيها، على وجه التفصيل المفهوم لكل عصر وزمان، بل هو في مسائل تتطلب تطورًا معرفيًّا متقدمًا في الغالب، وهذا ما لم يكن لتتحمله أفهام العصور السابقة.
السبب الآخر الذي يمنع كثيرا من الناس من قبول فكرة التطور العضوي للكائنات الحية بما فيها الإنسان هو الظن بأن الاعتراف بالتطور الطبيعي يتضمن القول بنفي القدرة الإلهية في الخلق وإنكارها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإلحاد؛
إذ يقول المؤمنون وماذا يبقى لله في الخلق؟! والحق أن الفهم الصحيح لأمر الله في العالم ووجوده يقرر أن (الأمر كله لله)، وما هذه المظاهر والميكانيزمات (الآليات) التي تبدو أفعالًا طبيعية كما يقال إلا مظاهر تخفي وراءها حقيقة أن (الأمر كله لله) فهو الحي القيوم.
والقوانين التي تعمل بها الآليات الطبيعية (والتي أحب أن أسميها السنن الفطرية) إنما ترتكز في جوهرها إلى الاحتمال وليس إلى الحتم، كما بينت في فصول سابقة، هذا ما تقرره الفيزياء المعاصرة على سبيل القطع في نظرية الكموم، ولما كانت قوانين الكيمياء وعلوم الحياة التي تفسر الفعاليات الحيوية مرتكزة إلى قوانين الحركات الذرية والجزيئية، فإن هذا مآله أن قوانين الكيمياء الحيوية والتحولات الأحيائية هي قوانين جوازية احتمالية في نتائج عملها وليست حتمية، وهذا ما أثبته العلوم الحديثة ومكتشفات القرن العشرين، وحين نعلم أن عدد الاحتمالات المتيسرة أمام أية عملية حيوية عادة ما يكون كبير جدا، جاز لنا بالتأكيد أن نتساءل عمن يتحكم بتلك الاحتمالات ويسوقها إلى التحقق بالنتيجة التي تكون عليها، ومن المؤكد أن أية جزئية من جزئيات العناصر المتفاعلة لا يمكن أن تمتلك مثل تلك القدرة على التحكم الشمولي إذ لا بد من أن يكون عنصر التحكم ملما بكافة الأجزاء وخصائصها عالما خبيرًا بكل شروطها ودقائقها، مهيمنًا على جميع سبلها وغاياتها؛ لكي يقع أمامنا تطور إيجابي متصاعد كالذي نشهده فعلا، ولن يكون ذلك إلا لقدرة عليم حكيم خبير، لذلك نقول أن (الأمر كله لله).
وهنا يحضرني قول الفيزيائي البريطاني بول ديفز إذ يقول في كتابه عالم الصدفة:
إن تفسيرًا منطقيًّا للحقائق يوحي بأن قوة هائلة الذكاء قد تلاعبت بالفيزياء، بالإضافة إلى الكيمياء وعلوم الحياة، وأنه ليس هنالك قوة عمياء في الطبيعة تستحق الحياة بصددها، فأي قوة عمياء وأية عشوائية يمكنها أن تجد كل هذا النظام والرقي التكويني الذي نراه في العالم([46]).
ثم يتابع الدكتور باسل الطائي حول مبدأ التطور والقرآن فيقول:
سأقدم فيما يلي اجتهادي لفهم النصوص القرآنية فيما يتعلق بمسألة خلق الإنسان، وغايتي في ذلك تحري الحق وتبصير النفس والعقل بنور الحق ليرتقيا إلى مراقي الفهم الصحيح ومنهجية النظر في هذا البحث تقوم على مراجعة النصوص القرآنية المتعلقة بخلق الإنسان ونشأته وتطوره واعتماد اللغة لتفسيرها وفهمها والاستعانة بتفاسير القرآن المعتمدة لدى المسلمين، وأشهرها تفسير ابن كثير، ولسوف أعرض لما جاء في القرآن مقدما ما جاء بأشهر التفاسير عنها لغرض الاطلاع على ما كان قال به السلف.
جاء في سورة الحجر من الآية 26 ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ﴾. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية:
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال هاهنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى ﴿خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ كَٱلۡفَخَّارِ١٤ وَخَلَقَ ٱلۡجَآنَّ مِن مَّارِجٖ مِّن نَّارٖ١٥﴾ [الرحمن: 14- 15]، وعن مجاهد أيضًا: الصلصال المنتن، فتفسير الآية بالآية أولى، وقوله ﴿مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ﴾ [الحجر: 26]؛ أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس، ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال هو التراث الرطب، وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا والضحاك: إن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد بالمسنون: المصبوب.
ما نشير إليه هنا أن معنى الحمأ المسنون يحتمل أن يكون هو التراب الندي النتن القديم، وهذه المعاني هي في أصول كلمتي صلصال وفخار، يقول ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة
الصاد واللام أصلان أحدهما يدل على الندى وماء قليل، وآخر على صوت.
وقال في معنى مفردة الفخر:
“الفاء والخاء والراء أصل صحيح يدل على عِظَمٍ وَقِدَمٍ… ومما شذ عن هذا الأصل الفَخَّارُ مِنَ الْجِرَارِ ، معروف”.
من الواضح أن هنالك شيء من التوافق بين النص القرآني في نشأة الحياة، وما تقترحه البيولوجيا التطورية فإذا كانت الكائنات قد تطورت عن أخرى وحيدة الخلية، أو عن المحاليل العضوية وتراب الأرض، فها هي إذن يسميها القرآن الحمأ المسنون، ثم جاء في الآيتين 28، 29 من سورة الحجر ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ٢٨ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ٢٩﴾ [الحجر: 28- 29].
نلاحظ هنا أن أمر الله للملائكة بالسجود للإنسان معلق على شرط تسويته والنفخ من روح الله فيه بقوله فـ (إذا) أأأي أن سجود الملائكة تالٍ للخلق ومشروط بالتسوية والنفخ، وهذا أمر مهم يتوجب الانتباه إليه ورب من يرى أن الآية التي ذكرناها هنا لا تفيد بوضوح ما إذا كانت التسوية والنفخة حصلت على التراخي أم على العجلة، لكن الجواب على ذلك واضح، بين، في سورة السجدة كما سيأتي بيانه، وفي التسوية يورد الحافظ ابن كثير في تفسيره ما يفيد أن معناها هو أن يجعل مشية الإنسان مستقيمة على قدميه فيقول:
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بشر بن جحاش قال: ((بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال: يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق؟ وأنى أوان الصدقة)).
الشاهد في هذا الحديث هو الإشارة الصريحة على استقامة الإنسان على طوله، قد جاءت كمرحلة تطوره، لكن السؤال: هل أن هذه الإشارة هي إلى نوع الإنسان أم هي للإنسان الفرد؟ الأرجح في ظاهر القول أنها للإنسان الفرد، لكننا سنرى أن القرآن يورد التعديل بالمضمون قصد به نوع الإنسان نفسه، من سورة المؤمنون الآية 12 في قوله: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾ [المؤمنون: 12].
هنا نقف على تعبير مهم ذي شأن في اعتبار الخلق، وقصده ذلك أن الآية قد أوردت مفردة (سلالة) وهذه واحدة من آيتين وردت فيهما المفردة، إذ نقرأ في السجدة ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ﴾ [السجدة: 8].
فما معنى السلالة هنا؟ في اللغة نقرأ في لسان العرب:
والسلالة: ما انسل من الشيء. ويقال: سللت السيف من الغمد فانْسَلَّ. وانسل فلان من بين القوم يعدو إذا خرج في خفية يعدو. وفي التنزيل العزيز:
﴿ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمۡ لِوَاذٗا﴾ [النور: 63]؛ قال الفراء: يلوذ هذا بهذا يستتر ذا بذا؛ وقال الليث: يتسللون ويَنسَلُّون واحدٌ. والسليلة: الشعر ينفش ثم يطوى، ويشد ثم تسل منه المرأة الشيء بعد الشيء تغزله. ويقال: سليلة من شعر لما استل من ضريبته، وهي شيء ينفش منه ثم يطوى ويدمج طوالا، طول كل واحدة نحو من ذراع في غلظ أسلة الذراع ويشد ثم تسل منه المرأة الشيء بعد الشيء فتغزله. وسلالة الشيء: ما استل منه، والنطفة سلالة الإنسان… وفي التنزيل العزيز: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾ [المؤمنون: 12]؛ قال الفراء: السلالة الذي سل من كل تربة؛ وقال أبو الهيثم: السلالة ما سل من صلب الرجل وترائب المرأة كما يسل الشيء سلا. والسليل: الولد سمي سليلا لأنه خلق من السلالة. والسليل: الولد حين يخرج من بطن أمه، وروي عن عكرمة أنه قال في السلالة: إنه الماء يسل من الظهر سلا؛ وقال الأخفش: السلالة الولد، والنطفة السلالة؛ وقد جعل الشماخ السلالة الماء في قوله: على مشج سلالته مهين.
قال: والدليل على أنه الماء قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ﴾ [السجدة: 7]، يعني آدم ثم جعل نسله من سلالة، ثم ترجم عنه فقال: من ماء مهين؛ فقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ﴾ [المؤمنون: 12]؛ أراد بالإنسان ولد آدم، جعل الإنسان اسما للجنس، وقوله ﴿مِّن طِينٖ﴾ أراد أن تلك السلالة تولدت من طين خلق منه آدم في الأصل، وقال قتادة: استل آدم من طين فسمي سلالة، قال: وإلى هذا ذهب الفراء؛ وقال الزجاج: من ﴿سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾، سلالة فعالة، فخلق الله آدم عليه السلام([47]).
نستنج من هذا أن السلالة وهي ما يسل وهي التي على وزن (فعالة) إنما يمكن تفسيرها على أنها النطفة ولو قال تعالى سلالات، لكان المعنى المرجح أنها أجيال، ولكن يصح القول أيضا أنه ربما منع قوله سلالات أن سلالة الإنسان مفردة بمعنى أن تطوره لم يكن إلا عن سلالة واحدة تسلسلت من جيل إلى جيل، حتى بلغ مرحلة التسوية أي جعله سويًّا في المبنى والمعنى والخلاصة فيما أجد أن السلالة التي في الآية من سورة المؤمنون ربما قصد بها أجداد الكائن الذي صار إليه جنس الإنسان، وأما السلالة التي في السجدة فلعل القصد منها النطفة؛ وهي التي تنسل من الماء المهين الذي يحف النطف، وذلك عندي بين من التركيب، يقول الله تبارك وتعالى:
﴿ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ٨ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفِۡٔدَةَۚ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ٩﴾ [السجدة: 7- 9].
فيه هذه الآيات ترتيب تسلسل الخلق وهو هنا على ثلاثة مراحل البدء من الطين، وسبق قوله: إن هذا الطين رطب منتن قديم (صلصال كالفخار)، وفي موضع آخر هو الطين اللازب أي الذي يلتزق باليد، ثم التكوين المتناسل من ماء مهين، وهذا لا يكون إلا لأنواع الحيوانات العليا أيضا، فالبدائيات لا تتماثل بالماء المهين، بل بالانقسامات المتكررة، لذلك كانت ضرورة وجود (ثم). فهذه المرحلة ربما حصلت على التراخي الزماني ثم التسوية (وهي التعديل والاستقامة) فالنفخة من روح الله والتي بها صار الكائن الأول إنسانا.
ويجب الانتباه إلى أن (ثم) في اللغة تفيد التعاقب على التراخي، أي مرور زمن ليس بالقليل، أما اعتبارنا التسوية على أنها التعديل وتحقيق استقامة البدن، فإشارتها في قوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ٦ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ٧﴾ [الانفطار: 6- 7].
كما أن الحديث القدسي الذي أورده ابن كثير وذكرته آنفًا يتعلق بهذه المسألة، ويعني أنه يفسر معنى التسوية باعتدال القامة وهذا يتوافق أيضا مع القول بأن التسلسل التطوري السابق للإنسان يبين أنه كان يمشي على أربع، ثم استقام واعتدل، أما النفخ من روح الله، من قوله تعالى ﴿وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: 29] فهي التي نقلت الكائن السابق للإنسان تطوريا إلى حالته كإنسان، وذلك حين امتلك العقل والقدرة على الإبداع، فتحول من كائنٍ غير عاقل إلى آخر عاقل، قادر على الإبداع والاختراع، وبذلك استحق سجود الملائكة له.
وهذا السجود هو حركة رمزية تعبر عن الخضوع والذل، ويتضح هذا من المعنى اللغوي للسجود؛ إذ يقول ابن فارس في معجم المقاييس: (السين والجيم والدال أصل واحد يدل على تطامن وذل، وكل ما ذل فقد سجد).
وسبب ذلك أن الملائكة هم جند الله ورسله الذين بهم يقوم العالم، والذين بهم يسير الله العالم، وسجودها لآدم يعني أن آدم قد خول ناصيتها وهيمن عليها، وتمكن منها بالقوة أولا، وبالفعل لاحقًا، فالله قد أعطاه القدرة على الإبداع والتركيب بالنفخة من روحه القدسية، التي نفخها فيه، وللإنسان أن يستثمر هذه أو لا يستثمرها، وقد جاء أمر الله بسجود الملائكة لآدم بعد أن كمل خلقه وتصويره والنفخ فيه من روح الله وتعليمه الأسماء، في سورة الصافات قوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۢ١١﴾ [الصافات: 11].
يقول ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد، وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد.
وهنا الإشارة في الآية بليغة من حيث أن أول الخلق كان ماء وطينًا، وهذا إنما يتفق إجمالا وليس على نحو التفصيل بالضرورة مع نشأة الحياة الأولى بحسب التصور المعاصر الذي جاءت به العلوم الأحيائية.
وفي سورة الإنسان قوله تعالى ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡٔٗا مَّذۡكُورًا﴾ [الإنسان: 1]، في الآية تساؤل واضح يحمل معنى الإخبار أن العالم كان والإنسان لم يكن بعد، فلهذه الآية تفاسير كثيرة ويورد الطبري في تفسيره أن الاستفهام هنا غرضه تقرير الواقعة، لكن المشكل هو في تحديد الزمن المقصود بهذا الدهر الذي مر على الإنسان دون أن يكون شيئا مذكورًا، وتجمع التفاسير تقريبًا على أن المقصود بالإنسان هو جنس الإنسان، أما بشأن الحين من الدهر المقصود وطوله ففيها قليل من الأقوال، وجدت أفضلها ما ذكره الماوردي في النكت والعيون إذ يقول:
وفي قوله تعالى: ﴿حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ﴾ [الإنسان: 1] ثلاثة أقاويل: أحدها:
أنه أربعون سنة مرت قبل أن ينفخ فيه الروح، وهو ملقى بين مكة والطائف، قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه.
الثاني: أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة، ثم من حمأ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة، فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة، ثم نفخ فيه الروح، وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. الثالث: أن الحين المذكور ها هنا وقت غير مقدر وزمان غير محدود، قاله ابن عباس أيضًا([48]).
سورة الانفطار قوله تعالى ﴿ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: 7].
قال الفخر الرازي:
وقال عطاء عن ابن عباس جعلك قائمًا معتدلًا حسن الصورة لا كالبهيمة المنحنية، وقال أبو علي الفارسي: عدل خلقك فأخرجك في أحسن التقويم وبسبب ذلك الاعتدال جعلك مستعدًّا لقبول العقل والقدرة والفكر وصيرك بسبب ذلك مستوليًا على جميع الحيوان والنبات وواصلًا بالكمال إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم([49]).
مما يعني أنه يسوق القصد إلى جنس الإنسان ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره:
أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال.
بهذا نفهم أن التسوية والتعديل تشتمل على استقامة الجسد واعتدال القامة وانتصابها وهذا واضح صراحة من كلام ابن كثير هنا. وعليه تكون مراحل التطور العضوي للإنسان بحسب ما يقرره القرآن الخلق والتسوية والتعديل، وقد جاء في سورة التين ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ٤ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ٥﴾ [التين: 5- 6].
وربما أمكن القول أيضا أن هذه الآيات ربما حملت معنى حصول نقوص تطوري في سيرة التطور العضوي للإنسان، فلحقه مسخ عضوي جعله شبيها بالحيوانات من الناحية التشريحية والتكوينية، بمعنى أن هنالك وجهًا لفهم هذه الآية على أن القصد منها أن الإنسان كان قد خلق في أول العهد بهيئة ومضمون راقيين أرقى مما هو عليه الآن، ثم جرت به المقادير فحصل في خلقه نقوص تطوري صار به الإنسان إلى حالة خلقته الحاصلة الآن من كونه شبيا بالحيوان من الناحية المورفولوجية وغيرها ومما يعضد هذا المذهب قوله تعالى في سورة طه ﴿فَأَكَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121]، وقوله تعالى في سورة الأعراف ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗا﴾ [الأعراف: 26]. وهذا اجتهاد جانبي في المسألة وليس نتيجة وفي هذا متسع للدراسة والبحث يفتحها القرآن لمن يريد البحث والدرس.
نستنتج من هذا العرض أن ما جاء في القرآن لا يتعارض مع القول بحصول تطور عضوي للإنسان على مراحل وحقب مديدة، ولكن القرآن يؤكد أن كل ذلك جرى بعلم الله تعالى وإرادته واختياره وفقا لسنن الفطرة التي استسنها لسيرة الخلق والتكوين وصيرورته إلى جانب ذلك، فإن القرآن يجيز حصول النقوص التطوري؛ أي حصول طفرة تطورية، تولد كائنًا مسخًا أيضًا، ولست أدعي أن فهمنا للصورة التي يقدمها القرآن الكريم هو فهم متكامل بل هنالك دون شك جزء غيبي من الصورة يتعلق بخلق آدم في الجنة التي لا يمكن القطع بأنها حقًّا على الأرض، على الرغم من قول البعض بأن الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض إنما كان مقصودًا به نزولًا معنويًّا، لكن تبقى هذه المسألة من متشابه القرآن التي تحتاج إلى أزمنة قادمة لحلها وفك ألغازها([50]).
ثم يتابع الدكتور الطائي قوله:
يمكن الجزم الآن بأن مبدأ التطور العضوي للكائنات الحية هو أحد الأعمدة الأساسية لعلوم الحياة المعاصرة، وبدون مبدأ أو فكرة التطور يصبح من الصعب تصور أي وجود لعلم البيولوجيا الحديث وهذا غير ممكن إذ لا يمكن الاستغناء عن علوم البيولوجيا، ومن ينكر حصول التطور العضوي فعليه الإتيان بتفسير علمي متكامل لظهور الأنواع ونشوئها، ويكون عليه أيضًا أن يفسر هذا التشابه المورفولوجي والفيزيولوجي والتركيبي، وحتى النشاط الاجتماعي الفطري بينه وبين الكائنات الأخرى في المملكة الحيوانية، ثم إن عليه أن يفسر نجاحات القائلين بالتطور في تفسيراتهم لكل ما يتعلق بالبيولوجيا التطورية. على أن هذا القول في الوقت نفسه لا يعني بالضرورة صحة جميع التصورات النظرية التي تقترحها الداروينية، بل إن هنالك بعض الأدلة العلمية التي تشير بالتأكيد إلى ضرورة وجود تفاصيل نظرية أخرى لم تعلم بعد، وعند هذا لا بد من تأكيد الفرق بين القول بحصول التطور العضوي للكائنات الحية والإيمان بنظريات التطور، فالأول يبدو واقعًا حاصلا في عالمنا، أما الثاني فمختلف فيه، ولا يمكن القطع به ألبتة.
وإنني أذهب إلى تأييد التصورات التي قدمها الفرنسي جان ستون بشأن نظرية التطور، وقولهم أنها لم تزل ناقصة وإنها في حال أشبه ما تكون نظريات الحركة التي طرحت في وقت جاليليو وما قبل نيوتن، بمعنى أن نظرية التطور الحالية تحتاج إلى الكثير من التحول لكي تقدم الحقيقة التطورية على الوجه الصحيح، وبهذا الصدد أود أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن القول بحصول الطفرات عشوائيًّا ليس واقعًا عمليًّا بل هو تفسير اعتمده الداروينيون وحسب([51]).
تقرر نظرية داروين في التطور أن الانقسام في الخلايا الجنسية يؤدي إلى حدوث طفرات عشوائية، وهي جملة تحولات في الشفرة الوراثية تنشأ أثناء عملية النسخ، وهذه الطفرات تظهر نتائجها في تكون الكائن الحي بعد ولادته، خلال حياة هذا الكائن تقرر الظروف التي يواجهها في الطبيعة ما إذا كانت الطفرة الحاصلة في تكوينه البيولوجي ناجحة أم هي فاشلة، من خلال صراع البقاء الذي يعانيه هذا الكائن مع الطبيعة، فإن كانت الطفرة الحاصلة ناجحة أدت إلى نجاة الكائن ومنحته فرصة للتكاثر على نحو ربما يكون أكثر تميزا من الجيل الذي لم تحصل له الطفرة، أما إذا كانت الطفرة فاشلة فإن الكائن سوف يموت، وهكذا يتم القضاء على الكائنات التي تحصل فيها طفرات غير مرغوبة من قبل الطبيعة، لذلك سمي هذا الاختيار للكائنات بين الطفرات الناجحة والطفرات الفاشلة (الانتخاب الطبيعي) على اعتبار أن الطبيعة نفسها هي التي تختار ما إذا كانت الكائنات ستعيش أم ستموت، ومن المنطقي أن تتكاثر وتزدهر أعداد الكائنات ذوات الطفرات المفضلة، بينما تتضاءل أعداد الكائنات ذوات الطفرات المرفوضة وغير المتجاوبة مع الشروط الطبيعية، وهذه هي الآلية التي تقترحها نظرية داروين للتطور.
في الحقيقة لا أجد في هذه الآلية ما يتناقض مع الاعتقاد الديني إلا في القول بأن الطفرات الحاصلة هي عشوائية تماما، فإننا إذا أقررنا عشوائيتها فإننا كأنما نجعلها مستقلة عن إرادة الخالق لكن ما يبدو عشوائيًّا ليس بالضرورة هو كذلك، فإن ما كنا ذكرناه في مقالاتنا السابقة حول عمل القوانين الطبيعية (الفطرية) وحقيقة أن نتيجة عمل هذه القوانين إنما هي احتمالية وليست حتمية، بحسب أرقى توصلات العلم المعاصر وإثباتاتها، إنما ينفي العشوائية وينفي استقلالية عمل القوانين الطبيعية بذاتها، بالتالي ليس من خشية في أن يكون في ذلك القول نفي لدور الخالق في آلية التطور، هذا الدور الذي يدخل أصلا إلى العملية من خلال حاجة القانون الطبيعي (الفطري) إلى مشغل وحاجة القوانين المتضاربة إلى (منسق) وإلا لم يكن هنالك نتاج مثمر، هكذا أجد أن إعادة تفسير آلية التطور بضوء نتائج علم الفيزياء الكمومية سيعطي دعما لقبول آلية التطور السابقة، لكننا يجب أن نتذكر أن نظرية الداروينية ليست رصينة على نحو مطلق بل فيها ثغرات يعرفها المتخصصون في علومها، وحتى آلية الانتخاب الطبيعي عليها مآخذ كثيرة ويمكن وضع ألف سؤال وسؤال تصعب إجابته بصدد ما هو حاصل في تطور الكائنات.
تبقى نقطة ثانية مهمة أيضًا وهي تعارض العقيدة الدينية مع السلسلة التطورية والقول بأن أصل الإنسان كان حيوانًا، قردا أو غزالا أو سمكة أيا كان، فالفكر الديني (وليس القرآن بالضرورة) يتعارض مع هذه الفكرة من منطلق أن هذه الكائنات مسخ لا تتناسب وتكريم الخالق للإنسان واختياره خليفة في الأرض، وهنا نقول: إن تكريم الإنسان وتكريم بني آدم إنما حصل بعد أن صار الكائن الراقي آدميًّا، وهذه حصلت عندما تمت تسويته ووقعت النفخة الربانية فصار بها ذلك الكائن البدائي إنسانًا، إن الحقائق المورفولوجية والتشريحية والفيزيولوجية وحتى السلوكية تؤشر تشابها واشتراكا كبيرا بين الإنسان وما سواه من الكائنات العليا، فنحن نأكل ونشرب ونتناسل ونمارس كثيرا من أنشطتنا الحياتية بطريقة لا تختلف كثيرا عن بقية الحيوانات، ما يميزنا عنها هو ملكة العقل وبها كرمنا الخالق، وبدونها يمكن أن ننزل إلى مستوى الحيوان، وإن نحن اخترنا أن نتجاهل ما يدلنا إليه العقل من كرامة نكتسبها مع الإيمان، بل من ضرورة الإيمان بوجود غاية للعالم ووجود قوة وإرادة وخطة وقصد لهذا الكون، فإننا سنكون في جمعية مع بقية المملكة الحيوانية التي ننتمي إليها ماديًّا بحكم النشأة والتكوين.
إن الخالق ميز هذا الكائن الذي هو -نحن- الإنسان لكي نتفكر ونتأمل، ونصير نحن الخليفة القادر على التخليق والإبداع، وندرك بعقولنا كوننا الذي نعيش فيه رغم أننا جزء ضئيل جدًّا من الناحية المادية فيه، إن قدرة العقل التي في الإنسان، تلك النفخة الإبداعية الرائعة قد أعطته قيمة تساوي قيمة الكون كله، بالتالي فإن الإنسان يجب أن يقدر هذه القيمة ويحترمها في جميع الوجوه والأنشطة، أما إذا شاء هذا الكائن أن لا يحترمها فهو وجماعته من مملكة الحيوان؛ سواء كان يتميز عليهم فيما يتحال لنفسه به([52]).
إذن فهناك رأي يقول بعدم التناقض بين القرآن وبين نظرية التطور، وهذا الرأي مستنده في ذلك أنه مهما قالوا في وصف هذه النظرية فالأمر في حقيقته مرجعه ومرده إلى الله تعالى، فكل الظواهر التي نراها في الكون مردها ومرجعها إلى الله، ولقد كان في الماضي من الفلاسفة الذين قالوا بمبدأ الطبع أو العلة، يقول الإمام الدردير في منظومته:
| ومن يقل بالطبع أو بالعلة
| فذلك كفر عند أهل الملة
|
| ومن يقل بالقوة المودعة
| فذاك بدعي فلا تلتفت
|
يقول الصاوي في شرحه:
(ومن يقل) من أهل الضلال كالفلاسفة (بالطبع) أي بتأثير الطبع أي الطبيعة والحقيقة بأن يقول إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها (أو) يقل (بالعلة) أي بتأثيرها بأن يقول إن الأشياء علة أي سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار، والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وإن اشتركا في عدم الاختيار أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع كالإحراق بالنسبة للنار؛ فإنه يتوقف على شرط مماسة النار للشيء المحرف وانتفاء مانع البلل فيه مثلا.
وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة وجد المعلول كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الأصبع، ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلولها ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها؛ أي لتخلف الشرط أو انتفاء المانع (فذلك) القائل (كفر) أي كافر أو ذو كفر ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من يقل، فالحمل ظاهر على معنى فقوله «كفر» فيكون القائل به كافرا؛ لأنه أثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك (عند) جميع (أهل الملة) أي ملة الإسلام… واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل، قالوا: إن الواجب الوجود أثر في العالم بالعلة فهو تعالى علة فيه، فلذا قالوا: إن العالم قديم لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، ولا شك في كفرهم عند المسلمين([53]).
ثم بين رحمه الله مذهب أهل السنة بقوله:
(فلا تلتفت) أي لقوله -أي القول البدعي وقول الكفر- بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا لا بطبع، ولا علة، ولا بواسطة قوة أودعت فيها، وإنما التأثير لله وحده بمحض اختياره([54]).
فالخالق على الحقيقة لكل لحظة وسكنة هو الله، هكذا يؤمن المسلم، وأفعالنا التي تبدو للوهلة الأولى -ظاهريًّا- مسببة من أفعالنا، هي على الحقيقة بخلق الله تعالى، ولا تأثير في هذا الكون كله إلا لله، يقول الله تعالى ﴿وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ [الأنفال: 17]، ويقول ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾ [الزمر: 62].
(([1] العقائد الكبرى بين حيرة الفلاسفة ويقين الأنبياء (ص 23) محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 2010م. والأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفة (ص 75)
(([2] الأربعين في أصول الدين (1/ 103).
(([3] شرح المعالم للتلمساني (ص 160).
(([4] انظر: الأدلة العقلية على وجود الله للدكتور سعيد فودة (ص 66).
(([5] الأدلة العقلية على وجود الله (ص 65- 69).
(([6] انظر: الأدلة العقلية على وجود الله (ص 89- 96).
(([7] انظر: المنطق غير التقليدي وتطبيقاته (ص 23).
(([8] شرح الحكم العطائية (ص 264).
(([9] الأدلة العقلية على وجود الله (ص 435).
(([11] هداية الحكمة مع شرحها لقاضي مير (ص 100).
(([12] المواقف مع شرحها (3/ 5).
(([13] انظر: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام (ص 89). والأدلة العقلية على وجود الله (ص 221).
([14]) انظر: مطرقة البرهان (ص 115).
(([15] انظر: الأدلة العقلية على وجود الله (436).
(([16] المرجع السابق (ص 436، 437).
([17]) المطالب العالية من العلم الإلهي، (1/88) فخر الدين الرازي.
(([18] كبرى اليقينيات الكونية ص 80.
(([19] الاقتصاد في الاعتقاد (ص 64، 65).
(([20] شرح المقاصد للسعد (1/ 125).
([21]) رحلة عقل، د. عمرو شريف (ص 80).
(([22] الكون المرئي بين الفيزياء والميتافيزيقا (ص 35).
([24]) كارل ساغان، كتاب الكون، ص: 234، سلسلة عالم المعرفة- الكويت، عدد 178.
([25]) شرح الوسطى للسنوسي ص: 234.
([26]) شرح النسفية، سعد الدين التفتازاني، ص:91.
([27]) التفسير الكبير 22/ 159.
([28]) شرح أم البراهين ص 28 للإمام السنوسي.
([29]) الوسطى وشرحها للسنوسي، ص: 112.
([30]) ابن فورك، مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص: 11.
([31]) راجع: مفاتيح الغيب للرازي (13/ 35).
([32]) Our cosmic habitat, p56.
(([33] هناك إله – كيف غير أشهر ملحد رأيه (ص 153، 154).
([34]) الزمخشري في الكشاف 4/ 215، ط. دار الكتاب العربي.
([35]) انظر: الإسلام ونظرية داروين (ص 7).
([36]) مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان (1/ 425، 427).
([37]) الانحراف الفكري والديني وأثرهما في الإلحاد المعاصر (ص 469).
([38]) المرجع السابق (ص 469، 470).
([39]) الإسلام ونظرية داروين (ص 25).
([40]) الإسلام ونظرية التطور (ص 26).
([42]) انظر: الانحراف الفكري والديني (ص 470).
([43]) الفيلسوف والعلم (ص 307). وانظر: الانحراف الفكري والديني (ص 474).
([44]) عقائد المفكرين في القرن العشرين (ص 54). وانظر: الانحراف الفكري والديني (ص 477).
([45]) تاريخ الفلسفة الحديثة (ص 354، 355).
هذه المسألة بالطَّبع هي لبُّ الأطروحة الإلحاديَّة أو غايتها، تصلُ في النِّهاية إليها بطريق أو بآخر، ويرجع إليها كلُّ أنواع الإلحاد السَّالف ذكرها.
هذا والَّذين لا يؤمنون بوجود خالق للكون يدورُ كلامهم حول عدَّة فروض، من ضمنها ما تقدَّم ذكرُه من الادعاءات السُّوفسطائية، وإنكار الحقائق الكونيَّة، لكن كل ما تقدم ذكره من تفاصيل شبهات النظرية المعرفية يرجع إلى ذلك في أغلبِه بالعرض لا بالذَّات، أمَّا إنكار وجود الله تعالى بالذَّات فإنه يرجع إلى ادعاء إلحادي قديمٍ جديدٍ ألا وهو وجود العالم دون خالق، إذ لا يخلو الأمر بعد إنكار الملحد لوجود الله إلا أن يقول بأزلية الكون والطبيعة والقوانين الفيزيائية، أو أن يقول بالعوالم المتعددة اللامتناهية، أو أن يقول بالوجود الاتفاقي للعالم، أي أن العالم وجد صدفةً.
إذ أصول عقائد الملاحدة من الماديين تدور على أن جوهر العالم وحقيقة الوجود أو العالم هي المادة أو الوجود المشاهد مادية كانت أصوله أم غير مادية، فالمادة هي الأصل الأول الذي يشكل وجود الكون، ولا يوجد فيه روح ولا أي شيء إلا المادة، والمادة هي منبع الوعي والعقل، وتنكر الإله والنفس والنبوة، واليوم الآخر، فلا حياة حقيقية إلا الحياة الدنيا المشاهدة، وعلى ذلك تراهم يعارضون دائما الأدلة العقلية القائمة على وجود الإله مثل الدليل الكوني، ودليل الحدوث، والدليل الغائي، والدليل الوجودي([1]).
وقبل الولوج إلى الشبهة، نطرح أولًا الأدلة على وجود الله تعالى.
إنَّ الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة متنوعة، تختلف حتى بين نظر المتقدمين العقلي المحض، وبين المتأخرين.
أما المتقدمين فيقول الإمام الرازي رحمه الله: إن الطريق إلى إثبات الصانع تعالى ليس إلا احتياج أجسام هذه الموجودات المحسوسة إلى موجود آخر غير محسوس، ومنشأ تلك الحاجة على قول بعضهم هو الإمكان، وعلى قول آخرين هو الحدوث، وعلى قول ثالث هو مجموع الإمكان والحدوث، ثم هذه الأمور الثلاثة إما أن تعتبر في الذوات، أو في الصفات، أو في مجموعها، أو بالعكس، فالمجموع طرق ستة([2]).
وقد اعتمد الإمام الرازي أربع طرق؛ حاصل ضرب الحدوث أو الإمكان، في الذوات أو في الصفات قال:
اعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصانع بالإمكان، أو بالحدوث وعلى كلا التقديرين، فإما في الذوات، وإما في الصفات، فهذه طرق أربعة([3]).
فالطريق الأول: الاستدلال على وجود واجب الوجود بإمكان الذوات.
والطريق الثاني: الاستدلال على واجب الوجود لذاته بإمكان الصفات.
الطريق الثالث: في إثبات العلم بالصانع تعالى: الاستدلال عليه بحدوث الجواهر والأجسام.
الطريق الرابع: في إثبات الصانع: الاستدلال عليه بحدوث الصفات:
والعلماء حصروا ذلك في نوعين: دلائل الأنفس، ودلائل الآفاق([4]).
وترجع هذه الطرق إلى ثلاث: طريق الإمكان، وهو يعتمد العلة والمعلول، وطريق الحدوث، ليرجع إلى المحدث القائم بنفسه، وطريق الإتقان أن وجود العالم المتقن الصنع دال على وجود خالق وصانع متقن، فالإمكان ينظر فيه من حيث دلالته على الحاجة إلى الموجد للذوات أو المخصص للصفات، والحدوث يدل كذلك على الحاجة في الذوات والصفات، ويضاف إلى ذلك الدلالة من حيث العناية وإتقان الصنعة، فهذه كما يبدو أصول الطرق.
وأما الفيلسوف ابن ملكا أبو البركات صاحب المعتبر في الحكمة فقد حاول حصر الطرق التي تؤدي إلى العلم بالله تعالى، وذلك بعدما أبطل طريق الحركة الذي اتبعه أرسطو وتبعه فيه كثيرون منهم توما الأكويني وانتشر الاحتجاج بدليل الحركة في الفلسفة الغربية في القرون الوسطى، بل في القرون المعاصرة، فهي ما تزال محلَّ نظر وتأمل، وخلص ابن ملكا إلى أن الطرق إلى معرفة المبدأ الأول على حد تعبيره هي كما يلي:
الطريق الأول: طريق العلة والمعلول، قال ابن ملكا: وإنما الطرق التي سلك فيها من جهة المعلولات إلى عللها والمبتدئات إلى مبادئها هي الطريق التي أوجبت عند عقول النظار وجود علة أولى لا علة لها، وهدتهم إلى مبدأ أول لا مبدأ له.
الطريق الثاني: طريق الوجود الواجب والممكن، قال ابن ملكا: وهو أيضًا من جملة النظر في العلة والمعلول، يخالفه في العبارة، وإشباع النظر من جهة الإمكان والوجوب.
الطريق الثالث: قال ابن ملكا: طريق العلم وتعليمه وتعلمه ينتهي فيه النظر كما انتهى في الوجود المعلول إلى غير المعلول، كذلك ينتهي في النظر العلمي من عالم يتعلم من غيره ينتهي إلى العالم بذاته الذي علمه لذاته بذاته، والطريق فيه بعينه هو طريق العلة والمعلول في العلم من العلم، حتى يكون العلم الأول الذي هو علم الأول، علة لكل علم بعده وهو غير معلول لعلم قبله، قال بذلك الأنبياء والعلماء ومحجته واضحة في حدود العلة والمعلول.
الطريق الرابع: من جهة الحكمة العملية، قال ابن ملكا: وطريق آخر من جهة الحكمة العملية، فإن الذي رأيناه من خلق المخلوقات من السماوات والكائنات والجمادات والحيوانات والنبات من النظام، في الشخص الواحد والأشخاص الكثيرة والأنواع المختلفة، دل على أن الأفعال فيها ترجع إلى حكيم، يسوق المبادي إلى غاياتها والأوائل إلى نهاياتها.
ويلاحظ أن الطرق الأربع التي ذكرها ابن ملكا ترجع إلى المذكورة عند الإمام الرازي.
ولو نظرنا في كتب توما الأكويني الشهير في الفكر المسيحي لوجدناه يذكر في الخلاصة اللاهوتية أن الطريق إلى إثبات وجود الله لا يتم إلا بالبرهان الإني لا اللمي، وقرر ذلك بقوله على من زعم أنه لا يمكن البرهان على الله تعالى.
الجواب: أن يقال إن البرهان قسمان، أحدهما ما يكون بالعلة، ويقال له لمي، وهذا يكون بما هو متقدم مطلقا، والثاني ما يكون بالمعلول ويقال له إني، وهذا يكون بما هو متقدم بالنسبة إلينا؛ لأنه متى كان معلول أوضح لنا من علته، فإننا نتأدى بالمعلول إلى معرفة العلة، وكل معلول يمكن أن يبرهن منه على وجود علته الخاصة إذا كانت معلولاتها أبين منها لنا، لأنه لما كانت المعلولات متوقفة على العلة فوجود المعلول يستلزم بالضرورة تقدم وجود العلة فيه، فإذا لما كان وجود الله ليس بينا في نفسه لنا، كان متبرهنا بآثاره البينة لنا.
ثم شرع في بيان المناهج الخمسة التي يرتئيها للبرهان على وجود الله، وهي مسالك مشهورة بين الدارسين للفلسفة والإلهيات وفلسفة الدين، ومن المفيد ذكرها هنا بصورة مجملة.
فالمنهج الأول: اعتمد فيه على دليل الحركة والمحرك، ووجوب انتهاء المتحرك إلى محرك لا يتحرك، والثاني: اعتمد فيه على أن العلل المترتبة لا بد من انتهائها إلى علة لا علة لها، لاستحالة التسلسل والدور، والثالث: دليل الممكن والواجب المشهور، ففي الأشياء ما يمكن عدمه ووجوده، ولو لم يكن غيره، لم يكن شيء في الوجود الآن، وهذا باطل، فوجب وجود شيء لا يطرأ الفساد عليه ولا العدم، والرابع: من جهة التفاوت في المراتب من حيث الحقية والخيرية في الأشياء الموجودة، ووجوب انتهائها إلى الخير المحض، وهو غاية الوجود وفاعله، والخامس هو دليل النظام والغاية.
وأما موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي والشارح الشهير للتوراة، فقد تكلم في كتابه الشهير دلائل الحائرين على خمس وعشرين مقدمة وزاد عليها واحدة أخرى هي أن الزمان والحركة سرمديان، ذكرها أرسطو وسلمها له موسى بن ميمون تسليما حتى يبين غرضه منها، وجعلها من مبادئ إثبات وجود الله تعالى واجب الوجود.
ثم شرع في عد الطرق على إثبات الواجب وهذه الطرق هي:
الطريق الأول: طريق الحركة ووجوب انتهاء المتحرك إلى محرك غير متحرك.
الطريق الثاني: تعتمد على أنه إذا وجدت أشياء متحركة ومحركة، وأشياء متحركة لا تحرك أصلا، وجب أن يوجد محرك لا يتحرك، وهو المحرك الأول.
وهذا الذي ذكره هنا هو صورة من برهان التضايف المذكور عند المتكلمين… الطريق الثالث: وهو الطريق الثالث المذكور عند توما الأكويني وقد أحاله ابن ميمون إلى كلام ذكره أرسطو وإن جاء به لغرض آخر.
الطريق الرابع: إذا وجدت أشياء تكون بالقوة أحيانًا وبالفعل أحيانا أخرى، فلا بد من استنادها إلى موجود لا يكون إلا بالفعل دائما ولا قوة فيه أصلا، وهو الواجب الموجود([5]).
ثم إننا نرى -بعد تقرير هذه الأدلة- بعض الفلاسفة ينزع إلى طرق أخرى في الاستدلال، فنرى الدليل الأنطولوجي الوجودي، المشتهر في القرون الوسطى إلى عصرنا الحاضر، ونرى أدلة تتسم بالعملية كالدليل الأخلاقي، ورهان باسكال، والأدلة النفعية الذرائعية.
أما الدليل الأنطولوجي فهو دليل نستطيع أن نطلق عليه دليلا ذاتيًّا، أي أن الله سبحانه وتعالى هو دليل نفسه، إذ في الدليل الأنطولوجي يتم الانتقال من مجرد تصور مفهوم الإله، إلى دعوى أن المفهوم يكفي عن طريق التحليل المنطقي للدلالة على الوجود الخارجي لله تعالى.
يقول ميل ثومبسون في بيان مفهوم الدليل الوجودي: إن الدليل الوجودي لا ينبني على ملاحظة العالم، أو أي شاهد خارجي، بل ببساطة على تعريف كلمة الإله، يدعي أنه من تعريفها تشير كلمة الإله إلى شيء ضروري الوجود.
ويقول جراهام أوبي: «إن الدليل الوجودي الناجح ينبغي أن يبين أن هناك جدوى للنظر المنطقي -تثبت قبليا باستعمال آليات منطقية قريبة- في أن الله يوجد». وأضاف: «إن الحجة الوجودية لا تستعمل أكثر من أساليب منطقية محضة معتمدة على حقائق معروفة قبليا، بأي أدوات معقولة مقربة للبرهان على المطلوب، فينبغي أن تكون الحجة الوجودية معتمدة على تعقل منطقي بحت لتأسيس صحة وجود الإله».
وهذا الدليل كما أشرنا له تقريرات، وهو دليل تكاثرت عليه المناقشات، واهتم كثير من فلاسفة الغرب محاولة منهم لمنع الاعتراضات الكثيرة عليه، ومن المعاصرين ألفن بلانتنجا والرياضي الشهير كيرت جودل الذي تكلمنا عنه مُسبقًا.
لكننا نقتصر في كلامنا هنا على تقرير الحجة من كلام أنسلم وكان تقريره على النحو التالي:
إنه من الأعظم للشيء أن يوجد في الذهن وفي الواقع أيضا، من أن يوجد في الذهن فقط.
الإله يعني «ما لا يمكن فرض شيء أعظم منه».
افرض أن الإله يوجد ذهنًا لا واقعيًّا.
إذن يمكن فرض ما هو أعظم من الإله. (وهو ما له جميع صفات الإله المفروضة ذهنًا، ولكنه موجود واقعيًّا أيضًا).
ولكن هذا محال (لأن الإله ما لا يمكن فرض شيء أعظم منه).
ينتج: الله موجود ذهنًا وواقعيًّا([6]).
وللدليل تقريرات أخرى آخرها ما عرضه كيرت جودل في هذا الدليل لكنه مكتوب بصورة منطقية رياضية تحتاج إلى تعمق في فهم المنطق الرمزي، والمنطق الموجه، وهذه صورته التي كتبها عليها الرياضي جودل:
فهذا الدليل يتألف من AX أي مسلمات، تنطلق لتكوين النظرية Th (تقع في مقابلة القطعية) ثم تتوالى النظريات حتى نصل إلى النتيجة الأخيرة التي تنسب الوجود الإلهي إلى الوجوب العقلي، ومعناه في المنطق الرياضي أنه في كل العوالم الممكنة وجود الله سبحانه وتعالى واجب فيها جميعا([7]).
على أية حال فإن هذا الدليل يذكرنا بكلام السادة الصوفية في الاستدلال، وهو أشبه بهم، كما قال ابن عطاء الله السكندري: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟
يقول شيخ الإسلام الشرقاوي: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده أي ثبوته وتحققه خارجًا مفتقر إليك، وهو المكونات، فإنها في ذاتها عدم محض كما مرَّ.
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟! فإن الدليل يكون أظهر من المدلول حتى يستدل به عليه، فأصحاب النظر والاستدلال حالهم قبيح بالنسبة إلى أصحاب الشهود والعيان، ويقال لهم عوام بالنسبة لهم.
قال الشيخ: ثم ترقى في نفي الاستدلال بقوله: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار أي المكونات هي التي توصل إليك؟! أي إلى معرفتك، ولذا قال مريد لشيخه: يا أستاذ أين الله؟ فقال ويحك: وهل يطلب مع العين أين؟! اهـ([8]).
وهو الدَّليل الذي يعتمد على ملاحظة الإمكان في هذا العالم بالتأمل فيه من جهات معينة كالحركة أو التركيب أو غيرهما، ليتم الانتقال بعد ذلك بإثبات حاجة هذا الممكن إلى وجود علة واجبة توجب وجوده، فإن الممكن يستحيل وجوده بنفسه عقلا.
وتم دراسة المقدمات التي يعتمد عليها الدليل، والإشارة إلى وجوه النقد الموجهة عليه مع مناقشتها، لتفحص مدى سلامتها، وهذا الدليل هو الدليل الأقدم والأكثر شهرة عند الفلاسفة، ولكن المتكلمين مع موافقتهم للفلاسفة على كثير من المقدمات والشروط، إلا أنهم زادوا عليهم وضبطوا وجه دلالة الدليل؛ لكي يصبح موافقًا لمقصودهم، وانتقدوا بعض الجهات التي قيد بها الفلاسفة الدليل.
والحاصل أن الدليل المعتمد على الإمكان والوجوب دليل سليم، ولكنه لا يكفي لإثبات الصانع المختار على طريقة الفلاسفة؛ بل لا بد من إضافة بعض المقدمات التي ذكرها المتكلمون للوصول إلى ذلك([9]).
يقول ابن سينا في تقرير هذا الدليل منتقلا من ملاحظة وجود ما حاصل وثابت في الخارج إلى إثبات ضرورة ثبوت وجود واجب لذاته:
لا شك أن هنا وجودًا، وكل وجود فإما واجب وإما ممكن.
فإن كان واجبًا فقد صح وجود الواجب، وهو المطلوب.
وإن كان ممكنا فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود([10]).
يقول الأبهري: فصل في إثبات الواجب لذاته، وهو الذي إذا اعتبر من حيث هو هو، لا يكون قابلًا للعدم وبرهانه أن نقول:
إن لم يمكن في الوجود موجود واجب لذاته يلزم منه المحال؛ لأن الموجودات بأسرها حينئذ تكون جملة مركبة من آحاد، وكل واحد منها ممكن لذاته، فتحتاج إلى عِلةٍ موجدة خارجة، والعلم به بديهي، والموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته، فيلزم وجود واجب الوجود، وعلى تقدير عدمه وهو محال، فوجوده واجب([11]).
وعبارة العضد الإيجي مع عبارة السيد الشريف: المسلك الثاني للحكماء وهو إن كان في الواقع موجودًا مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات وأحوالها، وهذه مقدمة تشهد بها كل فطرة، فإن كان ذلك الموجود واجبًا؛ فذاك هو المطلوب، وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى الواجب، وإلا يلزم الدور أو التسلسل وفي هذا المسلك طرح لمؤنات كثيرة([12]).
وهو الدليل الذي يتم فيه الانتقال من إثبات حدوث العالم، بطرق عدة إلى البرهان على أن هذا العالم المحدث له محدث صانع، ويمكن أن يقال إنه الدليل الأكثر أهمية المعتمد بين أكثر المتكلمين، وكان ينظر إليه باستهانة من قبل كثير من الفلاسفة عبر العصور، إلا أنه نتيجة لاكتسابه جهات قوة من بعض البحوث الفيزيائية والكونية في العقود المتأخرة، تبين أن هذا الدليل ربما يكون من أقوى الأدلة التي يجب الاعتماد عليها، لموافقة مبادئه ومقدماته كثيرًا من نتائج العلوم الفيزيائية، ولذلك فقد اكتسب الدليل أنصارًا في الغرب لم يكن يتوقع من قبل أن يرجحوه، ولا أن يصرحوا بمكانة المتكلمين؛ لأنهم الذين انتصروا للدليل رغم تعصب الفلاسفة بمختلف اتجاهاتهم ضده، وتصريحهم بأنه لا يصمد أمام النقد الفلسفي.
وقد ظهر دليل الحدوث عند المتكلمين الأوائل، ثم نقحه من جاء بعدهم وعدلوا عليه، وقد بين الإمام الأشعري الطرق الكلية بإجمال فقال في رسالة «استحسان الخوض في علم الكلام» في صدد بيان مشروعية علم الكلام والبحث في مسائله:
أما الحركة والسكون والكلام فيهما فأصلهما موجود في القرآن، وهما يدلان على التوحيد وكذلك الاجتماع والافتراق، قال الله تعالى مخبرًا عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه في قصة أفول الكوكب والشمس والقمر، وتحريكهما من مكان إلى مكان، ما دل على أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك وإن جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله([13]).
هو الدليل المعروف في الأدبيات الخاصة بعلوم العقائد كعلم الكلام الإسلامي أو اللاهوت اليهودي والنصراني بدليل العناية، أو الدليل الغائي، أو دليل النظم، وقد اتخذ في أواخر القرن العشرين اسمًا مُعاصرًا بإيحاءات علمية أكثر منها فلسفية، وهو دليل التصميم الذكي.
وقد اعتمد توما الأكويني هذا البرهان خامس أدلته التي طرحها على وجود الله تعالى في كتابه الخلاصة اللاهوتية، وفي سنة 1802م نشر اللاهوتي الإنجليزي ويليام بيلي كتابه المشهور اللاهوت الطبيعي ويقصد باللاهوت الطبيعي دراسة خطة الله في الخلق عبر دراسة وتأمل عالم الخليقة، وضرب له مثلا قدر له أن يصيب حظًّا كبيرًا من الشهرة والذيوع، إنه مثال الساعة التي يكفي تأمل أجزائها في دقتها وترتيبها وتآزرها في أداء عملها في الدلالة على استحالة أن تكون تكونت بطريق الصدفة المحضة، وأنه لا مناص من وقوف صانع ذكي وراء صنعها وتركيبها، وقد ظل رجال الدين -من المنافحين عن قضية الإيمان- إلى يومنا هذا يرددون التمثيل بهذا المثال، وانضم إليهم مؤخرًا المدافعون عن برهان التصميم الذكي.
الشكل المنطقي لبرهان النظم:
إن هذا البرهان من النَّاحية الشَّكليَّةِ هو استدلال قياسي بمقدمتين صغرى وكبرى وثالثة وسطى ونتيجة.
فأما مقدمته الصغرى فحسية؛ أي يتكفل الحس بتزويدنا بها، حتى إن ديفيد هيوم سقط سقوطًا مدويا في كتابه (محاورات في الدين الطبيعي) حين ظن أن هذا الدليل من أدلة الحس التي يسند إلى العلم الطبيعي معالجتها، والبرهان الحسي هو الذي تكون جميع مقدماته مستمدة من الحس؛ أي مما يدرك بإحدى الحواس، والحال أن مقدمة هذا البرهان الصغرى وحدها هي المستمدة من الحس على نحو يسمح للعلم بالتدخل عبر تزويدنا بأمثلة ونماذج هي قوام مقدمتنا هذه.
والمقدمة الكبرى مقدمة عقلية فلسفية ليست حِسيَّة أو تَجريبيَّة أو استقرائية أو تمثيلية، نتتمثل في الاعتقاد بأن كلَّ نظام لا بد له من منظم.
والمقدمة الوسطى فهي المشترك بين المقدمتين الكبرى والصغرى وهي لفظة النظام.
وهكذا تكون كل المقدمات جاهزة لاستخلاص النتيجة، وهي أنه لا بد من منظم لما نرى من نظام في العالم الطبيعي([14]).
وهو يعتمد على ملاحظة خصائص أخلاقية في الجنس البشري، لا يعقل أن تحدث صدفة ولا بمجرد التطور، كما يقول المعارضون والمحتجون بالدليل ينتقلون من إثبات ذلك، إلى القول بأنه لا بد من وجود مسبب ومحدث لهذه الأخلاق في نفس الإنسان، ولا يمكن أن يكون الإنسان هو عينه الذي أوجدها، ولذلك فهي دليل صارخ على وجود الخالق المتقن الذي أودعها في نفوس الخلق.
فالدليل الأخلاقي يمكن الاعتماد عليه، ولكن يبدو أنه لا يتعدى أن يكون وجهًا من وجوده دليل النظام، أو الحدوث وذلك بحسب وجهة النظر التي يعالج بها([15]).
طريقة رهان باسكال المبنية على مبدأ الاحتياط، وذرائعية وليام جيمس المنبنية على مرجعية المنفعة الدنيوية وكذلك أخلاقية كانط الذين لا يصح الاعتماد عليها لإثبات وجود الله، فهي لا تفيد الدلالة على وجود الله، غايتها أن تبعث النفس على الاطمئنان إلى الاعتقاد الحق غير المتلبس بالشك والريب، فإن كان الاعتقاد حقًّا؛ فيمكن بعد ذلك أن يقال: والمؤمن لا يخسر كثيرًا في دنياه، بل أرباحه أكثر بكثير من مكاسبه، وبخصوص الدليل الأخلاقي يمكن أن يقال: إن استقامة النظم الاجتماعية لا تتم على أبلغ وجه إلا على الأنظمة الدينية؛ ولذلك فقد وجدنا نصوصًا كثيرة عند علماء المسلمين تعارض الاعتماد على الاحتياط والتلبس بالشك في العقيدة([16]).
شبهات الملحدين في إنكار الوجود الإلهي
ادعاء أن للكون بداية، لكن دون احتياجه لوجود خالق:
وهذا الفرض قائم على نفي مبدأ السببية، فبناء على هذا الفرض ليس كل موجود له بداية لا بد له من موجد ومصدر سابق عليه.
وسوف نقف وقفة مع هذا الفرض؛ لأنَّه فرض قائم على نقض أحد المبادئ العقلية التي اتفق العقلاء عليها، بخلاف الفرض الأول الذي أثبت العلم بطلانه، وبخلاف الفرض الثاني الذي عند تأمله يظهر أنه ليس سوى محض خيال لا يمكن إقامة الأدلة عليه، كما أنه وقوع في مغالطة التسلسل الباطل، أمّا هذا الفرض فيكثر الكلام حوله، حتى إننا نجد علماء الكلام المسلمين قد صاغوا مقولات تناقشه فيها حجج قوية وأدلة كافية ووافية وشافية.
والذي يهمنا الآن أن نوضح النقطة الثالثة، وهي أن كل موجود قد ظهر وانتقل من العدم لحيز الوجود لا بد أن يكون له مسبب ضرورةً، واستحالة أن تُوجِدَ الصُّدْفَة شيئًا موجودًا له خصائص وسمات واضحة، وأن وجود الحق سبحانه لا يحتاج لموجد ليس فيه تناقض.
ضرورية مبدأ السببية، واستحالة الترجيح بدون مرجح:
إن العقلاء قد أجمعوا ببرهان العقل أن كل حادث متحقق فلا بد أن يكون لوجوده سبب، وأن هذا المبدأ (السببية) ليس مختصًّا بحالة دون أخرى ولكنه مطرد في جميع الأسباب والمسببات؛ لأنها ضرورة عقليَّة وليست برهانًا مبنيًّا على المشاهدة والتجربة.
ولذا عبّر أرسطو منذ آلاف السنوات عن المبادئ العقلية الضرورية بأنها التي يدركها العقل ضرورة، وإليها تُردُّ أغلب قوانين المنطق والاستدلال وهي المبادئ الأربعة: مبدأ الهوية، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ السببية.
ومعنى هذا: إدراك أن لكل شيء حادث سببًا أمر ضروري في النفس، وسنذكر برهانًا عقليًّا على صحته واطِّراده بلا تخصيص.
الأحكام العقلية الثَّلاثة وأهمية دلالتها على قضية السببية:
لكن قبل أن ندلل عليه نقول في البداية: إن جميع الأمور والمفاهيم والأشكال المفروضة في الذهن لا تعدو بأن تتصف بأحد أوصاف ثلاثة، وهي: الوجوب والإمكان والاستحالة، وهي المعروفة بالأحكام العقلية الثلاثة.
فالواجب: هو الذي يقطع العقل باستحالة عدمه أو انتفائه.
والمستحيل: عكسه أي ما يقطع العقل باستحالة وجوده أو ثبوت تحققه.
والممكن: أو الجائز ما يقضي العقل بثبوته أو بانتفائه.
وهذا العالم بكل مكوناته وأجزائه لما حكمنا عليه بالحدوث واستحالة كونه أزليًّا كان يقع ضمن المفهوم الثالث وهو الممكن؛ لأننا لما أدركنا حدوثه وعلمنا أن لوجوده بداية علمنا أنه ليس ضروري الوجود دائما وأبدًا أي ليس واجبًا، وكذلك فإنه ليس مستحيلًا؛ لأنه لا يترتب على فرض وجوده محال، لأنه موجود ومتحقِّق بالفعل.
الأدلة على ضرورية قانون السببية العقلية:
بناء على مفهوم الممكن، وهو الذي يستوي طرفا الثبوت والانتفاء في حقه، نفهم أن ترجيح جانب الوجود على العدم يحتاج إلى مرجح، ويبعد ويستحيل أن يكون هذا الترجيح من تلقاء نفسه؛ لأن ماهية الممكن أي (هويته) تقضي بأنه يستوي جانبا الوجود والعدم فيه لذاته، ومن ثم فإننا نناقض مبدأ الهوية -أول المبادئ العقلية- إذا قلنا بـأن (الممكن) أوجد نفسه دون حَاجةٍ إلى مؤثر خارج عن ماهيته، ومختلف في حقيقة (الإمكان) الذي قد ثبت له.
وقد عَبَّر المتكلمون المسلمون عن المعنى السابق بعبارات عديدة وساقوا هذا الدليل مرارًا بوضوح في التدليل على وجوب احتياج المـمكن إلى المؤثر،
فـلا شك أن الممكن هو الذي تكون نسبة الوجود إليه كنسبة العدم إليه، وما دام يبقى هذا الاستواء، فإنه يمتنع حصول الرجحان، فثبت أن دخوله في الوجود موقوف على حصول الرجحان وهذا الرجحان لما حصل بعد أن لم يكن، كان أمرًا وجوديًّا ثبوتيًّا، والصفة الوجوديَّة الثابتة لا بد لها من موصوف موجود، ويمتنع أن يكون الموصوف بهذه الصفة الوجودية هو وجود ذلك الشيء؛ لأنا بينا أن حصول هذا الرجحان سابق على وجود الممكن، فثبت أنه ليس محل هذا الرجحان هو ذلك الممكن الذي هو الأثر، فلا بد من شيء آخر يغايره([17]).
فلو كان رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر غنيًّا عن المؤثر والمرجح لامتنع توقف هذا الرجحان في موضع من المواضع على حصول المؤثر والمرجح، وهذا الثاني باطل، فذلك المقدم أيضًا باطل.
أما بيان الملازمة: فهو أنه لما كان ذلك الرجحان غنيًّا عن المؤثر امتنع افتقاره إلى المؤثر في شيء من المواضع أصلًا؛ لأن مقتضيات الحقائق والماهيات لا تتغير ألبتة، فإذا كان رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر غنيًّا عن المؤثر من حيث هو هو، كان هذا الاستغناء حاصلًا في جميع الصور، والغني لذاته عن الشيء يمتنع أن يكون محتاجًا إليه؛ وأمَّا بيان أن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر قد يتوقف على حصول المؤثر؛ فلأن العلم البديهي حاصل بأن حصول الكتابة في هذا الكاغد -الورقة- تتوقف على حصول الكاتب، وعلى حصول كل ما لا بد منه في كونه كاتبًا، وكذا القول في القطع والضرب والكسر وأمثالها من الأفعال.
فهذه العبارات والبراهين كلها تُرد لأصل المبادئ العقلية القبلية وهي مبدأ الهُوية واستحالة التناقض، وتوضح أن مبدأ السببية حتم لازم لها، وأن وجوبه ضرورة عَقليَّة وليس مُبنيًّا على المشاهدة والتجربة.
ولمزيد إيضاح يقول الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: «لاريب أنه قد أتى حين من الدهر لم يكن هذا الكون شيئا مذكورًا، إذ كان العدم المطلق هو المنبسط في مكان الوجود اليوم، ومعنى ذلك أن كفة العدم كانت إذ ذاك هي الراجحة، وكان الأمر مستمرًّا على ذلك.
ثم إن الأمر انعكس بعدئذ فترجحت كفة الوجود على كفة العدم المطلق؛ فإن قلت إن العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد، فمعنى ذلك أن تقول برجحان كفة الوجود على كفة العدم وانعكاس الأمر الذي كان مستمرًّا دون وجود أي عامل لهذا الرجحان أو الانعكاس الطارئ، وهذا أمرٌ يَعرِفُ الإنسانُ محض بطلانه بمحض الفطرة»([18]). اهـ.
فبناء على ذلك لا يمكن لإنسان أن يتصوّر أن يمسك بيده ميزانًا ويترك الكفتين فيه بوزن واحد دون وجود أي ثُقْلٍ إضافي في إحداهما؛ وبينما الكفتان متساويتان إذا واحدة منهما ترجح والأخرى تطيش دون أي مؤثر خارجي يتصوره الذهن، فالمادَّة الأوَّلية التي وُجد منها الكون لا يمكن أن تكون أتت من العدم إلى الوجود أو رجَّحَتْ نفسها بنفسها؛ لأنَّ العلم يقول باستحالة تغير المادة أو الطاقة الموجودة في نظام مغلق Closed System واستحالة استحداثها من العدم، ما لم يوجد مؤثر خارجي من خارج هذا النظام يكون سببًا في التغيير أي لا بد أن يكون النظام مفتوحًا Open system.
يَرِدُ على ما سبق اعتراضان سنوردهما مع مناقشتهما والرد عليهما فيما يلي:
الاعتراض الأول: قد يقول قائل إن القائلين من المؤمنين والموحدين بحدوث العالم وإسناد خلقه إلى الله وهو الفاعل الأول يؤمنون أنه قد صار فاعلًا للعالم بعد أن لم يكن فاعلا له، وهذه الفاعلية أو الخلق ليست لسبب يرجحها عن وقت آخر كان يمكن فيه إيجاد العالم، فهم اتفقوا على حصول معنى الحدوث والخلق لا لسبب، وذلك يرجع بالتناقض على قولكم بإثبات وجود افتقار العالم لسبب وعلة.
الاعتراض الثاني: أنكم قلتم إن الممكن هو الذي يستوي فيه جانب الوجود والعدم لذاته ولا يترجح أحدهما على الآخر، وهذا معارض بالعدم إذ هو سابق على الوجود وراجح عليه بلا سبب.
مناقشة الاعتراض الأول والجواب عنه: إن دعوى أن هذه الفاعلية أو الخلق قد ترجحت دون سبب يخصص ذلك الوقت بإيجاد العالم دون غيره غير صحيح؛ لأنا نقول إن المخصص هاهنا هو الإرادة الإلهية القديمة، فهي التي خصصت إيجاد العالم وخلقه بتلك الفاعلية من حيز القوة والجواز إلى حيز الفعل والوقوع.
ثم قد يقول السائل: فلنكرر السؤال وهو أن الإرادة قد تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى تلك الإرادة، فإنكم إن تخلصتم عن خصوص الوقت بإسناده إلى الإرادة فكيف تتخلصوا من خصوص الصفات، أي لماذا خصصت الإرادة هذا الوقت بخصوصه دون ما عداه، فإن كان بإرادة أخرى لزم التسلسل وهو محال، وإذا لم يكن بإرادة أخرى عاد بالنقض عليكم في تخصيص هذه الفاعلية بتلك الإرادة.
والجواب: أن هذه الشبهة قد ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) وردها على أحسن ما يكون، فقال:
وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها، وقول القائل إنه لم تعلقت بها وأضدادها مثلها في الإمكان، هذا سؤال خطأ فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء على مثله.
فقول القائل لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله، كقول القائل لم أوجب العلم انكشاف المعلوم، فيقال: لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم، فقول القائل لم أوجب الانكشاف كقوله لم كان العلم علمًا، ولم كان الممكن ممكنًا، والواجب واجبًا، وهذا محال؛ لأن العلم علم لذاته، وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات، فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله.
فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله؟ كقوله: لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، وهو محال، وكل فريق مضطر إلى اثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة، فكان أقوم الفرق قيلًا وأهداهم سبيلًا من أثبت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة، بل قال: هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال([19]). اهـ.
هل سَبْقُ العدم على وجود العالم يناقض قانون السببية؟
مناقشة الاعتراض الثاني والجواب عنه: وهو قول القائل أن العدم ترجح جانبه في الزمان الأول على جانب الوجود بلا سبب أو مؤثر، فنقول: إن هذه مغالطة؛ لأن السبب والمؤثر الذي نوجب استناد الممكن إليه هو الذي له أثر، والعدم نفي محض فيمتنع استناده إلى المؤثر، وهذا ليس تناقضًا أو تخصيصًا في الأحكام العقلية كما لا يخفى، والله أعلم.
وقد أشار الإمام التفتازاني إلى هذا الاعتراض، فقال: لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج إليه في عدمه لتساويهما، واللازم باطل؛ لأن العدم نفي محض لا يصلح أثرًا.
والجواب: أن العدم إن لم يصلح أثرًا منعنا الملازمة لجواز أن يتساوى الوجود والعدم بالنظر إلى ذات الممكن لكن لا يحتاج العدم إلى المؤثر لعدم صلوحه لذلك بخلاف الوجود؛ فإن المقتضى فيه سالم عن المانع، وإن صلح أثرًا منعنا بطلان اللازم وهو ظاهر.
وتحقيقه أنه وإن كان نفيًا صرفًا؛ بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود العيني لكن ليس نفيًا صرفًا بمعنى ألا يضاف إلى ما يتصف بالوجود، بل هو عدم مضاف إلى الممكن الوجود فيستند إلى عدم علة وجوده بمعنى احتياجه إليه عند العقل حيث يُحكم بأنه إنما بقي على عدمه الأصلي أو اتصف بعدمه الطارئ بناءً على عدم علة وجوده مستمرًّا أو طارئًا([20]). اهـ.
ضرورة استناد خلق العالم إلى سبب وفاعل مختار:
إن نظرية الانفجار العظيم The Big Bang Theory هي أكثر النظريات قبولا لتفسير نشأة الكون؛ حيث تؤكد أن الكون قد نشأ نتيجة لانفجار هائل في نقطة مفردة Singularity، وثبت علميًّا أن الكون له بداية ترجع إلى 13.7 مليار سنة، كما أن العلم قد طرح مفهومًا شديد الوضوح والدلالة: وهو أن الكون نشأ من عدم؛ فالفيزيائي إدوارد تريون Edward Tryon أستاذ الفيزياء في جامعة هنتر في مانهاتن: أكَّد أن طاقة الكون عند بدايته كانت صفرا، لأن قوة الجاذبيَّة الممسكة بالكون تمثل بالسالب في المعادلات الفيزيائية؛ إذ أنها تعمل في اتجاه معاكس للقوى الأخرى كالقوة الطاردة المركزية التي تدفع بالإلكترونات بعيدًا عن النواة، وتدفع بالكواكب بعيدًا عن شموسها، كذلك إذا عادلنا الشحنات الموجبة بالشحنات السالبة لذرات الكون أصبحت طاقة الكون صفرًا([21]).
والسؤال المطروح وسيظل مطروحًا دائما: كيف تعطي طاقة مقدارها صفر، كل ما في الوجود حولنا من بناء وطاقة وإبهار وجمال؟
فالمتدينون يعتقدون جَزمًا أن الله هو الذي أنشأ الكون كله من لا شيء بقدرة تامة وإرادة، تبعًا لما قدمناه من وجوب افتقار الممكن والحادث إلى فاعل واجب، وسبب أول قديم.
يقول الفيلسوف واللاهوتي المسيحي الأمريكي ويليام لان كريج في كتابهThe Cosmological Argument: «إذا كان الشيء فعلًا يدخل في الوجود بلا سبب، فإنه يصبح من المتعذر بيان كيف أن أي شيء وكل شيء لم يدخل في الوجود بلا سبب، أي: لِمَاذا وُجِدَ هذا العالم بالذات دون غيره من الممكنات؟». اهـ.
وقال أيضًا: «حينما نقول كل حادث له سبب:
Whatever begins to exist has a cause
فهذه المقدمة تبدو بوضوح صحيحة أكثر من نقيضها، فإنه من المتأصل في الحسِّ الفلسفي أن الحادث لا يدخل في الوجود بلا سبب، فإن مثل هذه الدعوى ترجع إلى ادعاء نوع من السحر!». اهـ.
فالذي لا يؤمن بوجود خالق، مضطر إلى قبول هذه المقدمة خاصة إن كان مشتغلًا في العلوم الطبيعية.
اعتراضات الفيلسوف (ديفيد هيوم) والجواب عليها:
والذين لا يُسلمون أن السببية مبدأ أولي، يدَّعون أنه لا يتوقف فهم الأثر على فهم السبب، وأشهر من انتصر للقول بنفي السببية الفيلسوف الشهير (ديفيد هيوم)؛ حيث نفى أن يكون مبدأ السببية قائم على أساس الضرورة العَقليَّة، وأن السببية ليست إلا انتظامًا معينًا لتسلسل ما من الملاحظات، أما الانتقال إلى حَتميَّة هذا الارتباط فيما سيكون لا ينبغي أن يكون مَبنيًّا على أسباب واقعية أو ماضية، فهو يقول مثلًا: لو سلمنا السببية فيما شاهدنا من أجزاء العالم، فلا يمكن تطبيقه على العالم كله لأنه لم يقع تحت إدراكنا.
والجواب: أننا قدمنا أن مفهوم الارتباط السببي بين الأثر والمؤثر هو ضرورة عقلية يلزم عن نفيها نفي الهوية، وما دام كذلك فإنه يصح لنا أن نطبقه على كل ما ثبت حدوثه وإمكانه كالعالم.
كما أننا نقول: إن العَقلَ يجرد المحسوس من خصوصياته، فالعقل يتناول قضايا كلية تكون أعم من المحسوس بحيث تصدق عليه وعلى غيره، ويجعلها مقدمات لقياساته الصادقة على الشاهد والغائب.
فحينما نقول: إن كلَّ جسمين لا بد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر، فهذه قضية كلية تلاحظ من تجريد المعنى الحسي المشاهد للجسم، ولا يلزم لصدق هذا الحكم مشاهدة كل ما يصدق عليه وصف الجسمية، فكذلك نقول: إن قانون السَّببية لازم لماهية الممكن دون النظر ومشاهدة كل جزء من أجزاء العالم بخصوصه.
دعوى مغالطة إعطاء الكل حكم الجزء (مغالطة التركيب) والرد عليها:
وهذا الاعتراض قد وجهه هيوم وكثير من القائلين بنفي السببية، وادعوا أن فيه مغالطة التركيب، وهي إعطاء المجموع حكم الأجزاء؛ لأننا إن حكمنا مثلًا على مادة كالكربون بأنها مادة غير ضارة، والأكسجين غاز غير ضار، فلا يلزم أن ثاني أكسيد الكربون وهو المركب المتكون منهما أن يكون غير ضار؛ لأن الحكم الذي تأخذه الأجزاء وهي مركبة ليس بالضرورة أن يكون نفس الحكم الثابت لأجزائها مفردة.
والجواب عن هذا الاعتراض: أن الشرط في مغالطة التركيب وهي إعطاء المجموع حكم الأجزاء أن تكون الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمجموع المركب مختلفة ومتباينة عن حقيقة الجزء أو الفرد، كما لو قيل إن الواحد فرد والثلاثة فرد فيلزم أن يكون المجموع المكون منهما فَردًا وهو الأربعة، فهذا هو وجه الغلط؛ لأن الهيئة الاجتماعية المتركبة من مجموع الأفراد مختلفة عن أجزائه، لكن أن يقال: إن كلَّ مجموع لا يأخذ حكم الأجزاء أو الأفراد المكونة له مُطلقًا فغير صحيح ولا يلزم؛ إذ قد يأخذ المجموع حكم الأجزاء إن تساويا في الماهيَّةِ أو الهيئة الاجتماعية: كأن نقول مثلا، كل جزء من أجزاء العالم حادث ومخلوق فيلزم أن يكون العالم بأسره مخلوق؛ لأن إمكان الماهية قد ثبت للعالم كله بإقامة الدليل على استحالة القِدم والتسلسل.
وقد تقرر أن علة المجموع هي علة لكل واحد من أجزائه؛ لأن المؤثر إذا كان مؤثرًا في مجموع الآحاد مع الهيئة الاجتماعية فقد أثر في كل جزء من أجزائه، ولو لم يؤثر في كل جزء من أجزائه جاز انتفاء ذلك الجزء، وعليه جاز انتفاء المجموع وهو وباطل.
فكرة السفر عبر الزمن وهل تبطل السببية؟
أما من يرددون بأن السَّفر عبر الزمن ينقض السَّببية إذ يمكننا السفر للماضي أو المستقبل، وعليه فيجوز وجود السبب قبل المسبب.
فنقول: إن فَرضيَّة السفر عبر الزمنTime Travel حسب النظرية النسبية العامة لأينشتاين مبنية على اعتبار الزمان ذا وجود نسبي، فالزمن يسري في الموجودات بسرعات ونسب متفاوتة؛ وذلك حسب اختلاف حقول الجاذبية، وفي الحقل الأعمق يتباطأ الزمان.
ونحن نعتقد أن الزمن ليس له وجود نسبي، بل هو مفهوم اعتباري يلاحظ من اشتقاق التغير والحدوث في أجسام العالم، أي هو دالة حسابية بين متغيرين، وعليه فالانتقال عبر الزمن مستحيلٌ عقلًا، ومعظم العلماء لا يعتقدون بجوازه، ولا توجد تجربة واحدة تدلل عليه.
يقول الدكتور جواد بشارة في كتاب: (الكون المرئي بين الفيزياء والميتافيزيقا):
أضافت النسبية الزمن كبُعْدٍ رابع بالإضافة إلى الأبعاد المكانية الثلاثة، تقول إن الزمان والمكان مرتبطان معًا ولا يمكن أن يوجد أحدهما بَمعزلٍ عن الآخر، إننا نستطيع أن نتحرك في الأبعاد المكانية بكل حرية، ويمكننا ركوب آلات مثل الطائرة أو الصاروخ التي تنقلنا في البعد المكاني الثالث (الارتفاع) ومن هذه الفكرة البسيطة عن الأبعاد يمكن أن ننتقل عبر الزمن بهذه الصورة، لكن النظر إلى ما سبق يعد مفهومًا كلاسيكيًّا فحسب؛ حيث يفترض أن الزمن مقياس مطلق لسرعة حركة هذه الأجسام، وقد توصلت باحثة ألمانية معاصرة إلى إثبات عدم إمكانية السفر عبر الزمان إلى الماضي، وذلك من خلال دراستها لنظرية أينشتاين بواسطة أي وسيلة تقنية سواء كانت خيالية أو افتراضية تسمى آلة الزمان([22]). اهـ.
اعتراض للفيزيائي الأشهر ستيفن هوكنج والرد عليه:
كذلك من المفاهيم التي يقدمها ستيفن هوكينج، للتدليل على جواز أن ينشأ العالم من العدم دون احتياج إلى الخالق أو الفاعل، مفهوم (الزمن التخيلي) Imaginary Time، وهو تطبيق لمفهوم الرقم التخيلي، ومعناه أننا إذا بحثنا عن الجذر التربيعي لرقم مثل (-4) فلن نجد رقما حقيقيا إذ أن ( -2 × -2 = 4) لذلك قام هوكنج بوضع رمز X يشير به إلى هذا الرقم الذي لا وجود له، ووضع X في معادلاته الخاصة بحساب الزمن، فنتج زمن تخيلي، عندما استخدمه هوكنج في حساباته أزال الحاجة إلى موجد أول.
وهذه مغالطة واضحة لأن مفهوم الأرقام التخيلية إذا كان صحيحًا من الناحية الرياضية، فلا اعتبار له من الناحية التطبيقية، وهذا أشبه بمفهوم -الما لانهاية ∞ في الرياضيات، فإنه وإن كان مستخدمًا رياضيًّا، لكن تطبيق الما لانهاية تطبيقيًّا على الموجودات يستحيل عمليًّا وفيزيائيًّا كما برهن العلماء.
يقول سير هيربرت دنجل Sir Herbert Dingle رئيس الجمعية الفلكية الملكية بإنجلترا: «أنه إذا كان مفهوم الأرقام التخيلية صحيحا من الناحية الرياضية، فلا اعتبار له من الناحية التطبيقية، ويستدل على ذلك بمثال يعرفه كل التلاميذ الدارسين للرياضيات: وهو إذا كان عدد الرجال المطلوبين لوظيفة ما هو (x)، وكانت x في بعض المعادلات: موجبة أو سالبة، عددًا صحيحًا أو كسرًا، عددًا تخيليًّا أو مركبًا أو صفرًا أو حتى لا نهاية، أو أي شكل من الأشكال التي ولدتها عقول الرياضيين، فإننا بالتأكيد سنعتبر x (عدد الموظفين المطلوبين) رقما صحيحًا موجبًا، ونرفض باقي الاحتمالات.
فالرياضيات لا تستطيع وحدها الاختيار بين البدائل في المثال السابق، وسنعتمد على المنطق العقلي والخبرة والتجربة. اهـ.
ومن ثمّ نقول: إن الزمن التخيلي الذي نشأ عن وضع الأرقام التخيلية في معادلات هوكينج لا اعتبار له، وسينقلب إلى زمن حقيقي إذا استبدل الرقم التخيلي برقم حقيقي، عندها ستظهر الحاجة إلى (المسبب الأول).
هل الفيزياء الكمية تثبت نقض السببية وتُجَوِّزُ وجود موجود من لا شيء؟
وأما ما يتعلق بنظرية تذبذب الفراغ الكمومي quantum vacuum fluctuations، وظهور الجسيمات الافتراضية في المستوى تحت الذري بلا سبب، وأنه ينافي السببية:
فالمقصود بهذا الكلام هو محاولة تفسير من بعض الفيزيائيين الملحدين بجواز وجود شيء لا من شيء أو بدون سبب ومؤثر، وحقيقة الأمر أن فيزياء الكم هي تصف العلاقات ما دون الذرية التي لا تستطيع ميكانيكا نيوتن وصفها؛ لأن للجسيمات دون الذرية خصائص ومواصفات مناقضة ومختلفة عن خصائص الجسم العادي.
وهؤلاء يقولون إن الجسيمات الافتراضيةVirtual Particles تنشأ من مكان فارغ؛ إذ الشيء يمكن أن يوجد الشيء من العدم وبلا سبب.
والجسيمات الافتراضية هي جسيمات تنشأ خلال فترة قليلة جدًّا من الزمن في موقع ما، ثم تختفي لتظهر في مكانٍ آخر وهي في الحقيقة تنحل من إشعاعات كهرومغناطيسية عند انخفاض الضغط عند التفريغ.
وينبغي التوضيح أنه ليس هناك مشكلة في القول بأن الأجسام الافتراضية بأنواعها الكثيرة المتعددة قد وجدت من الطاقة سواء كانت هذه الطاقة موجبة او سالبة.
فيبقى السؤال هل كان في هذا الفراغ طاقة أم كان فارغًا حقًّا وكان عدمًا محضًا؟
وفقًا لمبدأ عدم الدقة لهايزنبرج؛ فإن قيمة مجال معين ومعدل تغيره يلعبان نفس الدور مثل الموضع والسرعة لجسم معين؛ حيث كلما كان أحدهما أكثر دقة في التحديد كان الآخرُ أقل دقة في التحديد، ونستفيد من هذا فائدة مهمة وهي أنه لا يوجد شيء اسمه فضاء فارغ؛ وذلك بسبب أن الفضاء الخاوي يعني أن كلا من قيمة المجال ومعدل تغيره يساويان صفرًا بالضبط (إذا كان معدل تغير المجال ليس صفرًا بالضبط الفضاء لن يبقى فارغًا)، ومبدأ عدم الدقة لا يسمح لقيمة كلا من المجال ومعدل تغيره أن يكونا محددين معًا؛ ولذلك فإن الفضاء لن يكون فارغًا أبدًا ولكنه سيبقى في الحالة الدنيا من الطاقة التي تسمى فراغ.
وبناءً على الطريقة التقليدية غير الحتمية: فإن الجسيمات لا تأتي إلى الوجود من غير شيء كما يقولون، بل إنها تظهر كتذبذب لحظي للطاقة الكامنة في الفراغ الكمي Quantum vacuum، مما يشكل سَببًا غير محدَّد لنشأتها.
ولذلك فلا حجة لمن يقول: إنَّ الفيزياء الكمية أثبتت أنَّ الأشياء تظهر في الوجود بلا سببٍ، فضلًا عن القول بأن العالم كله ظهر فجأة إلى حيز الكون (الوجود) من لا شيء حرفيًّا!
ونحن إن فرضنا حالة حدثت وعلمنا أنه ليس لها سبب فيزيائي، وبالضرورة المنطقية لها سبب، إذن: لها سبب غير فيزيائي، وهذا الذي نثبته نحن (المؤمنين) انتهاء؛ لأنَّ عدم معرفة سبب الوجود لا ينفي الوجود.
فالسببية تعني افتقار المخلوقات لأسباب تحقق ماصادقاتها؛ أي وجودها الخارجي. وهذا مبدأ ضروري عقلي فطري، وتعني أن لكل مخلوق خصائص وصفات معينة ناشئة عن أسباب موجدة لها غير مرتبطة بزمان أو مكان، وهو مفتقر ومحتاج لهذه الخصائص والصفات؛ لأنها تمثل وتشكل وجوده وبدونها يصبح عدمًا، والإنسان العاقل يبحث عن مصدر هذه الصفات والخصائص فيجد أنها محكومة بقوانين وشرائط أي أسباب إذا تخلفت تتلاشى معها المخلوقات.
وإذا نظرنا إلى علم الفيزياء نجده معني بالبحث عن القوانين والشرائط التي تحدد خصائص، وصفات الظواهر المختلفة في الكون التي تلازمها تلازما خارجيًّا مطردًا لا يتخلف عادة، وبدون هذه القوانين والشرائط لا وجود لهذه الظواهر؛ لأن وجودها تابع لتوافر الشروط والقوانين والعكس صحيح.
ومن هنا نعلم أنه لم ولن يوجد موجود يتصف بصفات دون أن يكون لها قانون يحكمها، وإلا لما استقر نظام، ولا قانون، ولا امتازت الأشياء بعضها عن بعض بالخصائص المميزة لكل منها، ولانهدمت القوانين الفيزيائية التي هي قوام العلوم التجريبية، لكن هناك من يشغب على هذا المبدأ الفطري العقلي، مستندا إلى أدلة يظن أن قانون السببية ينهدم عندها. منها، ميكانيكا الكم؛ وهي قوانين جديدة تسري على الأجزاء الصغيرة في الكون، مثل الذرة والإلكترون والبروتون. وأصبحت القوانين التي تحكم الظواهر فائقة الصغر وفائقة السرعة يطلق عليها ميكانيكا الكم (quantum mechanics) بخلاف ما كان سائدًا قبل ذلك من أن قوانين نيوتن، أو الفيزياء القديمة المعروفة تحكم أجزاء الكون كله؛ سواء أكان مجرة أم ذرة، وعلى الرغم من أن لميكانيكا الكم استخدامات في مجالات علمية عديدة مثل الليزر، وأجهزة MRI، والترانزستور، وغيرها من مجالات الحساب الكمومي (Quantum computing)، مثل نظرية التشابك الكمومي Quantum entanglement، ونظرية النفق الكمومي quantum tunnel وغيرها من المجالات العلمية الهامة. إلا أن لها ظواهر غريبة إلى الآن لا يوجد تفسير لها، ومنها، الطبيعة المزدوجة للإلكترونات والفوتونات حيث ادعى البعض أن هذا يلغي مبدأ السببية.
وبيان ذلك أن ميكانيكا الكم أثبتت أن للإلكترونات والفوتونات طبيعة موجية وجسمية في نفس الوقت فيما يعرف بمثنوية الموجة والجسيم (wave-particle duality)، وهذا يعدُّ تناقضًا؛ لأن الجسم يكون محددًا ومتحيزًا في مكان والموجة منتشرة غير محددة وغير متحيزة في مكان.
وذلك من خلال تجربة الشق المزدوجdouble slits experiment)) وهي إحدى أهم التجارب الفيزيائية التي أسهمت في البحث في طبيعة الضوء وإثبات طبيعته الموجية، حيث أثبتت أن للإلكترونات خصائص مزدوجة من خصائص الجسيمات والموجات، وهذه التجربة كما جاء في كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم (ص 71) وما بعدها تكون بإحضار لوحة بها فتحتان ووضعت خلفه حائلا أو خلفية واضحة ثم وضعت أمام اللوح مصدر ضوئيًّا، فإن كان الضوء موجة فسوف يقسمها اللوح إلى موجتين منفصلتين ثم تلتحمان مباشرة بعد مرورهما من الفتحتين، لكن هذا الالتحام لن يجعلهما موجة واحدة مرة أخرى، وإنما سيجعلهما موجتين متداخلتين فيما يعرف بتداخل الموجات أو حيود الموجات Interference pattern مما يجعل الضوء على الخلفية في النهاية يقوى في بعض المواضع التي تقوي فيها الموجتان بعضهما بعضًا، ويضعف الضوء في المواضع الأخرى التي تضعف فيها الموجتان بعضهما بعضًا، وسوف يغطي هذا التداخل الخلفية أو جزءًا كبيرًا منها، ولن يكون حجمه متطابقًا مع حجم الفتحتين على اللوح.
وهذا ثابت ومتوقع في حق الضوء فعلا ولكن هناك ما يثبت أن الضوء يتصرف كجسيمات منفصلة أيضًا، وهي ظاهرة التأثير الكهروضوئی Photoelectric effect))، لكن لو استبدلنا بالمصدر الضوئي في تجربة الشقين مصدر يطلق الإلكترونات بدلا من الأشعة الضوئية المتوقع هو أن نرى على الخلفية خطين متطابقين مع حجم الفتحتين على اللوح.
وليس من المتوقع أبدًا أن تكون النتيجة على الخلفية هي تداخل الإلكترونات أو حيودها كما تفعل الموجات؛ لأن المفترض بالإلكترونات أنها جسيمات تتكون منها المواد من حولنا، وأنها ليست موجات تنتشر في الفضاء. لكن الصدمة الكبيرة هي أن النتيجة ستكون على الخَلفيَّةِ مطابقة السلوك الموجات؛ حيث ستغطي الخلفية تمامًا بشكل الحيود أو التداخل الموجي، فتكون أقسامًا من المناطق الداكنة التي تتركز فيها الإلكترونات والمناطق الفاتحة التي تخف فيها الإلكترونات؛ تمامًا كأنها موجات ضوئية.
وهذا يثبت أن الإلكترونات لها خصائص موجيَّة وجسميَّة كما للفوتونات خصائص موجية وجسمية، وهذه عجيبة من العجائب الكبرى، لكن إليك ما هو أكبر من ذلك، إذا أغلقت إحدى الفتحتين مما يجعلنا نعلم ونحدد المكان الذي سيمر منه الإلكترون؛ فسيختفي الحيود وستحصل على الأسلوب الجسيمي مرة أخرى، وسيتكون بالإلكترونات شكل مطابق لفتحة اللوح!! والأمر نفسه سيحدث لو فتحت الفتحتين لكن وضعت كاشفا على إحداهما يحدد مكان مرور الإلكترونات، فسيتكون شكلان مطابقان للفتحتين من الإلكترونات على الخلفية، وهذه الظاهرة العجيبة تعرف بمشكلة القياس Measurement problem وهي أحد الألغاز التي لم تحل إلى الآن في فيزياء الكم، وهي تعني أن القياس هو الذي يعطي للعالم الكمي وجوده المحدد الذي نتعامل معه كنتائج، وهنا تختفي الطبيعة الاحتمالية التي يعيشها العالم الكمي، أي أن الإلكترون انتهت ازدواجيته كموجة وجسيم بسبب قياسه وتحديد مكانه. أي أن الإلكترون يتصرف مثل الموجات لكن عند محاولة قياسه ورصده نجده يتصرف مثل الجسيمات في نفس الوقت، وتوقف العلم عن السبب الموجود في القياس الذي يجعل الإلكترون يغير سلوكه الموجي إلى الجسيمي عند رصده وقياسه.
وقد اختلف تفسير علماء العلوم التجريبية تجاه هذه الطبيعة المزدوجة ما بين قائل بالحتمية، وهي أن كل شيء في الكون خاضع لتسلسل منطقي سببي سواء علمناه أو أن هناك ثمة متغيرات خفية Hidden variables يمكن الوصول إليها في يوم من الأيام لاستكمال هذه الصورة الضبابية، أمثال شرودينجر، ديبرولي، أينشتاين ولطالما أن الحتمية مرتبطة ارتباطًا شديدًا بالزمن والتحديد كانت على النقيض من ميكانيكا الكم. وبين فريق آخر يتبنى الاحتمالية وعدم التحديد مثل هيزنبيرج الذي وضع قانون عدم الدقة وهو قانون رياضي مفاده أنه يستحيل قياس الكميات المقترنة وطبق هذه الحقيقة الرياضية المنطقية على الطبيعة المزدوجة للإلكترونات والفوتونات، أي أن سبب عدم دقة تحديد طبيعة الإلكترونات والفوتونات هي الطبيعة المزدوجة. أي أن هذا الفرع من ميكانيكا الكم ألغى الحتمية (Determinism)عند البعض ولم يلغ السببية (Causality)؛ أي أن القانون لا ينص على أن الإلكترون ليس لحركته سبب وإنما ينص على أنه من الصعب التنبؤ ومعرفة سرعته عند تحديد مكانه؛ لأنه يغير حركته وقتها إلى حركة الجسيم؛ لأن السببية ليس لها علاقة بطبيعة القوانين التي تحكم الظواهر فهي داخلة في الفيزياء الكلاسيكية والحديثة وميكانيكا الكم.
والفرق بين الحتمية والسببية يشرحه لنا العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء ماكس بورن أحد مؤسسي ميكانيكا الكم في كتابه: الفلسفة الطبيعية للسبب والصدفة (Natural Philosophy Of Cause And Chance)، فقد عقد فصلًا في أول الكتاب بعنوان السببية والحتمية( Causality and Determinism): يفرق فيه بين معنى الحتمية التي هدمتها ميكانيكا الكم، وبين معنى السببية يقول “القول بأن الفيزياء قد تخلت عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة، صحيح أن الفيزياء الحديثة قد تخلت عن بعض الأفكار التقليدية وعدلت فيها، لكن لو توقفت الفيزياء عن البحث عن أسباب الظواهر فلن تصبح حينها علمًا”.
ثم يضع تعريفًا للحتمية وآخر للسببية فيقول:
الحتمية تفترض أن الأحداث التي وقعت في أزمنة مختلفة، مرتبطة بواسطة القوانين وبالتالي فيمكن عمل تنبؤات في الماضي والمستقبل بمعرفة الحاضر، وفقًا لهذه الصياغة، فإن الحتمية تضاد فكرة القدر الدينية لأنه إذا كان يمكننا الكشف التام عن الماضي والمستقبل فكتاب القدر سيصبح معلومًا لنا، ولن يكون الله وحده المختص بهذا العلم.
السببية تفترض أنه وفقًا للقوانين يكون حدوث الكيان «ب» الذي ينتمي إلى فئة معينة، معتمدًا على حدوث الكيان «أ» الذي ينتمي إلى فئة أخرى. بحيث يكون المقصود بكلمة «كيان» هو أي شيء فيزيائي أو ظاهرة أو وضع أو حدث، ويسمى حينها «أ» بالسبب و«ب» بالنتيجة، ويضرب أمثلة تبين الفرق بين السببية والحتمية، فيبدأ بالسببية ويجعلها علاقة حاكمة بين الأشياء تُظهر قيام النتيجة بالسبب بصرف النظر عن تحديد الزمان والمكان لهذه العلاقات، فالسببية علاقة قائمة بشكل مطلق بصرف النظر عن التعيين في الزمن.
وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها على مبدأ السببية: الزيادة السكانية هي سبب فقر الهند، استقرار السياسة البريطانية كان بسبب المؤسسة الملكية.
الظروف الاقتصادية تتسبب في الحروب. لا توجد حياة على سطح القمر بسبب أن الغلاف الجوي هناك لا يحتوي على الأكسجين. التفاعلات الكيميائية تحدث بسبب انجذاب الجزيئات.
القاسم المشترك في هذه العبارات هو أن كلًّا منها تنص على علاقة غير زمنية؛ فهي جميعًا تخبرنا أن الشيء أو الحالة «أ» تتسبب في «ب»، مما يعني أن وجود «ب» معتمد على وجود «أ»، وأنه لو تغيرت أو غابت «أ» فسوف تتغير أو تغيب «ب» أيضا.
ثم ذكر عبارات مقاربة لكنها محددة في الزمن ولذلك فهي تعبر عن الحتمية وليس عن السببية:
المجاعة الهندية في عام 1946 كان سببها موسم حصاد سيئًا. سقوط هتلر كان بسبب هزيمة جيوشه. حرب الانفصال الأمريكية كانت بسبب الوضع الاقتصادي للعبيد. تدمير هيروشيما كان بسبب انفجار قنبلة نووية.
في هذه العبارات يعتبر الحدث المعين «أ» سببًا للحدث «ب» وكل منهما محدد في الزمان والمكان.
وأخيرًا يوضح أن مبدأ السببية ما زال مرتبطا بميكانيكا الكم فيقول “هل يمكن أن نرضى بقبول المصادفة وليس السبب كقانون أعلى للعالم الفيزيائي؟ للإجابة على هذا السؤال أقول، إنه ليست السببية المفهومة بشكل صحيح هي التي سقطت، وإنما الذي سقط فقط هو الفهم التقليدي لها المتمثل في تحديد هويتها بأنها هي نفسها الحتمية. لقد سعيت جاهدًا لأوضح أن هذين المفهومين غير متطابقين، السببية في تعريفي هي الفرضية القائلة بأن الحالة الفيزيائية المعينة تعتمد على الأخرى، والبحث السببي يعني الكشف عن هذا الاعتماد. وهذا ما زال صحيحًا حتى في فيزياء الكم”.
نشأة الحياة في الكون وضرورة وجود خالق ومصمم متقن:
وكذلك من ينظر في نشأة الحياة في هذا الكون ويدعي أنها جاءت اتفاقًا وصدفة، فإن هذا القول يكاد يكون مستحيل عمليًّا وأكثر غرابة ولا مَنطقيَّة من القول بنشأة أجسام الكون، فلو كان كل هذا بالصدفة والاتفاق، فكم من الزمان استغرق تكوينه بناء على قانون الصدفة الرياضي؟
إن الأجسام الحية تتركب من (خلايا حية) وهذه (الخلية) مركب صغير جدًّا ومعقد غاية التعقيد، وهى تدرس تحت علم خاص يسمى (علم الخلايا)Cytology. ومن الأجزاء التي تحتوي عليها هذه الخلايا: البروتين وهو مركب كيماوي مكون من خمسة عناصر هي الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، ويشمل الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر!
وفي الكون أكثر من مائة عنصر كيماوي كلها منتشرة في أرجائه، فأية نسبة في تركيب هذه العناصر يمكن أن تكون في صالح قانون (الصدفة)؟ وهل يمكن أن تتركب خمسة عناصر-من هذا العدد الكبير- لإيجاد (الجزيء البروتيني) بصدفة واتفاق محض؟
إننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الرياضي ذلك القدر الهائل من (المادة) الذي سنحتاجه لنحدث فيه الحركة اللازمة على الدوام؛ كما نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة السحيقة التي سوف تستغرقها هذه العملية.
لقد حاول رياضي سويسري شهير هو الأستاذ (تشارلز يوجين جواي) أن يستخرج هذه المدة عن طريق الرياضة، فانتهى في أبحاثه إلى أن (الإمكان المحض) في وقوع الحادث الاتفاقي-الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق كون، إذا ما توفرت المادة، هو واحد على 60/10 (أي 10×10 مائة وستين مرة)، وبعبارة أخرى: نضيف مائة وستين صفرا إلى جانب عشرة! وهو عدد هائل وصفه في اللغة.
إن جزيء البروتين يتكون من (سلاسل) طويلة من الأحماض الأمينية Amino-Acids وأخطر ما في هذه العملية هو الطريقة التي تختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض، فإنها لو اجتمعت في صورة غير صحيحة تصبح سمًّا قاتلًا بدلا من أن تصبح موجدة للحياة.
لقد توصل البروفيسور ج. ب. ليتزG. B. Leathes إلى أنه لا يمكن تجميع هذه السلاسل فيما يقرب من 48/10 صورة وطريقة.
وهو يقول: إنه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه السلاسل-بمحض الصدفة- في صورة مخصوصة من هذه الصور التي لا حصر لها، حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي يحتوي أربعين ألفًا من أجزاء العناصر الخمسة التي سبق ذكرها.
ولا بد أن يكون واضحًا أن القول بالإمكان في قانون الصدفة الرياضي لا يعني أنه لا بد من وقوع الحادث الذي ننتظره بعد تمام العمليات السابق ذكرها في تلك المدة السحيقة؛ وإنما معناه أن حدوثه في تلك المدة محتمل لا بالضرورة، فمن الممكن على الجانب الآخر من المسألة ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل العملية إلى الأبد!
وهذا الجزيء البروتيني ذو وجود (كيماوي) لا يتمتع بالحياة إلا عندما يصبح جزءًا من الخلية فهنا تبدأ الحياة، وهذا الواقع يطرح سؤالًا مُهمًّا: من أين تأتي الحرارة عندما يندمج الجزيء بالخلية؟ ولا جواب عن هذا السؤال عند غير المؤمنين.
إله سدّ الثغرات God of the gaps.
يفترض من لا يؤمن بوجود إله أنَّ مفهوم الإله ما نشأ لدى المؤمنين به إلا لوجود فجوة عِلميَّة وثغرة معرفية؛ لأنهم لم يستطيعوا تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية، والتقدم العلمي الذي حققته العلوم التجريبية كالفيزياء والأحياء وغيرها قد أغنانا عن القول بحَاجةِ هذا الكون إلى إله أو خالق، فتلك العلوم قد أحالتنا على أسباب الظواهر الطبيعية والكونية عن طريق القوانين التي استقرت وثبت صحتها، والتي لم نكن نعلم أسبابها في الماضي.
وللتوضيح لا بدّ أن نقرر مجال العلوم التجريبية، ومنها علم الفيزياء وغيره هو تفسير الظواهر الكونية والطبيعية التي تحدث شيئا فشيئا في هذا الكون، فمثلا عندما ينص إسحاق نيوتن على أنه:
لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه
فهذا القانون إنما يفسر ظاهرة حقيقية موجودة بالفعل، وتتكرر باستمرار، ومع كثرة المشاهدة ووفرة التجربة ودقة الملاحظة يستطيع العالم الفيزيائي أن يضع القاعدة أو القانون الذي يفسر حدوث تلك الظاهرة المتكررة.
وكذلك حينما يقول علماء الديناميكا الحرارية:
إن الحرارة تنتقل من الأجسام الأعلى حرارة إلى الأجسام الأقل حرارة في نظام معزول، وليس العكس، بدون شغل خارجي. فهذا القانون يفسر ظاهرة انتقال الحرارة من الأجسام الساخنة للأجسام الباردة حتى يحصل الاتزان الحراري بينهما، وهو أمر مشاهد ومتكرر، وتلك القوانين تفسر هذه الظواهر أي تعطي سببًا في سريانها على هذا النحو المشاهد باستمرار.
وعندما ينص ألبرت آينشتاين في معادلته المشهورة:
الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء
فهذا القانون يفسر ويرصد لنا أن كتلة الأجسام، ونواة العناصر المتكونة منها تحتوي على طاقة هائلة تساوي حاصل ضرب هذه الكتلة في سرعة عالية جدًّا وهي مربع سرعة الضوء، فهذه القوانين وأمثالها ترصد بعض الظواهر الطبيعية أي إنها كاشفة عن وجه النظام والترتيب بين أجزاء هذا الكون.
فبالتالي هناك فرق واضح بين الكاشف والمنشئ، فالكاشف عن الشيء هو الموضح والمفسر للعلاقات بين السبب والمسبب الموجودين بالفعل، وأغلب قوانين العلوم التجريبية من هذا الباب، أما المنشئ فهو المؤثر في الوجود وفي حصول الشيء من عدم.
وكذلك من المهم التفرقة بين السبب الضروري أي العلة العقلية والسبب العادي، فالسبب الضروري هو العلة الحتمية للوجود، أي التي لا يجوز تخلفها عقلا؛ كقولنا كل حادث له سبب، فهذا مبدأ من المبادئ العقلية الثابتة في التفكير البشري، فهذا يسمى سببا ضروريًّا أو علة، وأما السبب العادي فهو التلازم الموجود بين أمرين في الخارج في الظواهر الطبيعية والكونية وملاحظة تكرر الاقتران بينهما كقولنا مثلًا: إن الطعام سبب لحصول الشبع، وأن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، فهاهنا نقول: إن الطعام سبب عادي في حصول الشبع أي بينهما علاقة اقترانية ما؛ لكن يجوز أن يتخلف هذا الاقتران لمانعٍ ما، ونقول أيضا أن الحرارة سبب عادي في تمدد الجسم، فهذه الأسباب تدرك بالمشاهدة والتكرار، وكذلك القوانين المفسرة لها إنما توضع بعد الملاحظة والتجربة لهذه الأسباب، ثم صياغتها في شكل نظريات أو معادلات.
ولذلك قال العلماء: إن الضرورة والعلية صياغة منطقية، بينما الأسباب الطبيعية العادية صياغة للأحداث، أي انطباع ينشأ في الذهن نتيجة اطراد العلاقة بين النتائج والأسباب التجريبية.
فعلاقة كل هذا بوجود خالق مُنشئ للكون من عدم، هو كونه مُنشئا، فالملازمة والاقتران الشرطي والعقلي بين الكشف عن العلاقات الفيزيائية في الظواهر الطبيعية والكونية والبيولوجية، وبين نفي وجود خالق لهذا الكون، وفاعل للحوادث التي تجري فيه مغالطة واضحة.
مغالطة التلازم ونفي وجود الخالق
ولكي نوضح المغالطة في ادعاء وجود ملازمة بين اكتشاف القوانين المفسرة للظواهر الكونية والعلمية وبين نفي الخالق من الضروري أن نقدم بمقدمتين:
إننا من قبل قد أثبتنا أن هذا الكون مخلوق وناشئ من عدم، وأشهر النظريات العلمية حتى الآن التي تفسر نشأة الكون هي نظرية الانفجار العظيم تقول إن للكون بداية، وأنه يستحيل أن يكون الكون قد وُجد بنفسه أو من تلقاء نفسه، فالفيزياء والعلوم الكونية والمشاهدة والتجربة هي التي دلتنا على بداية الكون وأنه ليس أزليًّا، وكما يقول ستيفن هوكينج: إن العلم لا علاقة له بما قبل الانفجار العظيم أي ليس من اختصاصه، والسؤال الموجه إلى الفيزيائيين والماديين على اختلافهم: هل يمكن أن يوجد شيء من لا شيء؟ إنهم يقولون: لا؛ بناء على قانون حفظ الطاقة/ الكتلة الذي ينص على أن الكتلة/ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ومن ثم نسأل: هل يمكن للشيء أن يدخل في الوجود بلا سبب؟ فإن قالوا نعم فقد أبطلوا قوانين الفيزياء التي يدعون أنها مفسرة لكل الظواهر، وإن قالوا لا؛ لكننا لا نعرف ما هو السبب. فنقول لهم إن عدم العلم بالسبب الفيزيائي دليل على وجود سبب غير مادي ولا فيزيائي وهو (الله) جلَّ جلالُه.
فنظرية الانفجار العظيم تتصدى للإجابة عن الحدث الأول First Event لكنها لا تتعامل مع السبب الأول First Cause، ولا شك أن هناك فرق بينهما، وهذا السبب الغير فيزيائي الذي أثبتناه هو الذي يسميه المؤمنون
-المؤلهة- الله، لا بد أن يتصف بعدة صفات وهي:
1- واجب الوجود Necessary Being إذ إن تصور عدم وجوده يستتبع ألا يكون للكون ولوجودنا سبب.
2- وجوده لا يحتاج لسبب Uncaused؛ لأنه واجب الوجود، ولأنه يستحيل أن نتدرج في مصادر الموجودات إلى ما لانهاية.
3- أنه أزلي Eternal لأن الزمن وجد مع بداية الانفجار العظيم فذلك يستلزم أن يكون خالقه وسببه سابق على الزمان وغير مقارن له.
مطلق القدرة Omnipotent لأن المُوجد والخالق من عدم يستطيع إيجاد أي شيء.
مطلق المعرفة Omniscint لأن نشأة الكون وما استتبعه من هذا النظام المذهل في الكون بين أقسام العناصر المكونة له يستلزم معرفة تامة بموجوداته وما يحدث فيه.
إن مجرد مشاهدة التلازم بين أمرين، وحصول الثاني منهما عقب حصول الأول، لا يدل دلالة عقلية أو حتمية أن الأول سبب في وجود الثاني أو نشأته، وهذا الاطراد كما قلنا من قبل صياغة للحدث وليس ضرورة منطقية، والقوانين الفيزيائية مفسرة لحقائق موجودة بالفعل، فالقول بأنها مُوجدة للظواهر الكونية هو كالقفز على دليل بلا مقدمات؛ لأن العقل لا يحيل أن يكون المتسبب في هذه الظواهر هو خالق تام القدرة والمعرفة بلا واسطة أو بواسطة خصائص وقوى مودعة في الأجسام ومواد العالم، وما نلاحظه من التلازم بين الأسباب ومسبباتها لا يخرج أن يكون من الأحكام العادية التي تكتسب بالتجربة والتكرار.
يقول الأستاذ عباس محمود العقاد:
إن أسلوب لابلاس في التفكير الحتمي بالاستغناء عن العناية الإلهية -لأن قوانين الحركة تفسر حركة الأفلاك- يناقض أساليب الذهن الذي يراقب دورة الفلك، ويعلم أن العقل لا يستلزم حصولها على هذا الوجه دون غيره، إنه
ولا بد إذن من البحث عن الإرادة التي اختارت لها هذا الوجه من الحركة فانتظمت عليه([23]).
ومن راجع الأعمدة الرئيسة التي قام عليها دليل خلق العالم وجد أننا نجزم بمقدماتها وأدلتها، ولا نجهل شيئا منها، فمثلا إذا سألنا هل يمكن أن يكتشف العلم في المستقبل:
1- أن الكون أزلي ولا بداية له؟ الإجابة: قطعًا: لا.
2- أن الكون الذي له بداية يمكن أن ينشأ من عدم محض؟ الإجابة قطعًا: لا.
3- أن السبب الأول لوجود الكون يمكن أن يكون سببًا ماديًّا لا موجد له؟ الإجابة قطعًا: لا.
فالفيصل الحقيقي في إثبات وجود الخالق أو نفيه هو إقامة الأدلة على استحالة قدم العالم وأزليته، وأن له بداية وأن مُوجِده يتصف بصفات الكمال كالقدرة التامة والإرادة والعلم.
وعليه فالقول بأن خالق الكون هو مجرد اعتقاد لسد الثغرات المعرفية أو حل مؤقت لعجزنا عن تفسير بعض الأمور خطأ محض؛ لأنه ليس مبنيًّا على نقص في المعرفة العلمية، بل لأنه مبني على المعرفة العلمية اليقينيَّة والبراهين القطعية والتي أثبتها العلم والعقل والفيزياء، فدعوى الملحدين أننا نقول بوجود الخالق نتيجة لعدم اكتشافنا بعض الأسباب والنظريات المفسرة لبعض الظواهر ليس صحيحًا؛ لأننا ببساطة لا نتحدث عن (آلية) أو (حدث أول) يمكن أن يفسره العلم، لكننا نتحدث بوضوح عن (السبب الأول) وراء كل الأحداث والأسباب والمسببات المشاهدة في الكون، فالقول بوجود الله ليس تفسيرا لما لم يفسره العلم، بل هو تفسير لما أثبته العلم.
تدخّل الله في العلم ونظرية الخلق المستمر:
يرد على الذهن بين الحين والآخر بعض الاستشكالات حول ماهيّة تصوّر قدرة الإله، وهل هو يتدخّل في كلِّ شيء في الكون؟ وهل يعلم بالجزئيات علمه بالكليّات؟ كل هذه أسئلة الإجابة عنها ناشئة عن التصّور الذهني عن الإله ومدى علمه وقدرته وإرادته، وفي هذه النقطة حيرت العقول قديمًا وحديثًا، وبناءً على التصوّر بشأنها نشأت فلسفة كلّ فريق في حدود تدخّل هذا الإله.
فخصص أرسطو كتابه (ما بعد الطبيعة) للبحث في فكرة الإله، وإن كانت الميتافيزيقيا في نظره لها معنيان أحدهما خاص والآخر عام.
فالمعنى الخاص يقتصر موضوعه على الجواهر المفارقة، وهو ما يدعوه بالإلهيات خاصة، والمعنى العام يبحث في خصائص الوجود بما هو موجود، وهو ما يسميه علم الوجود؛ فتصوّر الإله عند أرسطو ليس معناه الخالق فقط، بل هو المحرّك، ومعنى المحرّك هو الذي يُخرج ما هو بالقوّة من القوّة إلى الفعل.
وفي الحقيقة أنَّ هذا التصوّر متماشٍ مع نظرة أرسطو للكون والحياة، فأرسطو كان يرى أنّ العالم عبارة عن طبقات فيها الأدنى والأعلى، والأدنى موجود لصالح ما هو أعلى، وما هو أعلى إنّما يكون كذلك لسبب ما فيه من مبدأ عقلي كما عبّر هو عن ذلك بنفسه.
ولأن الكون عنده مرتب بـ”الهيراركية” أي: التصاعدية، فالجماد ثمّ النبات ثمّ الحيوان ثمّ الإنسان، ثمّ الأجرام السماوية، ثمّ الإله أو المحرّك أو العقل المحض، أو…؛ فالإله عنده هو المحرّك لكلّ شيء؛ لأن كلّ شيء لا بد أن يرجع في النهاية إلى مبدأ أوّل يُحرّك ولا يتحرّك، يؤثّر في غيره ولا يتأثّر بشيء. يسميه (العقل المحض، أو العاقل، أو المبدأ الأول، أو المحرّك)؛ أسماء تفيد أنه مالك للإرادة المطلقة، وهو مرتبط بترتيب الأسباب، فیُعَرِّفُ الفلاسفة القدماء السبب بأنه: ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيّته، أو في وجوده.
لقد جعل أرسطو الإله المبدأ الأول للوجود، وهو لا يتحرك، بل سبب كل حركة، وهو متصف بالكمال لكنّه خال من القوة، ولا يدرك إلا أفضل الموجودات وهي ذاته فقط.
هذه الصفات التي ألزمها أرسطو للإله تستلزم منه أن لا يعلم العالم، بحجة أنّ العالم شيء ناقص وفاسد بالنسبة إليه، وأنّ الأشياء توجد وتنعدم، دون أن يريد الإله لها ذلك أو يعلم من أمرها شيئًا، إذًا فالإله عند أرسطو منطوٍ على نفسه، جاهل لما يقع في الكون، ولا مريد لما يجري فيه من أحداث، كما أنّه لا يحرك في الكون ساكنًا، فهو ليس علة فاعلة في الكون، بل علة غائية، يتحرك الكون شوقًا إليه، فعلاقة الإله بالعالم تنحصر في أن يثير اشتهاء العالم، وباستثناء ذلك فإنّ نشاط الإله يتجه بالكلية إلى داخله هو أي ذاته.
والحقيقة أن المؤمنين لم يقعوا في هذه الإشكالية عن الإله لثبوت ما يُعرف بقانون السببية، فتصوّر هذا القانون يحل كل هذه الاستشكالات.
قانون السببية معناه: أن يترتب السبب على مسببه، وألا يتخلّف عنه بحال من الأحوال؛ لأن السبب لغةً: اسم لما يتوصل به إلى المقصود، فكلّ شيء يُتوصّل به إلى غيره يسمّى سببا سواء كان هذا الشيء حسيًّا أو معنويًّا.
وفي اصطلاح المتكلمين: هو ما يحصل عنده الشيء لا به. هذا تعريف الأشاعرة؛ لأنّ السبب عندهم غير مؤثر بذاته بل هو علامة وأمارة عن التأثير الحاصل.
فمثلا: الحبل، وسيلة وسبب لإخراج الماء من البئر، وليس هو المؤثّر في الإخراج، وإنَّما المؤثِّر حركة المستقي للماء.
والمعتزلة قالوا: السبب يوجب المسبب متى كان المحلّ محتملا له، ووجد على الوجه الذي من حقه أن يولّده، فالسبب يوجب المسبب إذا احتمله المحلّ، فالأسباب تؤثر في مسبباتها.
وقد وقع الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في علاقة الأسباب بمسبباتها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الله هو الذي يخلق الحوادث والمسببات عند حصول الأسباب، أي عند وجودها واقترانها بها، فالله هو الذي يخلق الشعور بالشبع عند تناول الطعام، وهو الذي يخلق الإحراق عند وجود النار، وكذلك يخلق التمدد عند وجود الحرارة، فكل هذه الحوادث إنما هي بتأثير خلق الله وقدرته دون وجود أي مدخلية للأسباب المصاحبة لها إلا التلازم والاقتران المشاهد بينهما.
القول الثاني: أن الله يخلق هذه الحوادث والظواهر عن طريق قوة أودعها في الأسباب المقارنة لها، فهو خلق السبب والمسبب وخلق في السبب قوة مودعة فيه هي التي تُحدث الظاهرة أو توجد الحدث، فهو -أي الخالق- هنا يخلق بواسطة وهي القوى المودعة في الأسباب.
والقولين السابقين هما قولا المسلمين وأغلب أهل الأديان المؤمنين.
القول الثالث: وهو قول كثير من الفلاسفة حيث يقولون بأن هذه الأسباب هي علل للحوادث والظواهر التي تحدث في الكون، فمتى ما وجد السبب فلا بد حتما أن يوجد المسبب إذا انتفى المانع، من دون مدخل لتدخل القدرة الإلهية؛ لأنّ السبب في الفلسفة اليونانية القديمة منقسم إلى أربعة أقسام:
– السبب المادي: والمقصود به ما هو داخل الشيء ومعه بالقوة، كالنحاس بالنسبة للتمثال.
– السبب الصوري: والمقصود به ما هو داخل الشيء ومعه بالفعل، كالشكل النهائي للتمثال.
-السبب الفاعلي: والمقصود المؤثر في وجود الشيء والداخل فيه، كالذي صنع التمثال.
-السبب الغائي: والمقصود به الذي من أجله وُجد التمثال.
فعلى ذلك تكون للسببية ثلاثة معاني تشیر إلى: المقولة التي تختص بالرابطة السببية:
أ- المبدأ، أي: القانون العام للسببية.
ب- والمبحث، أو المذهب الذي يتوجه للبحث عن المبدأ السببي.
ج- الغاية.
وأما نظرية الخلق المستمر أو الخلق المتجدد فقد شغلت حيّزًا كبيرًا من مناقشات علماء الكلام، والحقيقة أنَّ ما أورده الأشاعرة من مباحثات وردود في الدرس العقدي حول هذه النظرية لا زال حاضرًا وبقوّة في وقتنا المعاصر، وإن لم يكن داخل الدرس الفلسفي فإنه يحتل موقعا كبيرًا لا يمكن إنكاره مع النظريات العلمية.
وجوهر فكرة (الخلق المستمر) مبثوث في كتب الأشاعرة وإن لم يُوجد لها مصطلح مخصوص؛ لكنها موجودة في مباحثهم المتعلقة بالفعل والمشيئة الإلهية، والإرادة وما إلى ذلك، وانتقل هذا المفهوم من الدراسات الفلسفية إلى حقل العلم وأصبح نظرية تفسيرية.
فتعدُّ الآن نظرية الخلق المستمر continuous creation theory كأحد النظريات المفسّرة لنشأة الكون؛ ذلك أنَّ مفهومها يكمن في أنه: ليس للكون لحظة ابتداء ولا لحظة انتهاء، وأنَّ المجرَّات التي تتباعد إنما تُخلق محلها المادة على شكل ذرات الهيدروجين؛ لتبقى كثافة اللون ثابته، أي: أنَّ هناك خلقًا دائمًا للمجرَّات والكواكب والنجوم([24]).
كما أنَّ الممكن حال بقائه غير مستغنٍ عن المؤثر، كما أنَّ العَرَضَ لا يبقى زمانين، ومعنى ذلك أن يُخلق في كل زمان زمان، فيستمر في الخلق؛ لأن من صفاته الخلاق، فلم يخلق الخلق ويتركهم سدى وهملا، ومن المقرر أن الاسم المشتق لا يفارق المشتق منه، فـ(الخالق) اسم فاعل مشتق من الخلق، فلا يفارقه أبدًا، كالحي لا يفارق الحياة… وهكذا، ولذلك نقول إنَّ الكون والكائنات لا تقوم بذاتها؛ لأن الله هو القيوم.
ويبقى السؤال الأهم وهو: هل قوانين السببية وجريان العالم على قانون الأسباب المطرد يمنع من وصف الإله بالقدرة أو بالخلق المستمر؟
لقد قررنا سابقًا أنَّ الله يُحدث قدرة في الشيء عن إرادة، فهذه القدرة مصاحبة للفعل متعلقة به، فمثلًا النار لها قدرة على الإحراق مصاحبة لفعل الإحراق وليست هي بذاتها، وليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلًا وإنَّما تتعلق به وتصاحبه فقط([25]).
كما أنَّ للعبد قدرة وإرادة في فعل الشيء أو عدمه تؤثر في الفعل، وحاصل العبد القادر عند أهل السُّنَّة أنه مجبور في قالب مختار، مجبور من حيث أنَّه لا أثر له ألبتة في أثر ما عمومًا، وإنِّما هو ظرف للحوادث والأعراض يخلق الله تعالى فيه ما شاء ويختار، فما اقتصرنا عليه في أصل العقيدة من عدم التأثير للقدرة الحادثة ألبتة هو المعروف المشهور الذي لا يصح عقلًا ولا شرعًا خلافه، وهذه القدرة الحادثة التي يطلق عليها الكسب، والمقصود بالكسب: هو مصاحبة القدرة الحادثة للمقدور وتعلّقها به من غير تأثير لها ألبتة.
وهذه القدرة الحادثة -أيضًا- هي عَرَضٌ من الأعراض يخلق الله بالعناية المستمَّرة لخلقة، ومدى احتياجهم للفعل الذي يقدرون على مباشرته يخلق لها إرادة تسيير في الشيء المقصود وقت القصد للفعل، فالنظرة السديدة تقضي بأنه ليس للعبد فعل حقيقة، وإنما تأثير وتدخل من الله في تطويع الأمر له، مثال ذلك: الحركة والسكون.
فالحركة والسكون عَرَضٌ من الأعراض، فمثلا: حين تمسك بالقلم لتكتب، فحركة القلم في يدك عرض خلقه الله عند إرادتك للتحريك، وكذلك حركة اليد الماسكة بالقلم عَرَضٌ خلقه الله خلقا مستمرًّا عند حاجتك إليه، وليس ليدك تأثيرًا مباشرًا في التحريك لأن العرض لا يتعدى محلّين.
ويمكن أن يسأل سائل سؤالا وهو أنَّ العادة تقضي بأن تحريك اليد كما في المثال السابق يعقبه تحريك القلم فهو علاقة سببية بينهما؟
والجواب: أنَّ هذا التحريك عَرَضٌ والعرض لا يبقى زمانين، ومن المقرر أنَّ القدرة الحادثة للإنسان المقترنة بالفعل الناشئ عنها لا بدَّ أن تقارن الفعل ولا تكون سابقة عليه؛ لأنَّ الأعراض لا تبقى زمانين فيخلق الله هذا العَرَضَ وقت القصد للفعل، “وإذا كانت الاستطاعة عَرَضًا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه؛ لامتناع بقاء الأعراض”([26]).
وفي تفسير قول الله تعالى: (قُلۡنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ) [الأنبياء: 69] يقول الفخر الرازي:
أنَّ الناس اختلفوا في المعنى المراد من كون النار أصبحت بردًا على أقوال كثير، أولاها القول: بأن الله تعالى أزال عنها ما فيها من الحر والإحراق، وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق والله على كل شيء قدير([27]).
وهذه الآية التي غالبًا ما يضرب بها العلماء الكلام للتدليل على أن قانون الأسباب للشيء وقدرته على الاستمرار يمكن أن تتخلفَ بنزع خاصة من خاصياته، فالطبيعي أن يطَّردَ قانون السببية بمجرد أن يُلقى إنسانٌ ما في النار أن تحرقه النار، لكن لبيان المعجزة وتثبيت دعائم التدخل الإلهي، في بيان الحفظ والعناية، جعلها الله بردًا وسلامًا، على قاعدة الخلق المستمر، فإنَّ الله يخلق خلقًا مستمرًّا عند الفعل بل عند إرادته وتهيؤ أسبابه.
وهذا ما يحيلنا إلى الجواب عن: هل يمكن عقلًا أن تتخلف الأسباب؟
والجواب أن نقول: إذا كانت الأسبابُ داخلةٌ في دائرة الإمكان، وكل ما كان في دائرة الممكن يمكن أن يرد عليه الإبدال أو التغيير، فالأسباب كذلك بلا شك، أما إذا لم تكن داخلة في دائرة الإمكان فلا يُتصور تبدُّلها، وبالتجربة والمشاهدة أن تخلف الأسباب وارد، ومع افتراض جريان العالم على قوانين مطردة فإن تلك القوانين لا تمنع من وجود عناية سابقة على تلك القوانين هذه العناية يمكن أن نسميها تدخل، ويمكن أن نسميها حفظ عن الخطأ، ويمكن أن نسميها قدرة من الإله، إلى غير ذلك من المسميات، فلذلك لا يمكننا بحال أن نعتقد أن الله خلق العالم وخلق له قوانين ثم هو يتركها هملًا، ولذلك قال الله في القرآن: {هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤}[الحديد: 4].
وفيما يتعلق بوجهة نظر الفيزياء الكلاسيكية التي قامت على قوانين نيوتن للحركة والجاذبية في الشق الفلسفي المتعلق بتدخل الخالق في الكون -فإنها قد مرت بمرحلتين:
– المرحلة الأولى: احتفظ إسحاق نيوتن فيها للإله بدور في منظومة عمل الكون يقوم على دعامتين؛ الأولى: تقول إن قوانين الطبيعة من خلق الإله، سواء بأن جعلها مكونًا ثابتًا في بنية المادة، أو أنه حدَّد للمادة السلوك الذي ينبغي أن تتبعه وألزمها به؛ والثانية: أن الإله هو المسؤول عن تعديل الخلل الواقع في مسارات الكواكب إذا خرجت عن النسق العام لقوانين الفيزياء.
وهذا التصور المنسوب لنيوتن عن علاقة الخالق بالقوانين الفيزيائية هو ما جعل البابا ألكسندر أن يكتب على قبر نيوتن: كانت قوانين الطبيعة ترقد في ظلام الليل، ثم قال الإله فليكن نيوتن، فأضاء كل شيء. وهو قريب من القول الثاني للموحدين الذين ينسبون المسببات والظواهر للقوة المودعة فيها من الله.
– المرحلة الثانية: التي ذهب فيها الفلكي الشهير لابلاس أن الإله لا دور له في تغيراته؛ لأن الكون مكتف بذاته ومغلق، وكل الظواهر التي فيه حتمية، لذلك شاع الحديث عن (حتمية) لابلاس التي تنفي تدخل القدرة الإلهية في حوادث الكون.
وعندما سأل نابليون بونابرت لابلاس عن مكان العناية الإلهية من حركات الأفلاك، أجابه أنه لا يرى لها مكانًا فيما يعلمه من تلك الحركات، فقوانين الحركة وحدها تفسر تفسيرًا يغني عن النظر لعلة أخرى وراءها.
أما في الفيزياء الحديثة خاصة ما يتعلق بميكانيكا الكم، فإنها قد رفضت مفاهيم الحتمية الموجودة عند لابلاس مع ظهور مفهوم اللاحتمية عند هايزنبرج، فالقوانين المفسرة لسلوك الجسيمات في فيزياء الكم قائم أغلبها على الاحتمالات وعدم وجود قيم محددة يسبق التنبؤ بها.
فمفهوم الارتياب واللاحتمية من المفاهيم الأساسية في فيزياء الكم، فمثلًا إذا سقطت مئات الجسيمات للضوء على مرآة فطبقًا لمبدأ هايزنبرج فإن حوالي 95% منها تنعكس تجاهنا لنرى الصورة، بينما تنفذ حوالي 5% من هذه الجسيمات خلال المرآة، لكن إذا سقط جسيم ضوئي واحد (فوتون) على المرآة فإننا لا نعرف ولا نجزم هل هذا الفوتون سينفذ أم سينعكس، لكن يبقى هناك احتمال بنسبة 95% أن ينعكس إلينا، واحتمال 5 % أن ينفذ خلال المرآة.
والفيزيائي الأشهر في القرن العشرين ألبرت آينشتاين يعارض حتمية لابلاس التي تعتمد أن الكون نظام مغلق كما يرفض مفهوم اللاحتمية في فيزياء الكم، ويرى أن هناك قوانين دقيقة لم ندركها بعد هي التي تحكم سلوك الجسيمات تحت الذرية، ويقول في هذا مقولته المشهورة: «إن الله لا يلعب بالنرد» أي إن كل شيء في هذا الكون يسير وفق نظام دقيق أنشأه الله حتى ولو لم نتعرف عليه بعد.
تقرير القضية قائم في ذهن من يسأل سؤال من خلق الله؟ بناء على تصور القاعدة بأن كل موجود له سبب، فمن الذي خلق الخالق، بناء على ضرورة قانون السببية.
ولتوضيح المعنى المقصود لا بد أن نقدم بعدة مقدمات حتى يتضح التناقض في السؤال، وعدم تناقضه مع ما أثبتناه من ضرورة السببية في العلل والمؤثرات.
ضرورة فهم الأحكام العقلية الثلاثة:
كما قدَّمنا هناك أحكاما ثلاثة اتفق على إثباتها جميع العقلاء لجميع المفاهيم والأحكام والموجودات، وهي الأحكام العقلية الثلاثة: الوجوب والاستحالة والإمكان، ومعرفة هذه الأحكام الثلاثة يزيل الإشكالات عن كثيرٍ من الأسئلة ودعاوى التناقض.
أما الوجوب العقلي: وهو الأمر الذي لا يتصور الانتفاء بالنظر إلى ذاته، أو هو ما لا يتصور في العقل عدمه، ومثاله: تحيز الأجسام، فالجسم حال كونه جسما يستحيل ألا يكون متحيزًا؛ أي يشغل قدرًا من الفراغ الموهوم، وإذا انتفى التحيز انتفت حقيقة الجسم. ومثاله أيضًا إثبات أن الكلَّ أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، فعند تصور معنى الكل والجزء ومعنى الكبر يجزم العقل بوجوب هذا الحكم بالنظر إلى ذاته، ودون النظر إلى أي اعتبارات أخرى .
والمستحيل العقلي: عكس الواجب وهو الأمر الذي لا يتصور الثبوت بالنظر إلى ذاته، أي هو الأمر الذي لا يقبل الثبوت بأي حال ودون النظر لأي اعتبار آخر، ومثاله: اجتماع النقيضين كوصف الشيء الواحد بأنه موجود وغير موجود دون النظر لأي حيثيات أو اعتبارات أخرى، وكذلك وصف الجزء أنه أكبر من الكل، وكذلك الدَّور تَوقُّف وجود الشيء على ما يُتوقف وجوده عليه؛ كتوقف
(أ) على (ب)، وتوقف (ب) على (أ)، كدعوى شخص أن سبب وجوده هو والده، وأن سبب وجود والده هو ولده.
والإمكان: وهو الأمر الذي يقبل الثبوت أو الانتفاء بالنظر إلى ذاته، ودون النظر لأي اعتبارات أو حيثيات أخرى، ومثاله: وجود الإنسان على الصورة التي يوجد عليها من اختلاف الصفات والأحوال، فالعقل لا يوجب أو يحيل وجود الإنسان، وكذلك لا يوجب أن يوجد على حالة واحدة من الطول أو القصر والكبر والصغر وغيرها من الصفات المتقابلة، فالعقل يجوز أن يتصف الإنسان بأضداد هذه الصفات التي يتصف بها، وأكبر دليل على الإمكان هو التغير والتحول من حالة لحالة ومن صفة إلى صفة.
وينبغي أن يُعلمَ أن هذه الأحكام العَقليَّة الثلاثة تنقسم لما هو بديهي وما هو نظري، والبديهي ما يدركه العقل بأدنى ملاحظة من دون تفكير والنظري عكسه، فمثال الواجب البدهي مثلا الحكم بتحيز الجسم، والحكم بأن الواحد نصف الاثنين، لأن العقل بمجرد تصور مفردات هذه القضية وهو معنى التحيز ومعنى الجسم، وكذلك معنى الواحد والاثنين ومعنى النصف يجزم فورًا بوجوب هذه الأحكام واستحالة تخلفها.
وأما النظري من هذه الأحكام فهو الذي يُدَرك بعد مزيد تأمل ونظر وبحث، وهذا النظر لا ينفي عنه قَطعيَّة الحكم إما بالوجوب أو الجواز أو الاستحالة، لكن الفرق بينه وبين الأول وهو البدهي أنه احتاج إلى تقديم عدد من الأدلة والمقدمات للوصول إلى هذه الأحكام الثلاثة.
ومثال الواجب النظري الحكم بوجوب صدق الأنبياء المؤيدين بالمعجزات، ومثال المستحيل النظري الحكم باستحالة التسلسل وهو اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل الممكنة بصورة غير متناهية، مثل أن يتوقف (أ) على (ب)، و(ب) على (ج)، و(ج) على (د)، وهكذا إلى ما لا نهاية.
واستحالة التسلسل: باعتبار أنَّه يؤدي إلى استحالة تحقق أي واحد من المعاليل، وأنَّ فرض تحقق ذلك يستلزم وجود المعلول بلا علة وهو محال.
– وعند فهم هذه المقدمة الأولى، خاصة معنى الواجب والممكن نقول: إن الموجود الواجب والممكن يتصف كل منهما بعدة أمور، فمما يتصف به الممكن:
-1 أنه لا محال في فرض وجوده أو عدمه وإلا فهو واجب لذاته، وتنقلب حقيقته.
2- إن أحد الطرفين الجائزين عليه من الصفات المتقابلة ليس أولى من الآخر.
3-أن إمكانه هو علة احتياجه لغيره.
كذلك نقول إن الواجب له صفات وخواص واجبة له بناء على تصور معناه وهي:
1- أن وجوب وجوده مستمد من ذاته وليس من غيره وإلا لكان ممكنًا.
2- أن عدمه ممتنع.
3- أنه لا يحتاج في وجوده إلى سبب.
وإذا تصورنا ما سبق، فإننا نسأل سؤالا مهما، وهو: إلى أي قسم من الأقسام الثلاثة يوصف به هذا العالم، وأي قسم يوصف به الخالق؟
إن الإجابة الضَّروريَّة أن العالم ينتمي للقسم الثالث وهو الإمكان؛ لأننا قد افترضنا وأثبتنا خلقه أي استحداثه من عدم واستحالة أزليته، وأن العدم سابق عليه وجائز في حقه، وأما الخالق سبحانه وهو الله، فإننا أثبتنا وجوده بناء على بعض المقدمات وهي:
أولًا: أن هذا العالم حادث ومخلوق وممكن.
ثانيًا: أن كل ممكن يحتاج ويفتقر إلى سبب وموجد.
ثالثًا: استحالة تسلسل الأسباب والعلل لا إلى خالق أول قديم.
وقد قدمنا الأدلة القطعية على صحة كل مقدمة من هذه المقدمات الثلاثة، كما أنه لا يخفى أننا لما أثبتنا ضرورة قانون السببية وضحنا أن هذا المبدأ القائل بأن لكل شيء سببًا أساسه هو النظر إلى ماهية الممكن، وهو الذي لا يترجح جانب وجوده على عدمه أو العكس، وذكرنا في أدلة ضرورة استناد كل ممكن إلى سبب، أن ترجيح جانب الوجود على العدم يحتاج إلى مرجح، ويبعد ويستحيل أن يكون هذا الترجيح من تلقاء نفسه؛ لأن ماهية الممكن أي (هويته) تقضي بأنه يستوي جانبا الوجود والعدم فيه لذاته، ومن ثم فإننا نناقض مبدأ الهوية -وهو المبدأ الأول من المبادئ العقلية- إذا قلنا بـأن (الممكن) أوجد نفسه دون حاجة إلى مؤثر خارج عن ماهيته، ومختلف في حقيقة (الإمكان) الذي قد ثبت له.
فبناء على هذا فالله سبحانه واجب الوجود لذاته، أي أن وجوده مستمد من ذاته، ويستحيل عليه العدم؛ لأن ما ثبت وجوبه وقدمه استحال عدمه، وأيضا فإن وجوده ليس مستمدًّا من غيره أو متوقف عليه، وبالتالي يكون التساؤل من خلق الله يحتوي تناقضًا واضحًا، وهو افتراض أن الواجبَ الوجود الذي يستمد وجوده من ذاته ولا يسبقه أو يطرأ عليه العدم، معتمد ومستند في وجوده إلى غيره، وهو خُلفٌ وتناقضٌ واضح في جملة قصيرة.
وعلم أيضا مما سبق أن هذا ليس تخصيصًا في الأحكام العقلية فيما يتعلق بإثبات قانون السببية على العالم، ومنعه على خالق العالم؛ لأنَّا نقول إن السببية متعلقة بإمكان ماهية الموجودات بغض النظر عما تصدق عليه، وهو مما لا يصدق على واجب الوجود الذي نسميه وهو الله سبحانه وتعالى.
– قد أشار القرآن الكريم إلى هذا الفرق في قوله تعالى: (أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُ) [النحل: 17] لبيان الفرق؛ حيث إن ماهية الخالق الواجبة تختلف قطعًا عن ماهية الممكن المفتقرة إلى السبب، كما أنَّ وجود الله سبحانه ليس متعلقًا بالزمان؛ فهو موجود قبل الزمان ومستغنٍ عنه، وأن الزمان قد بدأ بخلق العالم.
فمن المغالطات أيضًا السؤال عن الله بـ متى؟ أو متى كان؟ لأنه يجر أيضا للسؤال بـ (من خلق الله؟)، فهو سبحانه لا يعتمد في وجوده على زمان أو مكان أو سبب.
هل يقدر الله أن يخلق إلها معه؟
ويترتب على ما مرَّ من صفات الممكن وصفات واجب الوجود والتفرقة بينهما أنّ نجد تصوّر مثل هذا السؤال يحتوي على تناقض ومغالطة، وحتى يتضح هذا التناقض وتلك المغالطة فلا بد أن نسأل ما هو الإله؟ وما هي صفة القدرة؟ وهل فرض وجود إله ثاني، أو إله مماثل للخالق القديم واجب أم جائز أو مستحيل بالنظر إلى ذاته؟
والجواب: أنه لما أقمنا الأدلة على وجود الله، استلزم ذلك وصفه ببعض الصفات الواجبة، منها أنه واجب الوجود لذاته، أي يستمد وجوده من نفسه ويستحيل عليه العدم ويستحيل افتقاره أو استناد وجوده من غيره، وكذلك أيضًا أثبتنا له صفة القدرة الكاملة لما رأينا من بديع صنعه إلى إيجاد الممكنات من حيز العدم للوجود، ومن جملة هذه الممكنات هذا العالم بكل ما فيه، أو لما رأينا من آثار هذه القدرة على إعدام هذه الموجودات الممكنة؛ لأنَّ القدرة هي صفة توثر في إيجاد الممكن وإعدامه([28])، ومعنى هذا أن القدرة من صفات التأثير أي هي التي تنقل الممكن من حيز العدم إلى حيز الوجود أو العكس. ويفهم من هذا لماذا لا تتعلق هذه الصفة بالقسمين الآخرين من أقسام الحكم العقلي التي بيناها، وهما الواجب والمستحيل؛ لأن الواجب لا يقبل الانتفاء، والمستحيل لا يقبل الثبوت، ولو تعلقت صفة التأثير وهي القدرة بالواجب أو المستحيل للزم قلب حقيقة كل منهما، وتغير ماهيته وهو محال.
وأما فرض وجود إله ثاني أو إله مماثل للخالق القديم، فهو مستحيل في ذاته؛ لأن الإله هو الواجب المستغني عما سواه، وما دام افتُرِضَ استناد وجود هذا الإله المزعوم إلى إله غيره سابق في الوجود عليه فلا يكون حينئذ إلها؛ لأننا قد جوَّزنا عليه كل صفات الممكن وهو سبق العدم على وجوده وافتقاره إلى غيره، والإله لا يكون إلا واجبا.
واصطلح علماء الكلام على تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى إلى:
أولًا: صفات سلبية أو تنزيهية: وهي تدل على سلب النقص عنه تعالى. مثل صفة القيام بالنفس فمعنى كونه تعالى متصف بها أنه سبحانه وتعالى مستغن عن غيره استغناء تامًّا.
ثانيًا: صفات وجُوديَّة أو ثبوتية: وهي تدل على كمال موجود له سبحانه وتعالى. مثل صفة السمع والبصر في حقه سبحانه وتعالى.
ومن الصفاتِ السَّلبيَّة صفة الوَحدانيَّة:
ومعناها عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال.
ومعنى الوحدانية في الذات أي ليست ذاته مركبة من أجزاء، ولا توجد ذات تشبه ذاته تعالى.
ومعناها في الصفات أي عدم وجود صفتين له تعالى من نوع واحد كعلمين وقدرتين، وعدم وجود صفة لغيره تشبه صفته تعالى.
ومعناها في الأفعال: عدم وجود فعل لأحد غيره يشبه فعله تعالى؛ لذا ذكر العلماء أن الوَحدانيَّةَ الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفي كمومًا خمسة وهي:
الكم المتصل في الذات: وهو تركبها من أجزاء.
والكم المنفصل فيها: وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر، وهذان الكمان منفیان بوحدة الذات.
والكم المتصل في الصفات: وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد كقدرتين فأكثر.
والكم المنفصل في الصفات: وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم بها كقدرته تعالى، أو إرادة تخصيص الشيء بعض الممكنات، أو علم محیط بجميع الأشياء، وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات.
والكم المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد، وإنما ينسب الفعل له على وجه الكسب والاختيار. وهذا الكم منفي بوحدانية الأفعال.
وأما الكم المتصل في الأفعال فإن صورناه بتعدد الأفعال فهو ثابت لا يصح نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك، وإن صورناه بمشاركة غير الله له في فعل من الأفعال فهو منفي أيضا بوحدانية الأفعال.
وقد استدل العلماء على هذه الصفة بأدلة نقلية منها قوله تعالى: (قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ) [الصمد: 1-4].
وقوله تعالى: (مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١) [المؤمنون: 91].
وأدلة عقلية على نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال، ومن الأدلة على نفي التعدد في الذات بمعنى عدم وجود ذات تشبه ذاته، ما يُعرف بـ دليل التمانع: وهو أنه لو فرض وجود إلهين، كل منهما متصف بصفات الألوهية من العلم والإرادة والقدرة …إلخ، فإمَّا أن تنفق إرادتهما، أو تختلقا، وكل من الفرضين محال، فوجود إلهين محال، وبيان ذلك:
أولًا: في حالة الاختلاف بمعنى أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بخلق شيء مثلا، وتعلقت إرادة الآخر بعدم خلقه فالاحتمالات العقلية ثلاثة:
(أ) إما أن ينفذ مرادهما معًا وهو محال؛ لأنه اجتماع للنقيضين (الخلق وعدم الخلق).
(ب) وإما ألا ينفذ مرادهما معا، وهو محال؛ لأنه رفع للنقيضين، ويلزم عجزهما، والعجز على الإله محال.
(ج) وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، وهذا يستلزم عجز من لم تنفذ إرادته، وبما أن الثاني مثله، فهو عاجز أيضا لأن الفرض أنه مثله؛ فما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر
أولا: في حالة الاتفاق بمعنى أن تتفق إرادتهما على فعل شيء واحد مثل إيجاد زيد. فالاحتمالات العقلية أربعة:
(أ) أن يوجداه معًا على سبيل الاستقلال في وقت واحد، وهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد.
(ب) أن يوجداه معًا على سبيل الترتيب، بأن يوجده أحدهما، ثم يوجده الآخر، وهو محال؛ لأنه تحصيل الحاصل.
(ج) أن يوجداه على سبيل المعاونة، فكل منهما يعاون زميله في إيجاده وهو محال؛ لأنه يلزم عجز كل منهما، لاحتياجه إلى الآخر.
(د) أن يوجداه على سبيل التقسيم، بأن يوجد أحدهما بعضه، والآخر بعضه، وهو محال؛ لأنه يلزم عجز كل منهما، فكل منهما لا يقدر على التصرف فيما تصرف فيه الآخر.
وإذا بطلت هذه الاحتمالات سواء في حالة الاتفاق، أو في حالة الاختلاف، انتفى القول بتعدد الذوات، وثبتت الوحدانية لله في الذات بمعنى عدم وجود ذات تشبه ذاته.
وهذا الدليل نجده في قوله سبحانه وتعالى: (مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) [المؤمنون: 91]، وقوله سبحانه وتعالى: (لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ) [الأنبياء: 22]؛ لأننا لو فرضنا وجود إلهين لكل واحد منهما قدرة وإرادة تعلقت بنقيض ما يريده الآخر، كمثل إيجاد زيد أو إعدامه، فلا بد يبعد أن تنفذ قدرتاهما معا أو تنفذ قدرة واحد منهما، والأول مستحيل لما يترتب عليه من اجتماع النقيضين وهو محال عقلا لذاته، والثاني مستحيل لأن الذي لن تنفذ قدرته غير مستحق لوصف الألوهية، فثبت أن وصف الألوهية والوجوب لا يكون إلا لواحد وهو الله سبحانه.
وإذا تقرر ما تقدم ثبتت وحدانيته سبحانه وتعالى واستحال الشريك له، وإذا كان وجود إله مع الله محالا، فنحن لا نقول أن الله يقدر أو لا يقدر أن يوجده، بل نقول إن القدرة لا تتعلق بالمحال، لما بينا أن القدرة صفة تأثير لا تتعلق إلا بالممكنات ولا يلزم على ذلك عجز أو غيره؛ لأن العجز يكون إذا تخلفت القدرة في إيجاد عما تصح أن تتعلق به وهو الممكنات كلها، أما أن تتعلق القدرة بالواجب أو المستحيل فهذا هو المستحيل بعينه لما يترتب عليه قلب الحقائق والماهيات كما بينا.
الثابت الكوني، ودليل وجود الله.
صار هناك اتجاه علموي مادي قائم على فكرة أنَّ الاكتشافات العلمية الحديثة أضحت لديها القدرة التفسيرية الهائلة لكل شيء في الكون، مما يستلزم أنه لا حاجة للدين [الله] بما قدَّمه من إجابات عن أسئلة كبرى تتعلّق بالكون والحياة.
عناية الإله
يُعَنْوِنُ السنوسي في عقيدته: باب: إقامة البرهان القاطع على وجود الله، وبيان احتياج العالم إليه جلّ وعزّ([29]).
وجاء في مقالات الإسلاميين: إنّ المعرفة بالله طريقها الاكتساب، والنظر في آياته، والاستدلال عليه بأفعاله([30]).
داخل إطار النظرية الفلسفية الإسلامية المطروحة في كتب علم الكلام تحدث علماء المسلمين عن دليل من أدلتهم في إثبات وجود الله، هذا الدليل يسمى (دليل العناية) (Guardianship of the Universe) والذي يعني: أنّ العالَمَ بجميع أجزائه موافقٌ في خلقه وتركيبته لوجود الإنسان، وكلُّ ما يوجد موافقًا في جميع أجزائه لفعل واحد، ويكون مسدّدا نحو غاية واحدة؛ فهو أثر لإرادة وحكمة.
وطريقة استدلال علماء الكلام التي تُسمى النظر في آياته بالاصطلاح التراثي تؤدي نفس المُؤدى الذي يتحصّل من ملاحظات التجريبين وما أدّت إليه من نتائج.
وحتى إنَّ القرآن الكريم حين عالج المحاور الكبرى في الاستدلال الكوني أثبت أن الحوادث التي كانت بعد أن لم تكن دالة بخصوصها على المُحدث المتصرّف فيها.
ففي الاستدلال العقلي الذي سلكه النبي إبراهيم -عليه السلام- في إثبات قضيّة الربوبية؛ ليكون من الموقنين، ذكر (الكوكب، والقمر، والشمس) كمثال على أن هناك خط مشترك بينها وهو (التغير) بمعنى: أنها تُوجد/ تظهر بعد أن لم تكن، وتنعدم/ تختفي بعد أن تكون. فلما كان ذلك كذلك فُهم أنّ أوّل صفة ينبغي أن تكون لربّ يُسيّر الكون ألا يكون متصفا بصفة هذه المتغيّرات (الحدوث)، بل ينبغي أن تكون له قدرة غير متناهية فلا يطرأ عليه التغير والحدوث أبدا.
وذِكر القرآن هذه الطريقة من الاستدلال ليس حصرًا للمثال، بمعنى: أن النظر في الكون والملكوت دالّ على وجود الإله، وليس قيد النظر في الكوكب والقمر والشمس فذكرهم على سبيل التمثيل.
وقد يتساءل البعض، لماذا لم يتحدث القرآن -مثلا- عن عمر الكون وعن عدد المجرّات والكواكب وقربها وبعدها عن الأرض وحصول تلك المعلومات لنا ضروري؟
أجاب إمام الحرمين الجويني عن هذا الإشكال بأمر بسيط وهو كما ذكر: “أن دلالة ملك الله تعالى، وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية، وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال، فإذن لا طريق إلى تحصيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا إلى نهاية ولا إلى آخر في المستقبل([31]).
أصبح من المقرر في الفيزياء الحديثة ما يُعرف بالمبدأ الكوسومولوجي Cosmological principle وهو عبارة عن مجموعة من الافتراضات التي تتعلق بتكوين الكون وبنائه، وهذا المبدأ يفترض بأن الكون متجانس ومتماثل المناحي.
تفترض النظرية العلمية الكبرى المعروفة بـ (الانفجار الكبير Big Bang) أنَّ توسع الكون قد بدأ في لحظة معينة من الماضي كان فيها ضغطه وكثافته هائلين. ترجع إلى (13.7) بليون سنة هي عمر الكون، ثمّ حدث تمدد وتوسع للكون، متعادلا في القوى الأربعة المُكوّنة له، وهي: (الجاذبية، والقوة الكهرومغناطيسية، والقوى النووية القوية، والقوى النووية الضعيفة)، بحيث يُنبئ ذلك عن دقّة متناهية في الكون حدث هذا الضبط العظيم بعد الانفجار الكبير بأقل من 1/ مليون من الثانية، مما يُقرر أنّ هناك إرادة عظمى تدخّلت لإحداث ثبات كوني، بحيث لو اختل ذلك لحدث انهيار المنظومة الكونية كلها.
تخيّل الفيزيائي ستفين وينبرغ (الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء 1979م) ما حدث بعد الانفجار الكبير بثلاث دقائق، وألّف كتابه الرائع: “الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون”، وشرح فيه كيف تمدد الكون وتناسق في تناغم شديد منذ اللحظات الأولى وتكوّنه مما يدلّ على أنه لم يكن عشوائيا بل العشوائية هي العكس.
فمثلا:
– لو كانت النسبة بين القوة النووية القويّة والقوّة الكهرومغناطيسية زائدة أو ناقصة -ولو بمقدار شعرة- لما تكوّنت النجوم على الإطلاق.
– لو كانت قوّة الجاذبية أكثر مما هي عليه ولو بمقدار بسيط جدًّا لانكمش الكون وتبعثر، ولما تشكّلت المجرّات والنجوم والكواكب.
يقول عالم الكونيات والفلك البريطاني مارتن ريس: “إنّ سرعة التمدد، والمحتوى المادي للكون، وقدرات القوى الأساسية، يبدو أنها قد كانت متطلَّبا أساسيًّا لظهور هذا الموطن الكوني الكبير الملائم”([32]).
بل إذا أخذنا -مثلا- (كوكب الأرض) الذي نعيش فيه، وكيف تكوّنت صلاحيّته للحياة، وكيف كان يمكن الحال لو لم يكن هناك (عناية) أو (نظام دقيق) مُنح للكون من إرادة عليا متسامية هي التي فطرت/ خلقت/ صنعت/ هذا الكون من عدم، فـ (فطرت الأرض) فكوكب الأرض على ما تُظهره الاكتشافات العلمية يوجد بجواره على نفس المجرّة كوكب أضخم منه بكثير (المُشترى) يقوم باجتذاب النيازك عن أن تقصد الأرض، وإلا كان كوكب الأرض مرمى للنيازك وتدَمّر بشكل كامل.
حجم الأرض لو كان أكبر لزادت الجاذبية مما يعني اجتذاب غاز الأمونيا والميثين السام، ولو كان أصغر لخفّت الجاذبية مما يعني التأثير على كمية المياه الموجودة على سطح الأرض.
قشرة الأرض لو كانت أغلظ مما هي عليه لأثّر ذلك على كميّة الأكسجين في الغلاف الكوني، ولو كانت أخفّ لزادت البراكين والزلازل… وهكذا.
فبحسب الفيزيائي البريطاني الشهير بول دايفيس أن الدراسة المتأنّية لقوانين الفيزياء تُشير إلى أن قوانين الكون متميّزة ومثيرة في: تماسكها وانسجامها وموثوقيّتها على ما فيها من التعقيد.
فالعلم بهذا التناسق العجيب، والتجانس البديع، والدقّة المتناهية، يخبرنا بأن هذا كله لم يكن عن صدفة عمياء، وأنَّ هناك عناية تقف خلف هذا كله، من قِبَل فاعل قاصد مريد.
وكما يقول أنتوني فلو في كتابه هناك إله:
تخيل أنك دخلت إلى غرفة في الفندق الذي تسكن فيه في رحلتك المقبلة، ووجدت أن جهاز التسجيل الموجود بجانب السرير يعزف المعزوفة الموسيقية التي تحبها، ووجدت أن اللوحة المعلقة أعلى السرير تشبه تمامًا اللوحة الموجودة أعلى المدفأة في بيتك، والغرفة ينبعث منها العطر الذي تفضله، فقمت بهز رأسك متعجبًا وألقيت حقائبك على الأرض. بعد ذلك اتجهت إلى الثلاجة الصغيرة الموجودة في الغرفة وفتحت بابها وحدقت في محتوياتها فوجدت مشروبك المفضل وقطعة الحلوى والكعكة التي تحبها، بل وجدت قنينة من نوع المياه الذي تفضله. بعدها، أدرت ظهرك للثلاجة ونظرت إلى المنضدة الموجودة في الغرفة فوجت عليها الكتاب الجديد لمؤلفك المفضل، وعندما ألقيت نظرة في الحمام حيث تصطف على الرف مواد الاعتناء بالبشرة وجدت أن جميعها من النوع الذي تستخدمه في العادة، وعندما قمت بتشغيل التلفزيون وجدت القناة التلفزيونية التي تفضلها.
مع كل شيء تشاهده في الغرفة تجد أنك أقل ميلًا إلى التفكير بأن كل حدث كان من باب الصدفة. أليس الأمر كذلك؟ وقد تتساءل كيف استطاع مدير الفندق أن يعرف كل هذه الأمور التفصيلية عنك. وقد تتعجب من هذا الإعداد الدقيق، حتى إنك تفكر مجددًا كم سيكلفك كل ذلك من مبالغ مالية، ولكنك بالتأكيد سوف تميل إلى الاعتقاد بأن شخصًا ما كان يعرف بقدومك([33]).
تعدد الأديان، وصعوبة الوصول للحق.
تتلخص إحدى أهم الإشكاليات الدينية المعاصرة في نقطة مهمة يتردد حولها الكلام كثيرا، وهي أنه يوجد في العالم حوالي 20 ديانة، كل ديانة منها تنقسم إلى طوائف ومذاهب وأغلب هذه الطوائف والأديان تكفر بعضها بعضًا، ومن أراد معرفة الدين الحق يصعب عليه جدًّا دراسة كل هذه الأديان والمذاهب وتمييز الحق من الباطل منها فيكفي لدخول الجنة ورضا الله مجرد الأخلاق الحسنة، والمعاملات الراقية بين الناس.
والحقيقة أنَّ حلّ هذا الإشكال يتلخص في معرفة أنّ الإنسان في طريقة بحثه عن الخلاص لا بد وأن يتجرّد عن كل العوائق التي تعوقه عن قبول الحقّ، لا سيما إذا كان صادقًا في بحثه.
والإشكالية المطروحة حول صعوبة التعرف على الحق وسط زخم شديد من الأفكار، وتعدد مفرط في الديانات، غالبًا ما يُفضي ذلك إلى سلوك السبيل إذا أقيمت الأدلة والبراهين على الحق لتمييزه عمّا عداه.
والتمييز بين الديانات والأفكار يقوم على إقامة الأدلة على صدق الدعوى التي يدّعيها المدّعي، فمتى ما أقيمت الحجة وجب الاتباع، فكل الديانات جاءت بدعوى أنّ هناك قوة خفية تتحكم في هذا العالم، واختلفت الأنظار في تفسير تلك القوة، فبين مفسر لها على أنّها قوة طبيعية تتحكم فيها الظواهر المختلفة المرتبطة بالتغيرات الفيزيائية في الكون، وبين مفسر لها على أنّها أحد الظواهر المتجلّية للبشر من أعلى، مما يبعث في النفوس إكبارها وإجلالها كالشمس والقمر مثلا، وبين مفسر لها على أنّها أحد الموجودات الحيَّة كالماء والريح والحيوان وهكذا، وبين مفسر لها على أنّها قوة غير مُتصوّرة لا بد من التعرف عليها، ويتوقف على التعرف عليها حتى يُقام له الدليل على صدق ذلك، وعلى كلِّ هذا عبد كل شخص ما رآه من هذه القوة أو عبدها.
القوة التي تُسير هذا الكون هي الطريق الموصل للتعرف على أَيّها هو الحق، هذه القوة جاءت الأديان بإقامة الأدلة على التعرف على كنهها، ونسميها تنزّلا قوة؛ لأنَّ الطباع تميل إلى إجلال ما لا تستطيع أن تضاهيه من القوى والسيطرات.
غالبًا ما يؤول البحث بالإنسان إلى الوصول للحق، والوصول للحق ليس صعبًا حتى مع اختلاف الأديان والمذاهب؛ لأنّ أغلب الأديان سترد إلى الأديان السماوية والمفاضلة بينها سهلة.
يتحدث القرآن عن الله في الأديان فيقول: ﴿۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا﴾ [النساء: 163]، ومعنى الآية أنّ الموحَى به إلى الرسول هو نظير ما أُوحي به إلى جميع الأنبياء السابقين، وما أوحي به إلى الأنبياء السابقين هو توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والمثيل باعتباره خالق هذا الكون ومُنشأه من العدم، والمستحق للعبادة كما سيأتي تقرير ذلك، فيقول: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].
فاتفق جميع الرسل في تبليغ الدعوة إلى توحيد الله بقول (لا إله إلا الله)؛ لأنها أصل كل شيء والباب الذي يفد منه الإنسان للتعرف على الخالق، فالله علم على الذات الواجب الوجود المحدث لجميع حوادث العالم؛ بدليل الحدوث كونها مُحدثة في احتياج إلى مُحدث.
قال تعالى: ﴿۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾ [الشورى: 13].
“فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله ﴿أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾ والمراد: إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه، وبيوم الجزاء، وسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلمًا، ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة. قال الله تعالى: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾”([34]).هـ.
ويترتب على ذلك استشكال آخر، وهو إذا كانت الأديان السماوية مصدرها واحدا لماذا تعددت؟
نقول إن الأديان لم تتعدد بالمعنى المصطلحي الذي يُفهم منه التباين؛ إذ كلها متفقة في أصل الدعوة وهي الدعوة إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وأنه الفاعل والمدبر في هذا الكون بمقتضى فردانيته وصمديته سبحانه، فاتفق جميع الأنبياء على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتنزيهه عن أي شريك أو شبيه أو مثيل، لكن الاختلاف والتعدد وقع في الشرائع بمعنى أن الشرائع مختلفة في بعض الأمور، ومعنى الشرائع هو ما سوى العقائد؛ فإنَّ الدين يتكون من جزأين: العقائد، والشرائع.
فالعقائد التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل متماثلة تمامًا بخلاف الشرائع؛ لأنها متغيرة بتغير العوامل الأربعة في الأحكام (الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال) فما يصلح لبيئة معيّنة قد لا يصلح للأخرى، وما يصلح لأشخاص بعينهم قد لا يصلح لغيرهم من آحاد الناس أو تجمعات البشر؛ فلزم أن تكون الشرائع مختلفة ومتنوعة نوعًا ما؛ لتواكب تطورات البشر، فإن الشرائع مبناها على المصالح، بمعنى أن يُلحظ فيها مصلحة البشر بما يحققها لهم ويدفع عنهم الفساد، لكن هذا لا يعكس فكرة أنّ المؤدَّى واحد.
لقد نالت نظرية داروين وهي نظرية التطور والارتقاء من الشهرة والذيوع في العالم ما لم تنله أية نظرية في العالم، وما لم تنله أية نظرية حديثة حتى اليوم.
وذلك بسبب احتكاك هذه النظرية المباشر بجوانب حساسة من معتقدات الناس وأفكارهم وآرائهم المتمركزة في نفوسهم حول خلق العالم وتكوين الإنسان والروح.
لقد هزت هذه النظرية دنيا العلم، وأشغلت عالم الفكر، وبعثت موجات من الغضب والاستنكار في محيط المتدينين.
كما أن هذه النظرية -في الوقت نفسه- أنعشت روح الإلحاد ووسعت المجال لدعاة التحلل -الإباحية- أن يقولوا أكثر مما كانوا يقولون.
فمنذ ظهور هذه النظرية والصراع حولها مستمر بين العلماء والمفكرين ورجال الدين، وخاصة عندما كانت السلطة الزمنية في يد رجال الكنيسة في أوروبا([35]).
ألقى داروين نظريته التي تلقاها ممن سبقوه إلى وضع أسسها؛ بإصداره كتابه أصل الأنواع الذي أصدره في عام 1859م، وحاول فيه أن يوجد تصورا شاملا مفسرا لنشوء الحياة على الأرض وانتشار الأحياء وتكاثرها وتنوعها، حتى وصلت إلى ما انتهت إليه اليوم من تنوع أجناسها، وكانت محاولته هذه قد آتته حظا في انتشار نظريته وقبولها عند فئة من الناس فور نشرها، وذلك يعود إلى أسباب عدة منها:
بساطة نظريته مع قدرته على عرضها بأسلوب يشد الانتباه، وقد جاءت في وقت سئم فيه الناس-في المحيط الغربي الناهض- تعاليم الدين وأصبحوا يقيسون الإنسان في عقله وتطوره بقدر انسلاخه منه، وقد وقر في نفوسهم أن العلم والدين ضدان لا يلتقيان.
وصادفت نظريته هذه هوى في أفئدة الذين اشتد عداؤهم للدين، وتصوروا أن خلاصهم في الإلحاد الذي يحررهم من تبعات الدين، ويخلصهم من أفكاره التي عدوها تخلفية، فآثروا كل ما يعزز جانب الإلحاد، ولو لم يكن قائما على دليل من العقل ونصيب من الفهم.
وقد قامت نظريته على أسس ثلاثة:
أولها: أن الكائنات لها أصل مشترك، فكلها تنحدر من كائنات حية بسيطة بدأت بها الحياة على وجه الأرض.
ثانيها: أن تغير الظروف الطبيعية والبيئية المحيطة بالكائنات الحية يؤدي إلى ظهور صفات جديدة تفرضها عليها تلك التغيرات.
ثالثها: وهو الأساس لفكره هو الاصطفاء الطبيعي الذي يختار من الكائنات ما تؤدي تغيراته إلى تحسين في نوعه، وإلى قدرة أكبر على البقاء في الظروف المحيطة الجديدة، بحيث تبقى الكائنات التي حظيت على اكتساب صفات تساعدها على العيش في البيئة المتغيرة، وعلى مقاومة الظروف المحيطة، وتتكاثر، وتنقل صفاتها المتميزة الجديدة إلى ذريتها، وذلك إبان انقراض الكائنات الأضعف، أو ذوات الصفات الأدنى، وقد افترض داروين أن الصفات المكتسبة المتميزة يمكن أن تنقل من الكائن الحي إلى ذريته.
وهذا يعني أن التدافع بين الكائنات من أجل البقاء أمر حتمي ينتهي بانتصار الأقوى على الأضعف، وأن الأقوى دائما هو الأصلح، فهو أولى بالبقاء، وعليه فإنه يستمر بقاؤه، وتتنامى قوته، بينما الأضعف يظل في انحسار حتى يتلاشى نهائيًّا، ومعنى هذا أن التطور في الكائنات إنما هو إلى الأحسن والأصلح والأقوى([36]).
إذن فنظرية التطور والارتقاء خلاصتها أن أنصارها يزعمون أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر هذه الأرض بجرثومة أو جراثيم قليلة تطورت من حالٍ إلى حال تحت تأثير فواعل طبيعية حتى وصلت إلى هذه التنوعات التي نراها وعلى رأسها الإنسان.
وعلى هذا فإن الإنسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بجرثومة صغيرة تحولت إلى حيوان صغير ثم تدرج هذا الحيوان إلى حياة حيوانية بدائية فإلى حيوانات أكبر فأكبر ريشية ومجنحة، ثم تحولت إلى ذوات فقرات، ثم ارتقت إلى حيوان أشبه بالإنسان، ثم كانت نهاية هذا التطور إنسانا أول، لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم ثم إنسانا كاملا وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه.
ويقولون إن هذه التحولات والتطورات والترقيات جاءت بعد صراع مرير بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة وتقلباتها وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض عبر آلاف القرون من أجل البقاء.
إذن فالتطور كلمة يقصد بها التحول والانتقال من شيء إلى آخر كما يراد بها الظهور التدريجي لشيء من شيء آخر، وهو عندهم ينقسم قسمين، تطور غير شامل (عضوي) وتطور شامل (عام) فالتطور العضوي يعرف بأنه مفهوم يتضمن الاعتقاد بأن الحيوانات والنباتات تكونت من أشكال سبقتها نتيجة تحول تدريجي مستمر وهو ظاهرة طبعية تعني تغير صورة الكائنات الحية وظهور أنواع وأشكال جديدة منها، أما التطور الشامل (العام) فأشهر القائلين به، هربرت سبنسر، وقد عمم أصحاب هذا الاتجاه تطبيق التطور بهذا المفهوم على الكون كله بما اشتمل عليه من مادة وقوة وبما فيه من كائنات حية وغير حية، وهو يعني: انتقال من البسيط إلى المركب وتغاير تدريجي من الوحدة النوعية إلى الاختلاط والتكاثر النوعي، أو هو ارتقاء من حالة التجانس التركيبي إلى التنافر فيه([37]).
ويمكن تلخيص مذهب التطور النوعي في العناصر الآتية:
1- قابلية الأنواع للتغير ونزوعها إليه، وهذا العنصر يعتبر حجر الزاوية في نظرية داروين.
2- توجد في الطبيعة اختلافات في الأنواع والأفراد.
3- عن طريق النسبة الهندسية لمعدل زيادة الأفراد التي تحدث نتيجة الكوارث فإن عدد أي نوع يجنح نحو الزيادة المطردة، ولكن العدد النهائي في الواقع يبقى ثابتًا بسبب موت العديد من الأفراد، وفي ظل هذه الظروف يحدث:
- تنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة.
- بقاء الأصلح أو الانتخاب الطبعي.
- التكيف مع البيئة.
- وراثة الصفات الملائمة.
- الأصل الحيواني للإنسان.
وهذه العناصر جميعها قد أثيرت قبل داروين وتناولتها الأبحاث العلمية والتأملات الفلسفية النظرية، ولكن داروين هو الذي استطاع أن يقوم بجمعها في صورة رائعة وعمل متكامل في أبحاثه عن أصل الكائنات الحية وتطورها في دقة وصبر وأناة([38]).
أول المؤسسين لنظرية التطور والارتقاء:
مؤسسو نظرية التطور والارتقاء وقطبا رحا هذه النظرية اثنان:
- لامارك وهو مؤسسها.
- داروين وهو مطورها وحامل لوائها وباذل عمره في سبيل تعضيدها ونشرها.
إلا أن القائلين بنظرية التطور والارتقاء مع اتفاقهم على أصول هذه النظرية، فإنهم يختلفون من حيث النتاج الفلسفي للنظرية.
آراء العقيدة الدينية
ففريق منهم قد جعل من هذه النظرية منطلقًا للدعوة إلى الإلحاد وجعلها سندًا له في إنكار العقيدة الدينية، واتخذ منها فلسفة لنفي الخالق سبحانه وتعالى وأعطى المادة صفة القادر على كل شيء، وعلى رأس هذه الفريق الفيلسوف الفرنسي لامارك والعالم الألماني أرنست هيكل والبروفسور الشيوعي أوبارين وغيرهم من ماديين وشيوعيين.
وفريق لم يستند إلى هذه النظرية في إنكار العقيدة الدينية ولم يجعل منها قاعدة للدعوة إلى الإلحاد وإنكار الخالق سبحانه وتعالى، ولم يزعم أنه بها يفسر سر الحياة أو سر الكون، وإنما كان همه الوحيد البحث عن أصل الأنواع الحية وتكوين فكرة عن أصل نشأتها وصلة بعضها ببعض، ومعرفة الأحوال والمؤثرات والتقلبات التي تعرضت لها عبر آلاف القرون، وعلى رأس هذا الفريق العالم الشهير تشارلز داروين([39]).
الإلحاد ونظرية التطور:
يزعم الجناح الإلحادي من أنصار هذه النظرية أن الحياة الأولى جاءت نتيجة تفاعل طبعي بين أجزاء من المادة، هذه المادة التي يزعمون أنها كانت ولم تزل قادرة بطبعها على إعطاء الحياة، ولهذا فهم ينكرون أن تكون الحياة من صنع قوة فوق الطبيعة.
فهذا الجناح الإلحادي عندما يتحدث عن مراحل التطور والارتقاء يخرج من حسابه قوة ما فوق الطبيعة وهي القوة الإلهية؛ لأن حالة المادة بزعمهم لا تحتاج إلى هذه القوة، فالطبيعة الملازمة للمادة بحركتها الدائبة هي التي تخلق وتبدع وتنوعت وتطور وتصطفي وتبيد([40]).
هذا والطبيعة عند لامارك هي القوة العامة الملازمة للمادة المنزهة عن الفساد التي لا تفتر عن التأثير في المواد طرفة عين، غير أنها مجردة عن العقل ومحكومة بقوانين هكذا يقول لامارك.
وإذا كان داروين أعلن عجزه عن معرفة سر الحياة وكيف ومما تكونت؟ فإن لامارك يزعم أنه قد عرف كل ذلك عن الحياة.
فهو يزعم أن الحياة قد تكونت من المادة مباشرة بفعل الطبيعة وعلى سبيل المصادفة، وذلك بعد عملية مزج مواد مخصوصة بعضها ببعض يقول:
إن الطبيعة تولد بعض الكائنات توليدا مباشرا، فتعمد إلى تكوين منسوج خلوي من الكتل الصغيرة للمادة الجلاتينية التي نجدها تحت يدها، ثم تملأ هذا الكتل الخلوية الصغيرة في الأحوال الموافقة بالسوائل المناسبة وتحييها بتحريك هذه السوائل بواسطة سوائل ألطف منها طبيعتها التهييج تأتيها على الاستمرار من البيئات المحيطة.
ويقول عن قوة الحياة: إنها ليست بقوة خاصة وإنما هي نتيجة خاصة لبعض المركبات، وجودها وقتي فيها، وأن الأنواع الحية لم تتكون إلا شيئا فشيئا، ووجودها نسبي وبقاؤها محدد، والطبيعة في تكوينها الحيوانات بدأت من الأدنى فما فوقه حتى انتهت إلى الأعلى، ولا فرق في ذلك بين النباتات والحيوانات إلا في الحس، والحياة عند لامارك عرض طبعي وليست بأصل مستقل([41]).
إن نظرية التطور تحمل عند البعض نزعات إلحادية، وبعض الذين يرون صحتها تذهب بهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى فهم يرون أنها تعتمد في المقام الأول على إنكار الله وأنه ليس ثمة خالق لهذا الكون وأن الكائنات تم خلقها بواسطة الطبيعة وأنها نشأت عن أصل واحد، وأنها تكونت بخلق الطبيعة وبالتولد الذاتي، وأن هذا التنوع والتعدد الذي نراه ما هو إلا نتيجة التطور الذي نشأ نتيجة الصراع بين الكائنات والطبيعة من جهة وبينها وبين بعضها من جهة أخرى، وأن هذا الصراع ولدته حاجة الكائن للبقاء، ولم يبق من الكائنات إلا أقواها وأصحها، وهذا كله أي التوالد وتطور الكائنات جاء من انتخاب طبعي واصطفاء نوعي، وليس ثمة داع لوجود إله خالق لهذه الكائنات، لأن الذي تولى تنظيم هذا كله المادة ليس غير، والتطوريون خلعوا على هذه المادة كل أوصاف الإله وخصائصه([42]).
لكن في الوقت الذي ينادي فيه فلاسفة النزعات الإلحادية بالحتمية وبضرورة الربط بين الأسباب والمسببات، ويرون أن العلاقة بينهما ضرورية ولا انفكاك بينهما، نجد أن هناك تناقضًا واضحًا وصريحًا بين مبادئهم التي أعلنوها وقوانينهم التي قننوها وبين دعائم مذاهبهم وما تقوم عليها من نظريات، وأن هذا يتضح جليًّا في مذهب النشوء والارتقاء الذي يفتقر إلى معرفة السبب الكامن وراء التغيرات، ويكفي أن يكون الجهل بهذا السبب تقويضا لصرح هذه النظرية.
يقول جون كيمني عن نظرية النشوء والارتقاء واحتياجها إلى معرفة السبب الكامن وراء التغيرات:
هناك اتفاق عام بأن هنالك فيضًا من الكائنات الحية يؤدي إلى تنازع البقاء، وبالتالي إلى عملية انتخاب طبيعي، تقوم بالحفاظ على الأفراد الذي تستبين لديهم مميزات بالنسبة لأقرانهم، كما أن هنالك اتفاقا بأن هذه الفروقات متأتية من تغيرات في الصبغيات أو من التحولات الفجائية، غير أن الخلاف هو في السبب الكامن وراء هذه التغيرات([43]).
ومن ناحية أخرى فإن مذهب التطور إذ ينكر وجود إله يدبر أمر هذا الكون فإنه يناقض نفسه حين ينادي بالتطور المنتظم المتقدم نحو غاية عليا، نعم هو تناقض صارخ إذ يستحيل في العقول والتي دائما ما يتمسح فيها أرباب تلك المذاهب في نكرانهم للعقائد الدينية أن يخرج الأعلى من الأدنى فهذا توهم ظاهر.
ونحن بدورنا لا ننكر أن يكون هناك تطور، والأديان في جملتها لا تنكر التطور فهو بمثابة السنة الكونية الطبعية التي لا تتخلف، لكن التطور الذي تقره الأديان ليس بهذا المفهوم الذي تقول به نظرية التطور الذي يعتمد على الصدفة والعشوائية وليس له وجهة أو غاية.
وتلقي الحيرة بظلالها على الإنسان عندما نجد داروين نفسه لا ينكر الإله الخالق فيقول فيما ينقله عنه إسماعيل مظهر من كتابه أصل الأنواع:
هنالك مؤلفون من ذوي الشهرة وبعد الصيت مقتنعون بالرأي القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة، أما عقليتي فأكثر التئامًا مع المضي مع ما نعرف من القوانين والسنن التي بثها الخالق في المادة، والاعتقاد بأن نشوء سكان هذه الأرض وانقراضهم في الحاضر والماضي يرجع إلى نواميس جزئية مثل النواميس التي تحكم في توليد الأفراد وموتهم.
وعند النظر في كتاب داروين (أصل الأنواع) تجد فيه بعض العبارات والجمل التي تستوقفك متسائلا هل كان مؤمنًا بالخلق أم لا؟ وإذا كان مؤمنًا فلم قال بهذه النظرية؟ وإذا لم يكن مؤمنا فلم قال هذه العبارات؟!
من هذه العبارات قوله «فإذا اعتقد معتقد أن هذه الأنواع قد خلق منها مستقلا، فلا يسعني إلا أن أعتقد أن كلا منها خلق وفيه نزعة إلى التحول؛ سواء أكان بتأثير الإيلاف أم بتأثير الطبيعة الخالصة -ثم يعقب على من يقول بالخلق استقلالا- وما هذا الزعم إلا تبديل غير ثابت بثابت، أو على الأقل غير معروف بمعروف، فهم يشوهون صبغة الله وخلقه».
ونراه يختم كتابه بقوله «إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها لأول مرة».
هذه الجمل أثارت تعجب كثير من الباحثين، وأثارت تساؤلهم «هل كان ذلك خطة مداهنة ومصانعة للمؤمنين بالله حتى لا يثوروا عليه، ويرفضوا آراءه جملة وتفصيلا، أو كان من المؤمنين بالله إيمانًا نصرانيًّا، ولا سيما وهو خريج دراسات لاهوتية، إلا أن الملاحدة واليهود قد استغلوا مذهب التطور لتأييد المادية وإنكار وجود الخالق من وجهة نظرهم».
وقد تزول هذه الحيرة أو تزداد عندما نرى كاتبًا بحجم العقاد ينفي عن داروين نزعة الإلحاد وإنكار الإله، وأنه ليس في مذهبه ما يدل على ذلك غاية الأمر عنده الشك في الديانات التقليدية، يقول:
لقد هوجم المذهب كثيرًا باسم الدين، وجعله بعضهم مرادفًا للإلحاد والمادية، ومع هذا لم يكن والاس ولا داروين ملحدين معطلين، وكان والاس شديد الإيمان بالله، خامرته الشكوك في الديانة التقليدية، ولم تخامره في الإيمان بالله وبحكمته، ومن كلامه ما يستدل به على تصديق المعجزات وخلود الإنسان، أما داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي وجود الله، ولم يقل قط إن التطور يفسر خلق الحياة، وغاية ما يذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتية.
وقد استدل العقاد على ما ذهب إليه بإجابة داروين عن سؤال وجهه إليه طالب هولندي عن عقيدته الدينية فقال:
إن استحالة تصور هذا الكون العظيم العجيب وفيه نفوسنا الشاعرة قائما على مجرد المصادفة هي في نظري أقوى البراهين على وجود الله([44]).
يقول يوسف كرم:
وقد أخذ على داروين أن نظريته ماديَّة إلحاديَّة، والواقع أنه لم يشأ أن يستثنى الإنسان من قانون التطور العام، وقد كان مؤمنًا بالله إلى وقت ظهور كتابه أصل الأنواع، وقال في ختامه إن الصور الحية مخلوقة، ثم تطور فكره شيئا فشيئًا حتى أعلن أسفه لاستعماله لفظ الخلق مجاراة للرأي العام، وصرح بأن الحياة لغز من الألغاز وأن ما في العالم من ألم يعدل بنا عن القول بعناية إلهيَّة وأنه هو “لا أدري” لا يقول بالعناية ولا بالصدفة([45]).
ومن هنا فقد برز من يقول بأن التطور لا يتناقض مع الأديان من جهة ومع القرآن من جهة أخرى.
يقول الدكتور باسل الطائي وسوف ننقل كلامه هنا بتمامه:
من الشائع القول بأن فكرة التطور العضوي للإنسان والكائنات الحية تتعارض مع الدين، وسبب ذلك أن التفاسير التي قدمها الناس للنصوص الدينية تقضي بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية من التراب هكذا مرة واحدة، وخلق الإنسان من الطين بعد أن جعله مناسبًا لتشكيل هيئة الإنسان وصورته التي هو عليها، وحتى عهد قريب كان الناس يعتقدون أن الحشرات والديدان والنمل نشأ ذاتيًّا عن المواد غير الحية، وهذا ما كان يعتقده أرسطوطاليس وكثير من حكماء اليونان.
من جانب آخر يقرر القرآن الكريم على وجه الخصوص أن الله تعالى خلق الإنسان من الطين، ويؤكد ذلك ظاهر الآيات القرآنية الآتية:
﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59].
وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ﴾ [الحج: 5].
وقوله: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٞ تَنتَشِرُونَ﴾ [الروم: 20].
وقوله: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ أَزۡوَٰجٗا﴾ [فاطر: 11].
وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا﴾ [غافر: 67].
فهذه الآيات تؤكد أن الخلق كان من التراب وعلى وجه الدقة يشار بذلك إلى خلق آدم نفسه، أما بعد آدم فالخلق يكون من النطف، وهنا نقف على مسألة أساسية في فهم الخلق من التراب في القرآن، فقد جاء هذا المفهوم على مستويين الأول: أن يكون القصد خلق آدم الإنسان الأول، وهذا يقود إلى اعتبار ألف لام التعريف للعهد، والثاني: أن يكون قصد به خلق الإنسان أي جنس الإنسان وذلك من خلال الدورة الغذائية التي أصلها التراب والماء، والذي يصير نباتًا يأكله الناس أو الحيوان، فيكون غذاء ينشأ عنه المني والبيضة التي يكون منها الإنسان.
على أن النظر الدقيق في هذه الآيات يبين أن القرآن الكريم يخفي تعابيره في قضية الخلق على نحو يجعلها قابلة للتفسير بأكثر من وجه، وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله: القرآن حمَّال وجوه.
وهذه هي المتشابهات التي أقرها القرآن في قوله تعالى من الآية السابعة في سورة آل عمران: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾ [آل عمران: 7].
وهذه مسألة يقرها جميع المفسرين فالقرآن يحمل المحكم والمتشابه، أما المحكم فهو في الأوامر والنواهي والحدود، وأما المتشابه فهو ما جاء أغلبه في الأمور الغيبية والعقائدية والأمور التي تخص نشوء العالم والإنسان بمعنى أن للنص القرآني أكثر من معنى يمكن أن يحمل عليه، وهذا أمر معروف وهو ما فتح الباب لطرح أفهام مختلفة لمعاني الآيات القرآنية وهو ما سمي بالتأويل إلا أن من الواجب القول بأن البعضَ يتأول القرآن تأولًا يخرج النص عن القصد حتى لكأنه يحتمل معنى مناقضًا تمامًا لما يتبادر للذهن، والتفسير أو البيان الصحيح للمعنى ينبغي دومًا أن يلتزم بما تقرره اللغة العربية، وما يقرره سياق النص أيضا، والسبب في أن القرآن حمال أوجه يعود لكونه قد احتوى المعرفة المطلقة في وعاء اللغة العربية، فتمت صياغة تلك المعرفة المطلقة بكلمات وجمل عربية جاءت في صياغة تحتوي المعاني الدقيقة على وجهها الحقيقي، فكان لا بد أن تكون تلك الصياغات مموهة؛ لأن معرفة الإنسان في أي عصر من العصور لم ترقى لأي حال من الأحوال إلى معرفة الخالق نفسه. بل هي في تطور مستمر وكلما تقدمت معارف الإنسان تم الكشف عن معانٍ أخرى لآي القرآن، وهكذا يكون القرآن معجزة دائمة على مر الزمان، وعلى الذين يريدون الاستفادة من هذه المعجزة الدائمة تقليب الوجوه كلها وتثويرها، ولكن بالضرورة ضمن ما هو معهود من معانٍ ودلالات تقرها اللغة ويوحي بها السياق.
من المنطقي القول بأنه لم يكن بالإمكان الإفصاح عن المضامين المتعلقة بالخلق وغيره من المسائل التي هي على قدرٍ كبيرٍ من التطور في الفهم، والكشف لأهل عصور لا تفهم تلك المضامين ولا تتقبلها، فلو أن القرآن أفصح القول في تلك المسائل فتطلب الأمر كثيرًا من الشرح والتقديم لعلوم كثيرة ومعارف جديدة ولعجز الناس عن تقبله وفهمه؛ لذلك تبدو الآيات التي تتعرض إلى هذه المواضع مبهمة، فنحن نعرف المعاني غالبًا على وجه الإجمال، ولا نستطيع القطع بالتفصيل، ومثال ذلك أيضًا ذكر السماوات السبع وخلقها ومصيرها فقد عرضت آي القرآن في هذه المسائل نصوصًا محيرة، ولتفسيراتها وجوه كثيرة، ونحن لا نستطيع القطع بأي منها بل يبقى أمامنا أن نقبل بعضها على أنه ممكن فحسب.
وقد قمت ببحث هذه المسألة تفصيلا، بالمشاركة مع زميل لي متخصص في اللغة العربية وآدابها وقد تم نشر البحث في مجلة أكاديمية محكمة، وقد وجدنا من خلال النظر المتفحص أن متشابه القرآن جاء في أمور لا يمكن الحديث فيها، على وجه التفصيل المفهوم لكل عصر وزمان، بل هو في مسائل تتطلب تطورًا معرفيًّا متقدمًا في الغالب، وهذا ما لم يكن لتتحمله أفهام العصور السابقة.
السبب الآخر الذي يمنع كثيرا من الناس من قبول فكرة التطور العضوي للكائنات الحية بما فيها الإنسان هو الظن بأن الاعتراف بالتطور الطبيعي يتضمن القول بنفي القدرة الإلهية في الخلق وإنكارها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإلحاد؛
إذ يقول المؤمنون وماذا يبقى لله في الخلق؟! والحق أن الفهم الصحيح لأمر الله في العالم ووجوده يقرر أن (الأمر كله لله)، وما هذه المظاهر والميكانيزمات (الآليات) التي تبدو أفعالًا طبيعية كما يقال إلا مظاهر تخفي وراءها حقيقة أن (الأمر كله لله) فهو الحي القيوم.
والقوانين التي تعمل بها الآليات الطبيعية (والتي أحب أن أسميها السنن الفطرية) إنما ترتكز في جوهرها إلى الاحتمال وليس إلى الحتم، كما بينت في فصول سابقة، هذا ما تقرره الفيزياء المعاصرة على سبيل القطع في نظرية الكموم، ولما كانت قوانين الكيمياء وعلوم الحياة التي تفسر الفعاليات الحيوية مرتكزة إلى قوانين الحركات الذرية والجزيئية، فإن هذا مآله أن قوانين الكيمياء الحيوية والتحولات الأحيائية هي قوانين جوازية احتمالية في نتائج عملها وليست حتمية، وهذا ما أثبته العلوم الحديثة ومكتشفات القرن العشرين، وحين نعلم أن عدد الاحتمالات المتيسرة أمام أية عملية حيوية عادة ما يكون كبير جدا، جاز لنا بالتأكيد أن نتساءل عمن يتحكم بتلك الاحتمالات ويسوقها إلى التحقق بالنتيجة التي تكون عليها، ومن المؤكد أن أية جزئية من جزئيات العناصر المتفاعلة لا يمكن أن تمتلك مثل تلك القدرة على التحكم الشمولي إذ لا بد من أن يكون عنصر التحكم ملما بكافة الأجزاء وخصائصها عالما خبيرًا بكل شروطها ودقائقها، مهيمنًا على جميع سبلها وغاياتها؛ لكي يقع أمامنا تطور إيجابي متصاعد كالذي نشهده فعلا، ولن يكون ذلك إلا لقدرة عليم حكيم خبير، لذلك نقول أن (الأمر كله لله).
وهنا يحضرني قول الفيزيائي البريطاني بول ديفز إذ يقول في كتابه عالم الصدفة:
إن تفسيرًا منطقيًّا للحقائق يوحي بأن قوة هائلة الذكاء قد تلاعبت بالفيزياء، بالإضافة إلى الكيمياء وعلوم الحياة، وأنه ليس هنالك قوة عمياء في الطبيعة تستحق الحياة بصددها، فأي قوة عمياء وأية عشوائية يمكنها أن تجد كل هذا النظام والرقي التكويني الذي نراه في العالم([46]).
ثم يتابع الدكتور باسل الطائي حول مبدأ التطور والقرآن فيقول:
سأقدم فيما يلي اجتهادي لفهم النصوص القرآنية فيما يتعلق بمسألة خلق الإنسان، وغايتي في ذلك تحري الحق وتبصير النفس والعقل بنور الحق ليرتقيا إلى مراقي الفهم الصحيح ومنهجية النظر في هذا البحث تقوم على مراجعة النصوص القرآنية المتعلقة بخلق الإنسان ونشأته وتطوره واعتماد اللغة لتفسيرها وفهمها والاستعانة بتفاسير القرآن المعتمدة لدى المسلمين، وأشهرها تفسير ابن كثير، ولسوف أعرض لما جاء في القرآن مقدما ما جاء بأشهر التفاسير عنها لغرض الاطلاع على ما كان قال به السلف.
جاء في سورة الحجر من الآية 26 ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ﴾. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية:
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال هاهنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى ﴿خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ كَٱلۡفَخَّارِ١٤ وَخَلَقَ ٱلۡجَآنَّ مِن مَّارِجٖ مِّن نَّارٖ١٥﴾ [الرحمن: 14- 15]، وعن مجاهد أيضًا: الصلصال المنتن، فتفسير الآية بالآية أولى، وقوله ﴿مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ﴾ [الحجر: 26]؛ أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس، ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال هو التراث الرطب، وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا والضحاك: إن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد بالمسنون: المصبوب.
ما نشير إليه هنا أن معنى الحمأ المسنون يحتمل أن يكون هو التراب الندي النتن القديم، وهذه المعاني هي في أصول كلمتي صلصال وفخار، يقول ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة
الصاد واللام أصلان أحدهما يدل على الندى وماء قليل، وآخر على صوت.
وقال في معنى مفردة الفخر:
“الفاء والخاء والراء أصل صحيح يدل على عِظَمٍ وَقِدَمٍ… ومما شذ عن هذا الأصل الفَخَّارُ مِنَ الْجِرَارِ ، معروف”.
من الواضح أن هنالك شيء من التوافق بين النص القرآني في نشأة الحياة، وما تقترحه البيولوجيا التطورية فإذا كانت الكائنات قد تطورت عن أخرى وحيدة الخلية، أو عن المحاليل العضوية وتراب الأرض، فها هي إذن يسميها القرآن الحمأ المسنون، ثم جاء في الآيتين 28، 29 من سورة الحجر ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ٢٨ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ٢٩﴾ [الحجر: 28- 29].
نلاحظ هنا أن أمر الله للملائكة بالسجود للإنسان معلق على شرط تسويته والنفخ من روح الله فيه بقوله فـ (إذا) أأأي أن سجود الملائكة تالٍ للخلق ومشروط بالتسوية والنفخ، وهذا أمر مهم يتوجب الانتباه إليه ورب من يرى أن الآية التي ذكرناها هنا لا تفيد بوضوح ما إذا كانت التسوية والنفخة حصلت على التراخي أم على العجلة، لكن الجواب على ذلك واضح، بين، في سورة السجدة كما سيأتي بيانه، وفي التسوية يورد الحافظ ابن كثير في تفسيره ما يفيد أن معناها هو أن يجعل مشية الإنسان مستقيمة على قدميه فيقول:
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بشر بن جحاش قال: ((بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال: يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق؟ وأنى أوان الصدقة)).
الشاهد في هذا الحديث هو الإشارة الصريحة على استقامة الإنسان على طوله، قد جاءت كمرحلة تطوره، لكن السؤال: هل أن هذه الإشارة هي إلى نوع الإنسان أم هي للإنسان الفرد؟ الأرجح في ظاهر القول أنها للإنسان الفرد، لكننا سنرى أن القرآن يورد التعديل بالمضمون قصد به نوع الإنسان نفسه، من سورة المؤمنون الآية 12 في قوله: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾ [المؤمنون: 12].
هنا نقف على تعبير مهم ذي شأن في اعتبار الخلق، وقصده ذلك أن الآية قد أوردت مفردة (سلالة) وهذه واحدة من آيتين وردت فيهما المفردة، إذ نقرأ في السجدة ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ﴾ [السجدة: 8].
فما معنى السلالة هنا؟ في اللغة نقرأ في لسان العرب:
والسلالة: ما انسل من الشيء. ويقال: سللت السيف من الغمد فانْسَلَّ. وانسل فلان من بين القوم يعدو إذا خرج في خفية يعدو. وفي التنزيل العزيز:
﴿ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمۡ لِوَاذٗا﴾ [النور: 63]؛ قال الفراء: يلوذ هذا بهذا يستتر ذا بذا؛ وقال الليث: يتسللون ويَنسَلُّون واحدٌ. والسليلة: الشعر ينفش ثم يطوى، ويشد ثم تسل منه المرأة الشيء بعد الشيء تغزله. ويقال: سليلة من شعر لما استل من ضريبته، وهي شيء ينفش منه ثم يطوى ويدمج طوالا، طول كل واحدة نحو من ذراع في غلظ أسلة الذراع ويشد ثم تسل منه المرأة الشيء بعد الشيء فتغزله. وسلالة الشيء: ما استل منه، والنطفة سلالة الإنسان… وفي التنزيل العزيز: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾ [المؤمنون: 12]؛ قال الفراء: السلالة الذي سل من كل تربة؛ وقال أبو الهيثم: السلالة ما سل من صلب الرجل وترائب المرأة كما يسل الشيء سلا. والسليل: الولد سمي سليلا لأنه خلق من السلالة. والسليل: الولد حين يخرج من بطن أمه، وروي عن عكرمة أنه قال في السلالة: إنه الماء يسل من الظهر سلا؛ وقال الأخفش: السلالة الولد، والنطفة السلالة؛ وقد جعل الشماخ السلالة الماء في قوله: على مشج سلالته مهين.
قال: والدليل على أنه الماء قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ﴾ [السجدة: 7]، يعني آدم ثم جعل نسله من سلالة، ثم ترجم عنه فقال: من ماء مهين؛ فقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ﴾ [المؤمنون: 12]؛ أراد بالإنسان ولد آدم، جعل الإنسان اسما للجنس، وقوله ﴿مِّن طِينٖ﴾ أراد أن تلك السلالة تولدت من طين خلق منه آدم في الأصل، وقال قتادة: استل آدم من طين فسمي سلالة، قال: وإلى هذا ذهب الفراء؛ وقال الزجاج: من ﴿سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾، سلالة فعالة، فخلق الله آدم عليه السلام([47]).
نستنج من هذا أن السلالة وهي ما يسل وهي التي على وزن (فعالة) إنما يمكن تفسيرها على أنها النطفة ولو قال تعالى سلالات، لكان المعنى المرجح أنها أجيال، ولكن يصح القول أيضا أنه ربما منع قوله سلالات أن سلالة الإنسان مفردة بمعنى أن تطوره لم يكن إلا عن سلالة واحدة تسلسلت من جيل إلى جيل، حتى بلغ مرحلة التسوية أي جعله سويًّا في المبنى والمعنى والخلاصة فيما أجد أن السلالة التي في الآية من سورة المؤمنون ربما قصد بها أجداد الكائن الذي صار إليه جنس الإنسان، وأما السلالة التي في السجدة فلعل القصد منها النطفة؛ وهي التي تنسل من الماء المهين الذي يحف النطف، وذلك عندي بين من التركيب، يقول الله تبارك وتعالى:
﴿ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ٨ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفِۡٔدَةَۚ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ٩﴾ [السجدة: 7- 9].
فيه هذه الآيات ترتيب تسلسل الخلق وهو هنا على ثلاثة مراحل البدء من الطين، وسبق قوله: إن هذا الطين رطب منتن قديم (صلصال كالفخار)، وفي موضع آخر هو الطين اللازب أي الذي يلتزق باليد، ثم التكوين المتناسل من ماء مهين، وهذا لا يكون إلا لأنواع الحيوانات العليا أيضا، فالبدائيات لا تتماثل بالماء المهين، بل بالانقسامات المتكررة، لذلك كانت ضرورة وجود (ثم). فهذه المرحلة ربما حصلت على التراخي الزماني ثم التسوية (وهي التعديل والاستقامة) فالنفخة من روح الله والتي بها صار الكائن الأول إنسانا.
ويجب الانتباه إلى أن (ثم) في اللغة تفيد التعاقب على التراخي، أي مرور زمن ليس بالقليل، أما اعتبارنا التسوية على أنها التعديل وتحقيق استقامة البدن، فإشارتها في قوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ٦ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ٧﴾ [الانفطار: 6- 7].
كما أن الحديث القدسي الذي أورده ابن كثير وذكرته آنفًا يتعلق بهذه المسألة، ويعني أنه يفسر معنى التسوية باعتدال القامة وهذا يتوافق أيضا مع القول بأن التسلسل التطوري السابق للإنسان يبين أنه كان يمشي على أربع، ثم استقام واعتدل، أما النفخ من روح الله، من قوله تعالى ﴿وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: 29] فهي التي نقلت الكائن السابق للإنسان تطوريا إلى حالته كإنسان، وذلك حين امتلك العقل والقدرة على الإبداع، فتحول من كائنٍ غير عاقل إلى آخر عاقل، قادر على الإبداع والاختراع، وبذلك استحق سجود الملائكة له.
وهذا السجود هو حركة رمزية تعبر عن الخضوع والذل، ويتضح هذا من المعنى اللغوي للسجود؛ إذ يقول ابن فارس في معجم المقاييس: (السين والجيم والدال أصل واحد يدل على تطامن وذل، وكل ما ذل فقد سجد).
وسبب ذلك أن الملائكة هم جند الله ورسله الذين بهم يقوم العالم، والذين بهم يسير الله العالم، وسجودها لآدم يعني أن آدم قد خول ناصيتها وهيمن عليها، وتمكن منها بالقوة أولا، وبالفعل لاحقًا، فالله قد أعطاه القدرة على الإبداع والتركيب بالنفخة من روحه القدسية، التي نفخها فيه، وللإنسان أن يستثمر هذه أو لا يستثمرها، وقد جاء أمر الله بسجود الملائكة لآدم بعد أن كمل خلقه وتصويره والنفخ فيه من روح الله وتعليمه الأسماء، في سورة الصافات قوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۢ١١﴾ [الصافات: 11].
يقول ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد، وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد.
وهنا الإشارة في الآية بليغة من حيث أن أول الخلق كان ماء وطينًا، وهذا إنما يتفق إجمالا وليس على نحو التفصيل بالضرورة مع نشأة الحياة الأولى بحسب التصور المعاصر الذي جاءت به العلوم الأحيائية.
وفي سورة الإنسان قوله تعالى ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡٔٗا مَّذۡكُورًا﴾ [الإنسان: 1]، في الآية تساؤل واضح يحمل معنى الإخبار أن العالم كان والإنسان لم يكن بعد، فلهذه الآية تفاسير كثيرة ويورد الطبري في تفسيره أن الاستفهام هنا غرضه تقرير الواقعة، لكن المشكل هو في تحديد الزمن المقصود بهذا الدهر الذي مر على الإنسان دون أن يكون شيئا مذكورًا، وتجمع التفاسير تقريبًا على أن المقصود بالإنسان هو جنس الإنسان، أما بشأن الحين من الدهر المقصود وطوله ففيها قليل من الأقوال، وجدت أفضلها ما ذكره الماوردي في النكت والعيون إذ يقول:
وفي قوله تعالى: ﴿حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ﴾ [الإنسان: 1] ثلاثة أقاويل: أحدها:
أنه أربعون سنة مرت قبل أن ينفخ فيه الروح، وهو ملقى بين مكة والطائف، قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه.
الثاني: أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة، ثم من حمأ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة، فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة، ثم نفخ فيه الروح، وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. الثالث: أن الحين المذكور ها هنا وقت غير مقدر وزمان غير محدود، قاله ابن عباس أيضًا([48]).
سورة الانفطار قوله تعالى ﴿ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: 7].
قال الفخر الرازي:
وقال عطاء عن ابن عباس جعلك قائمًا معتدلًا حسن الصورة لا كالبهيمة المنحنية، وقال أبو علي الفارسي: عدل خلقك فأخرجك في أحسن التقويم وبسبب ذلك الاعتدال جعلك مستعدًّا لقبول العقل والقدرة والفكر وصيرك بسبب ذلك مستوليًا على جميع الحيوان والنبات وواصلًا بالكمال إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم([49]).
مما يعني أنه يسوق القصد إلى جنس الإنسان ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره:
أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال.
بهذا نفهم أن التسوية والتعديل تشتمل على استقامة الجسد واعتدال القامة وانتصابها وهذا واضح صراحة من كلام ابن كثير هنا. وعليه تكون مراحل التطور العضوي للإنسان بحسب ما يقرره القرآن الخلق والتسوية والتعديل، وقد جاء في سورة التين ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ٤ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ٥﴾ [التين: 5- 6].
وربما أمكن القول أيضا أن هذه الآيات ربما حملت معنى حصول نقوص تطوري في سيرة التطور العضوي للإنسان، فلحقه مسخ عضوي جعله شبيها بالحيوانات من الناحية التشريحية والتكوينية، بمعنى أن هنالك وجهًا لفهم هذه الآية على أن القصد منها أن الإنسان كان قد خلق في أول العهد بهيئة ومضمون راقيين أرقى مما هو عليه الآن، ثم جرت به المقادير فحصل في خلقه نقوص تطوري صار به الإنسان إلى حالة خلقته الحاصلة الآن من كونه شبيا بالحيوان من الناحية المورفولوجية وغيرها ومما يعضد هذا المذهب قوله تعالى في سورة طه ﴿فَأَكَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121]، وقوله تعالى في سورة الأعراف ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗا﴾ [الأعراف: 26]. وهذا اجتهاد جانبي في المسألة وليس نتيجة وفي هذا متسع للدراسة والبحث يفتحها القرآن لمن يريد البحث والدرس.
نستنتج من هذا العرض أن ما جاء في القرآن لا يتعارض مع القول بحصول تطور عضوي للإنسان على مراحل وحقب مديدة، ولكن القرآن يؤكد أن كل ذلك جرى بعلم الله تعالى وإرادته واختياره وفقا لسنن الفطرة التي استسنها لسيرة الخلق والتكوين وصيرورته إلى جانب ذلك، فإن القرآن يجيز حصول النقوص التطوري؛ أي حصول طفرة تطورية، تولد كائنًا مسخًا أيضًا، ولست أدعي أن فهمنا للصورة التي يقدمها القرآن الكريم هو فهم متكامل بل هنالك دون شك جزء غيبي من الصورة يتعلق بخلق آدم في الجنة التي لا يمكن القطع بأنها حقًّا على الأرض، على الرغم من قول البعض بأن الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض إنما كان مقصودًا به نزولًا معنويًّا، لكن تبقى هذه المسألة من متشابه القرآن التي تحتاج إلى أزمنة قادمة لحلها وفك ألغازها([50]).
ثم يتابع الدكتور الطائي قوله:
يمكن الجزم الآن بأن مبدأ التطور العضوي للكائنات الحية هو أحد الأعمدة الأساسية لعلوم الحياة المعاصرة، وبدون مبدأ أو فكرة التطور يصبح من الصعب تصور أي وجود لعلم البيولوجيا الحديث وهذا غير ممكن إذ لا يمكن الاستغناء عن علوم البيولوجيا، ومن ينكر حصول التطور العضوي فعليه الإتيان بتفسير علمي متكامل لظهور الأنواع ونشوئها، ويكون عليه أيضًا أن يفسر هذا التشابه المورفولوجي والفيزيولوجي والتركيبي، وحتى النشاط الاجتماعي الفطري بينه وبين الكائنات الأخرى في المملكة الحيوانية، ثم إن عليه أن يفسر نجاحات القائلين بالتطور في تفسيراتهم لكل ما يتعلق بالبيولوجيا التطورية. على أن هذا القول في الوقت نفسه لا يعني بالضرورة صحة جميع التصورات النظرية التي تقترحها الداروينية، بل إن هنالك بعض الأدلة العلمية التي تشير بالتأكيد إلى ضرورة وجود تفاصيل نظرية أخرى لم تعلم بعد، وعند هذا لا بد من تأكيد الفرق بين القول بحصول التطور العضوي للكائنات الحية والإيمان بنظريات التطور، فالأول يبدو واقعًا حاصلا في عالمنا، أما الثاني فمختلف فيه، ولا يمكن القطع به ألبتة.
وإنني أذهب إلى تأييد التصورات التي قدمها الفرنسي جان ستون بشأن نظرية التطور، وقولهم أنها لم تزل ناقصة وإنها في حال أشبه ما تكون نظريات الحركة التي طرحت في وقت جاليليو وما قبل نيوتن، بمعنى أن نظرية التطور الحالية تحتاج إلى الكثير من التحول لكي تقدم الحقيقة التطورية على الوجه الصحيح، وبهذا الصدد أود أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن القول بحصول الطفرات عشوائيًّا ليس واقعًا عمليًّا بل هو تفسير اعتمده الداروينيون وحسب([51]).
تقرر نظرية داروين في التطور أن الانقسام في الخلايا الجنسية يؤدي إلى حدوث طفرات عشوائية، وهي جملة تحولات في الشفرة الوراثية تنشأ أثناء عملية النسخ، وهذه الطفرات تظهر نتائجها في تكون الكائن الحي بعد ولادته، خلال حياة هذا الكائن تقرر الظروف التي يواجهها في الطبيعة ما إذا كانت الطفرة الحاصلة في تكوينه البيولوجي ناجحة أم هي فاشلة، من خلال صراع البقاء الذي يعانيه هذا الكائن مع الطبيعة، فإن كانت الطفرة الحاصلة ناجحة أدت إلى نجاة الكائن ومنحته فرصة للتكاثر على نحو ربما يكون أكثر تميزا من الجيل الذي لم تحصل له الطفرة، أما إذا كانت الطفرة فاشلة فإن الكائن سوف يموت، وهكذا يتم القضاء على الكائنات التي تحصل فيها طفرات غير مرغوبة من قبل الطبيعة، لذلك سمي هذا الاختيار للكائنات بين الطفرات الناجحة والطفرات الفاشلة (الانتخاب الطبيعي) على اعتبار أن الطبيعة نفسها هي التي تختار ما إذا كانت الكائنات ستعيش أم ستموت، ومن المنطقي أن تتكاثر وتزدهر أعداد الكائنات ذوات الطفرات المفضلة، بينما تتضاءل أعداد الكائنات ذوات الطفرات المرفوضة وغير المتجاوبة مع الشروط الطبيعية، وهذه هي الآلية التي تقترحها نظرية داروين للتطور.
في الحقيقة لا أجد في هذه الآلية ما يتناقض مع الاعتقاد الديني إلا في القول بأن الطفرات الحاصلة هي عشوائية تماما، فإننا إذا أقررنا عشوائيتها فإننا كأنما نجعلها مستقلة عن إرادة الخالق لكن ما يبدو عشوائيًّا ليس بالضرورة هو كذلك، فإن ما كنا ذكرناه في مقالاتنا السابقة حول عمل القوانين الطبيعية (الفطرية) وحقيقة أن نتيجة عمل هذه القوانين إنما هي احتمالية وليست حتمية، بحسب أرقى توصلات العلم المعاصر وإثباتاتها، إنما ينفي العشوائية وينفي استقلالية عمل القوانين الطبيعية بذاتها، بالتالي ليس من خشية في أن يكون في ذلك القول نفي لدور الخالق في آلية التطور، هذا الدور الذي يدخل أصلا إلى العملية من خلال حاجة القانون الطبيعي (الفطري) إلى مشغل وحاجة القوانين المتضاربة إلى (منسق) وإلا لم يكن هنالك نتاج مثمر، هكذا أجد أن إعادة تفسير آلية التطور بضوء نتائج علم الفيزياء الكمومية سيعطي دعما لقبول آلية التطور السابقة، لكننا يجب أن نتذكر أن نظرية الداروينية ليست رصينة على نحو مطلق بل فيها ثغرات يعرفها المتخصصون في علومها، وحتى آلية الانتخاب الطبيعي عليها مآخذ كثيرة ويمكن وضع ألف سؤال وسؤال تصعب إجابته بصدد ما هو حاصل في تطور الكائنات.
تبقى نقطة ثانية مهمة أيضًا وهي تعارض العقيدة الدينية مع السلسلة التطورية والقول بأن أصل الإنسان كان حيوانًا، قردا أو غزالا أو سمكة أيا كان، فالفكر الديني (وليس القرآن بالضرورة) يتعارض مع هذه الفكرة من منطلق أن هذه الكائنات مسخ لا تتناسب وتكريم الخالق للإنسان واختياره خليفة في الأرض، وهنا نقول: إن تكريم الإنسان وتكريم بني آدم إنما حصل بعد أن صار الكائن الراقي آدميًّا، وهذه حصلت عندما تمت تسويته ووقعت النفخة الربانية فصار بها ذلك الكائن البدائي إنسانًا، إن الحقائق المورفولوجية والتشريحية والفيزيولوجية وحتى السلوكية تؤشر تشابها واشتراكا كبيرا بين الإنسان وما سواه من الكائنات العليا، فنحن نأكل ونشرب ونتناسل ونمارس كثيرا من أنشطتنا الحياتية بطريقة لا تختلف كثيرا عن بقية الحيوانات، ما يميزنا عنها هو ملكة العقل وبها كرمنا الخالق، وبدونها يمكن أن ننزل إلى مستوى الحيوان، وإن نحن اخترنا أن نتجاهل ما يدلنا إليه العقل من كرامة نكتسبها مع الإيمان، بل من ضرورة الإيمان بوجود غاية للعالم ووجود قوة وإرادة وخطة وقصد لهذا الكون، فإننا سنكون في جمعية مع بقية المملكة الحيوانية التي ننتمي إليها ماديًّا بحكم النشأة والتكوين.
إن الخالق ميز هذا الكائن الذي هو -نحن- الإنسان لكي نتفكر ونتأمل، ونصير نحن الخليفة القادر على التخليق والإبداع، وندرك بعقولنا كوننا الذي نعيش فيه رغم أننا جزء ضئيل جدًّا من الناحية المادية فيه، إن قدرة العقل التي في الإنسان، تلك النفخة الإبداعية الرائعة قد أعطته قيمة تساوي قيمة الكون كله، بالتالي فإن الإنسان يجب أن يقدر هذه القيمة ويحترمها في جميع الوجوه والأنشطة، أما إذا شاء هذا الكائن أن لا يحترمها فهو وجماعته من مملكة الحيوان؛ سواء كان يتميز عليهم فيما يتحال لنفسه به([52]).
إذن فهناك رأي يقول بعدم التناقض بين القرآن وبين نظرية التطور، وهذا الرأي مستنده في ذلك أنه مهما قالوا في وصف هذه النظرية فالأمر في حقيقته مرجعه ومرده إلى الله تعالى، فكل الظواهر التي نراها في الكون مردها ومرجعها إلى الله، ولقد كان في الماضي من الفلاسفة الذين قالوا بمبدأ الطبع أو العلة، يقول الإمام الدردير في منظومته:
| ومن يقل بالطبع أو بالعلة
| فذلك كفر عند أهل الملة
|
| ومن يقل بالقوة المودعة
| فذاك بدعي فلا تلتفت
|
يقول الصاوي في شرحه:
(ومن يقل) من أهل الضلال كالفلاسفة (بالطبع) أي بتأثير الطبع أي الطبيعة والحقيقة بأن يقول إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها (أو) يقل (بالعلة) أي بتأثيرها بأن يقول إن الأشياء علة أي سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار، والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وإن اشتركا في عدم الاختيار أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع كالإحراق بالنسبة للنار؛ فإنه يتوقف على شرط مماسة النار للشيء المحرف وانتفاء مانع البلل فيه مثلا.
وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة وجد المعلول كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الأصبع، ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلولها ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها؛ أي لتخلف الشرط أو انتفاء المانع (فذلك) القائل (كفر) أي كافر أو ذو كفر ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من يقل، فالحمل ظاهر على معنى فقوله «كفر» فيكون القائل به كافرا؛ لأنه أثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك (عند) جميع (أهل الملة) أي ملة الإسلام… واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل، قالوا: إن الواجب الوجود أثر في العالم بالعلة فهو تعالى علة فيه، فلذا قالوا: إن العالم قديم لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، ولا شك في كفرهم عند المسلمين([53]).
ثم بين رحمه الله مذهب أهل السنة بقوله:
(فلا تلتفت) أي لقوله -أي القول البدعي وقول الكفر- بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا لا بطبع، ولا علة، ولا بواسطة قوة أودعت فيها، وإنما التأثير لله وحده بمحض اختياره([54]).
فالخالق على الحقيقة لكل لحظة وسكنة هو الله، هكذا يؤمن المسلم، وأفعالنا التي تبدو للوهلة الأولى -ظاهريًّا- مسببة من أفعالنا، هي على الحقيقة بخلق الله تعالى، ولا تأثير في هذا الكون كله إلا لله، يقول الله تعالى ﴿وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ [الأنفال: 17]، ويقول ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾ [الزمر: 62].
(([1] العقائد الكبرى بين حيرة الفلاسفة ويقين الأنبياء (ص 23) محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 2010م. والأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفة (ص 75)
(([2] الأربعين في أصول الدين (1/ 103).
(([3] شرح المعالم للتلمساني (ص 160).
(([4] انظر: الأدلة العقلية على وجود الله للدكتور سعيد فودة (ص 66).
(([5] الأدلة العقلية على وجود الله (ص 65- 69).
(([6] انظر: الأدلة العقلية على وجود الله (ص 89- 96).
(([7] انظر: المنطق غير التقليدي وتطبيقاته (ص 23).
(([8] شرح الحكم العطائية (ص 264).
(([9] الأدلة العقلية على وجود الله (ص 435).
(([11] هداية الحكمة مع شرحها لقاضي مير (ص 100).
(([12] المواقف مع شرحها (3/ 5).
(([13] انظر: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام (ص 89). والأدلة العقلية على وجود الله (ص 221).
([14]) انظر: مطرقة البرهان (ص 115).
(([15] انظر: الأدلة العقلية على وجود الله (436).
(([16] المرجع السابق (ص 436، 437).
([17]) المطالب العالية من العلم الإلهي، (1/88) فخر الدين الرازي.
(([18] كبرى اليقينيات الكونية ص 80.
(([19] الاقتصاد في الاعتقاد (ص 64، 65).
(([20] شرح المقاصد للسعد (1/ 125).
([21]) رحلة عقل، د. عمرو شريف (ص 80).
(([22] الكون المرئي بين الفيزياء والميتافيزيقا (ص 35).
([24]) كارل ساغان، كتاب الكون، ص: 234، سلسلة عالم المعرفة- الكويت، عدد 178.
([25]) شرح الوسطى للسنوسي ص: 234.
([26]) شرح النسفية، سعد الدين التفتازاني، ص:91.
([27]) التفسير الكبير 22/ 159.
([28]) شرح أم البراهين ص 28 للإمام السنوسي.
([29]) الوسطى وشرحها للسنوسي، ص: 112.
([30]) ابن فورك، مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص: 11.
([31]) راجع: مفاتيح الغيب للرازي (13/ 35).
([32]) Our cosmic habitat, p56.
(([33] هناك إله – كيف غير أشهر ملحد رأيه (ص 153، 154).
([34]) الزمخشري في الكشاف 4/ 215، ط. دار الكتاب العربي.
([35]) انظر: الإسلام ونظرية داروين (ص 7).
([36]) مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان (1/ 425، 427).
([37]) الانحراف الفكري والديني وأثرهما في الإلحاد المعاصر (ص 469).
([38]) المرجع السابق (ص 469، 470).
([39]) الإسلام ونظرية داروين (ص 25).
([40]) الإسلام ونظرية التطور (ص 26).
([42]) انظر: الانحراف الفكري والديني (ص 470).
([43]) الفيلسوف والعلم (ص 307). وانظر: الانحراف الفكري والديني (ص 474).
([44]) عقائد المفكرين في القرن العشرين (ص 54). وانظر: الانحراف الفكري والديني (ص 477).
([45]) تاريخ الفلسفة الحديثة (ص 354، 355).
([47]) لسان العرب (باب اللام، فصل السين مع اللام).
([48]) النكت والعيون (6/ 162).
([50]) انظر: دقيق الكلام (ص 323).
([52]) انظر: دقيق الكلام (ص 326).
([53]) انظر: حاشية الصاوي (ص 40).
([54])المرجع السابق، نفس الصفحة.
([47]) لسان العرب (باب اللام، فصل السين مع اللام).
([48]) النكت والعيون (6/ 162).
([50]) انظر: دقيق الكلام (ص 323).
([52]) انظر: دقيق الكلام (ص 326).